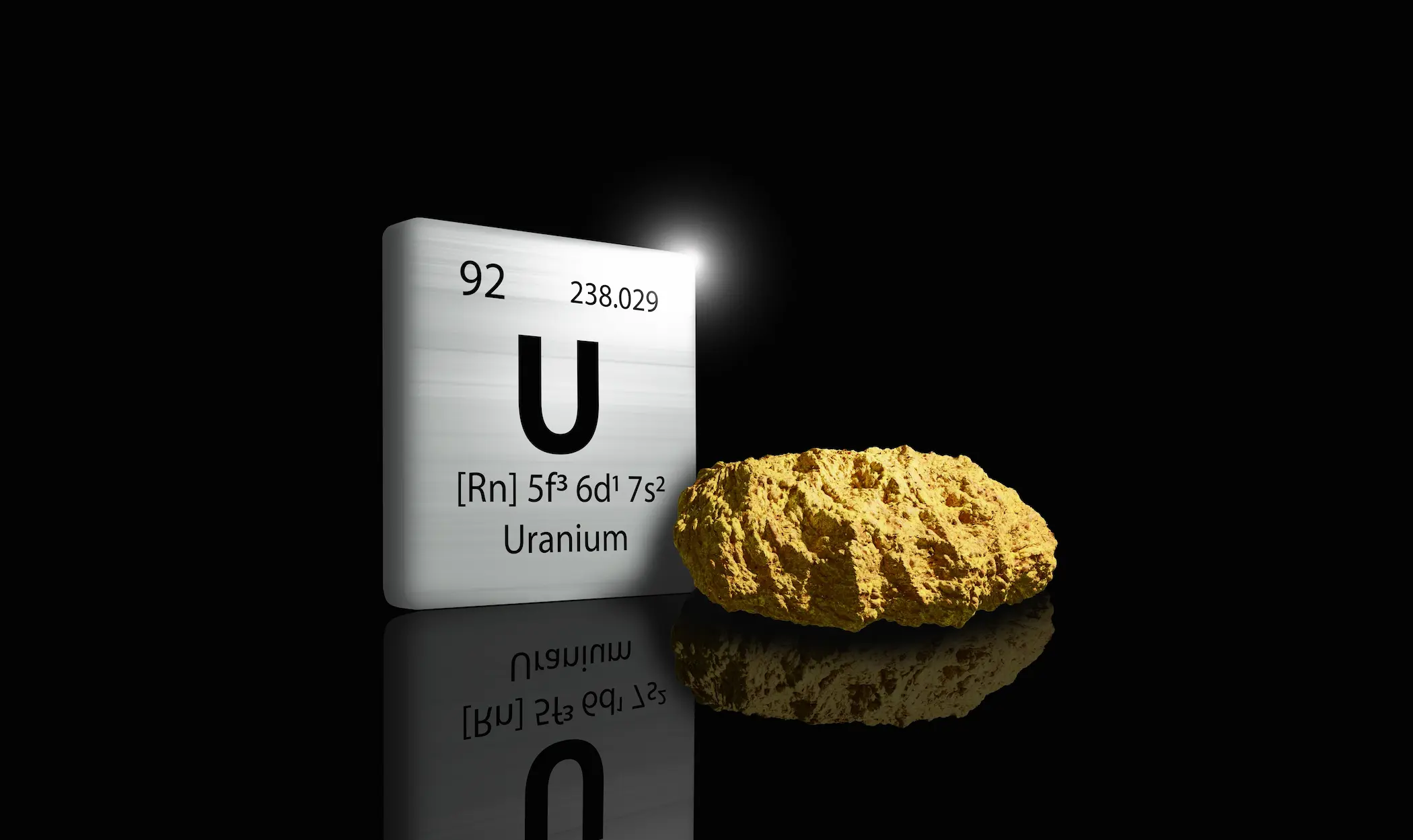9 يوليو 2025
معضلة التخصيب الإيراني: بين السيادة النووية وهواجس الانتشار العالمي
تُشكّل أزمة تخصيب اليورانيوم في إيران المحور الجوهري للصراع النووي القائم، حيث تتقاطع الاعتبارات التقنية مع محددات السيادة الوطنية، ويتداخل القانون الدولي مع منطق الردع الاستراتيجي. فمن منظور الجمهورية الإسلامية، يُعدّ امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، بما في ذلك التخصيب على أراضيها، حقًا أصيلًا ومكفولًا بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT). غير أن هذا "الحق" يتجاوز في الوعي السياسي الإيراني كونه خيارًا تكنولوجيًا، ليتحوّل إلى رمز سيادي وركيزة في سردية الاستقلال الوطني والتحدي لهيمنة القوى الغربية.
في المقابل، تنظر الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى التقنية ذاتها بوصفها البوابة المباشرة نحو إنتاج سلاح نووي. فالمعمار الفني القائم على أجهزة الطرد المركزي يتيح – مع توافر القرار السياسي – الانتقال من التخصيب المنخفض إلى إنتاج مادة انشطارية قابلة للتفجير خلال أسابيع معدودة. وقد تعاظمت هذه المخاوف بصورة غير مسبوقة عقب تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2025 أن إيران راكمت ما يزيد عن 400 كيلوغرام من اليورانيوم المُخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي نظريًا لإنتاج ثلاث إلى خمس قنابل نووية بمجرد رفع النقاء إلى 90%، دون حاجة لإضافة بنية تحتية جديدة.
الخبرة التاريخية الإيرانية – من حرمانها من حصتها في مشروع Eurodif عام 1979 إلى انهيار مبادرة مفاعل طهران البحثي عام 2009 – عززت قناعة راسخة لدى النخبة الحاكمة بأن الاعتماد على الخارج في تأمين الوقود النووي ليس خيارًا موثوقًا. ومن ثمّ، فإن أي صيغة تفاوضية تتطلب التخلي عن التخصيب المحلي تُعدّ، من المنظور الإيراني، مساسًا جوهريًا بالكرامة السيادية والأمن الاستراتيجي للدولة.
وعليه، فإن جوهر الأزمة لا يكمن في مستويات التخصيب أو أعداد أجهزة الطرد، بل في البنية السياسية العميقة لانعدام الثقة المتبادل. ولن يكون ممكنًا بلوغ تسوية مستدامة إلا ضمن إطار أمني أشمل يُعيد تعريف العلاقة بين إيران والنظام الإقليمي والدولي على أسس جديدة.
لذلك ينطلق هذا التحليل من مقاربة متعددة المستويات تُعالج أزمة التخصيب الإيراني بوصفها مسألة تتجاوز الطابع التقني، لتلامس جوهر الصراع بين السيادة الوطنية وهواجس الانتشار النووي. ويتناول التحليل أربعة محاور رئيسية: الخصائص التقنية للتخصيب، الدوافع السياسية والاستراتيجية الإيرانية، الحسابات الأمنية الغربية، وأطر الحلول المقترحة، مع التأكيد على أن أي تسوية دائمة تقتضي إعادة تعريف العلاقة بين إيران والنظام الدولي.
27 يونيو 2024
الانتخابات الرئاسية الإيرانية: منافسة محتدمة ورهانات عالية
يدلي الناخبون الإيرانيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر انعقادها 28 يونيو بعد وفاة رئيسها المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث غير متوقع نتيجة تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي. حيث شهد النظام الإيراني سيناريوهات مماثلة في السابق، ففي عام 1981، تم عزل أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للجمهورية بعد الثورة، من قبل مجلس الشورى بسبب عدم كفاءته السياسية. وفي نفس العام، تكرر هذا السيناريو باغتيال الرئيس محمد علي رجائي خليفة بني صدر، بتفجير حقيبة مفخخة عام 1981، وبالتالي فإن الفراغ السياسي والدستوري الحالي ليس بجديد على إيران، فقد حدث مرتين من قبل في فترة من عدم الاستقرار السياسي، وهذه المرة لا تقل أهمية عن سابقاتها.
وكان رئيسي من الشخصيات القليلة التي تحظى بثقة المؤسسة الأمنية وحراس النظام من رجال الدين، وكان من المخطط له الأشراف على تصعيد مرشد أعلى جديد بعد وفاة علي خامنئي أو ربما قد يصبح هو نفسه المرشد الأعلى، وبالتالي فإن وفاة رئيسي ستشكل تحدياً لنظام الملالي في طهران في ظل تحديات داخلية وخارجية شهدتها إيران في الآونة الأخيرة.
ومن ناحية أخري، مهد المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية عبر اختيار ستة مرشحين فقط، اجتازوا الفحص الذي أجراه مجلس صيانة الدستور -المكون من أثني عشر رجل دين يعيّنهم المرشد الأعلى، بترشيح من السلطة القضائية وموافقة البرلمان عليهم- من بين 80 مرشحا تقدموا بطلبات ترشحهم للمنصب، وفقاً لمعايير فضفاضة يجري تفسيرها وتأويلها من قبل مجلس صيانة الدستور مما يعطيه قول الفصل في اختيار أو استبعاد بعض المرشحين فعلي سبيل المثال لا يستثني الدستور الإيراني صراحة المرأة من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية ولكن يمنعها مجلس الصيانة من ذلك الحق حيث سجلت أربع سيدات أسماءهن في قائمة الترشح للرئاسة وغيرهم على مدار الثلاثة عشر انتخابات رئاسية ماضية، لم تتم الموافقة على ترشيح أي امرأة إلى الرئاسة بسبب المادة 115 من الدستور التي تنص على أن يكون الرئيس من بين "رجال السياسة والدين من أصل إيراني، ومواطناً إيرانياً، ومديراً وحكيماً، يتمتع بسمعة طيبة وأمانة وتقوى، ويؤمن بأسس جمهورية إيران الإسلامية وبالدين الرسمي للبلاد" ، علاوة على وضع معايير أخري تتعلق بالقدرة على الإدارة والتدبير، بخلاف ذلك الافتراض العام بأن خامنئي يريد رئيسًا مخلصًا ومحافظًا لا يعارضه يؤمن بالثوابت الخاصة بالنظام متمثلة في قدسية وطاعة ولي الأمر وإطاعة المرشد.
لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح أهمية هذه الانتخابات، وكيفية إداراتها، وأولويات التي يبحث عنها الناخب والنظام في الرئيس القادم.