تُمثّل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، اليوم نواةً صاعدة داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بوصفها مجموعةً شبه متبلورة باتت تُعرف تدريجيًا في أدبيات السياسة الخليجية الحديثة باسم "الثلاثي الخليجي". وعلى الرغم من أن هذا التشكيل لا يحظى بوضعية رسمية أو طابع مؤسسي، شأنه في ذلك شأن مجموعة الدول السبع التي تُعَدّ من أبرز محافل تنسيق السياسات الاقتصادية والسياسية بين الديمقراطيات الصناعية الكبرى، أو مجموعة العشرين التي تأسست عام 1999 كإطار للتفاعل بين القوى المتقدمة والصاعدة من أجل ضمان الاستقرار المالي العالمي، أو حتى مجموعة الـ77 التي تعد أكبر تكتل للدول النامية داخل منظومة الأمم المتحدة؛ إلا أن (الثلاثي الخليجي) تُقدَّم اليوم كإطار عملي وفعّال لتنسيق استراتيجيات النفوذ والتأثير بين أبرز الفاعلين في الفضاء الخليجي والعربي.
وتنبع خصوصية هذا الثلاثي من كونه أصغر التكتلات، وأكثرها حداثة، وأكثرها تجانسًا من حيث المحددات البنيوية والمصالح العليا لدوله، إذ تحتل الدول الثلاث مواقع متقدمة على مستوى النشاط السياسي والديبلوماسي، والقدرة الاقتصادية والمالية، فضلاً عن حضورها الدولي المُتنامي مُقارنة ببقية أعضاء المجلس. كما تدل المؤشرات المتراكمة على أن هذه الدول لم تعد تمارس دورها الإقليمي كقوى منفردة، بل باتت تشكل مركز ثقل جديد للسياسة العربية، يفرض نفسه من حيث التأثير وسرعة الاستجابة ووضوح التوجهات.
وانطلاقًا من لحظة التحول التي يشهدها الخليج في هذه المرحلة، والتي لا يُمكن أن تُفسَّر فقط بموازين القوى التقليدية أو بهياكل التعاون القائمة، بل باتت تستدعي فهمًا أدق للدوافع الكامنة وراء السياسات الخارجية لدول (الثلاثي الخليجي)، وآليات التنسيق غير الرسمي التي تربطها، والرهانات الكبرى التي تضعها هذه الدول في الحسبان وهي تعيد تعريف معادلة الأمن والتنمية في بيئة الشرق الأوسط ما بعد حقبة إيران.
من التنافس إلى التقارب الاستراتيجي
شهدت العلاقات بين دول الثلاثي الخليجي منذ تسوية أزمة المقاطعة الخليجية في عام 2017 تحولًا نوعيًا في مستوى التنسيق السياسي والأمني، إذ ارتقت اليوم إلى أرفع حالاتها منذ ذلك التاريخ. فالتوترات التي عصفت سابقًا بالعلاقات البينية—وتحديدًا عندما قادت كل من السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة شاملة لقطر—باتت من الماضي، بعد أن جرى احتواؤها ضمن تسوية توافقيّة أعادت تفعيل منطق المصلحة المشتركة، ولو بصورة غير مؤسسية. هذا التحول لا يُقرأ فقط في مسار العلاقات الخليجية–الخليجية، بل يتقاطع بشكل مباشر مع نمط تفاعل الثلاثي الخليجي مع الولايات المتحدة، التي حافظت على موقعها بوصفها الضامن الخارجي الرئيسي للأمن الإقليمي، رغم ما يعتري علاقتها بحلفائها من شكوك ظرفية في لحظات التوتر والفراغ الاستراتيجي.
وقد شكّلت الزيارة التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2025 إلى كل من الرياض وأبوظبي والدوحة لحظةً كاشفة عن إدراك واشنطن للأهمية المتصاعدة لهذا التشكيل الثلاثي. فمنذ تلك الزيارة، والتي اكتسبت دلالاتها من الرمزية والموقع والتوقيت، برزت مؤشرات متسارعة على ارتفاع مستوى التنسيق السياسي والعسكري بين دول الثلاثي الخليجي، خاصة في أعقاب الضربة الجوية والصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية في سبتمبر. إذ مثلت هذه الحادثة في التقدير الاستراتيجي الخليجي، نقطة تحوّل محتملة في مفهوم التهديد وحدود التفاهمات الدفاعية القائمة، بما أعاد إحياء فكرة “الناتو الخليجي”—أي بناء هيكل دفاعي جماعي بقيادة الرياض وأبوظبي والدوحة.
وفي لحظة التصعيد تلك، بادرت دول مجلس التعاون الست إلى إعادة تأكيد التزامها الصريح باتفاقية الدفاع المشترك لعام 2000، والتي تنص بوضوح على أن أي اعتداء على دولة عضو يُعدّ اعتداءً على سائر الأعضاء، وهو ما يستدعي الرد الجماعي وفقًا لمبدأ شبيه بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذه الاستجابة، وإن جاءت تقليدية في ظاهرها، إلا أنها حملت في طياتها إدراكًا جديدًا بأن التهديدات لم تعد خارجية بالضرورة، وأن صيغ الردع الجماعي بحاجة إلى إعادة تفعيل يتناسب مع طبيعة التحوّلات المُتسارعة في البيئة الإقليمية، ومع التعقيدات التي فرضتها واقعة استهداف الدوحة بالتحديد.
تراجع إيران وبزوغ حقبة جديدة
ما تزال دول الثلاثي الخليجي، شأنها شأن غالبية أعضاء مجلس التعاون الخليجي، تنظر إلى إيران بوصفها مصدر تهديد استراتيجي طويل المدى، غير أن هذا التهديد بات يأخذ منحًى مغايرًا بعد أن دخل نفوذ طهران مرحلة انحسار ملموس. فقد فقدت إيران تدريجيًا مواقعها المتقدمة التي كانت تحتفظ بها منذ مطلع العقد الماضي، وتراجعت قدرتها على التأثير في مسارات الصراع في سوريا، بينما تتجه خسارتها لنفوذها في لبنان نحو الاكتمال، بعد أن أصبح ما يُعرف بـ«محور المقاومة» في حالة تفكك هيكلي وضعف تنظيمي غير مسبوق. وإلى جانب هذا التراجع الميداني، تعرض برنامجها النووي—الذي شكّل على مدى سنوات أداتها التفاوضية الأبرز وورقتها الضاغطة في علاقاتها مع القوى الكبرى—لأضرار بالغة عقب اثني عشر يومًا من القصف الجوي والصاروخي الإسرائيلي–الأميركي المتواصل، ما أدى إلى تعطيل قدراتها على التخصيب وإفقادها إحدى أهم أدوات الردع التي كانت تعتمد عليها.
مثل هذا التآكل في القوة الإقليمية الإيرانية مؤشرًا على بداية حقبة جديدة في النظام الشرق أوسطي، يمكن توصيفها اصطلاحًا بحقبة «ما بعد إيران»، وهي لحظة انتقالية يتسارع فيها فراغ النفوذ، وتُعاد خلالها صياغة التوازنات داخل الإقليم على أسس مغايرة لما ساد طوال العقدين الماضيين. في هذا السياق تدرك دول الثلاثي الخليجي بدقة أبعاد هذا التحول، وتتعامل معه كفرصة استراتيجية لإعادة ترتيب المجال الإقليمي بما ينسجم مع رؤيتها للأمن والتنمية، وبما يتيح لها أن تكون فاعلًا مركزيًا في إدارة التوازنات المقبلة. كما تسعى إلى توظيف هذا الفراغ لمراكمة أدوارها في المنظومة الإقليمية بالتوازي مع القوى الصاعدة الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل وتركيا، في مشهد يعيد رسم مراكز القوة في الشرق الأوسط، ويجعل من الخليج—بمكونه العربي تحديدًا—أحد محاور الثقل الجديدة في النظام الإقليمي قيد التشكل.
إسرائيل: تهديد محتمل في معادلة ما بعد إيران
شكّلت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية نقطة تحوّل حاسمة في إدراك دول الثلاثي الخليجي لطبيعة التهديدات الإقليمية. فبعد أن كانت إسرائيل تُدرَك، في الأدبيات الخليجية، بوصفها طرفًا سياسيًا إشكاليًا ومصدرًا للضغوط الدبلوماسية، باتت تُصنَّف الآن كفاعل ذا نزعة هجومية مباشرة، يُهدد استقرار المنظومة الأمنية الخليجية في لحظة انكشاف استراتيجي غير مسبوقة.
في سياق الشرق الأوسط “ما بعد إيران”، تُحاول إسرائيل—تحت قيادة رئيس وزراء يعاني من أزمة شرعية داخلية ويعتمد نهجًا تصعيديًا—فرض تصور أحادي للنظام الإقليمي، يقوم على التفوّق العسكري، واستدامة السيطرة الفعلية على الضفة الغربية، والتجاهل المتعمد للتبعات الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. ويمثل هذا التوجه، في تقدير عواصم الثلاثي الخليجي، تهديدًا مزدوجًا: فمن جهة، يقوّض فرص بناء توازن قوى مستقر، ومن جهة أخرى، يُعيد إنتاج مناخات عدم الثقة التي قادت إلى دورات الصراع السابقة.
في المقابل، تعتمد دول الثلاثي الخليجي مقاربة مغايرة، تقوم على تفعيل دور القيادة الخليجية بصيغتها التوافقية، وتعزيز نموذج التعاون الإقليمي المستند إلى الاقتصاد والتكامل، وليس الصدام والهيمنة. فهي لا تسعى إلى عزل إسرائيل، بل إلى تقويض سردية الهيمنة الأحادية التي تُفضي إلى تفكك النظام الإقليمي، وطرح تصور بديل يُعيد تموضع الخليج كمركز استقرار يقود الترتيبات الأمنية والتنموية، بدل أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
الولايات المتحدة والثلاثي الخليجي: شراكة لا تقبل الانفصام
يأتي تصاعد دور الثلاثي الخليجي الثلاثي الخليجي في سياق توازي مع عودة أميركية واثقة إلى قلب التفاعلات الإقليمية، بعد فترة من التردد الاستراتيجي. فواشنطن عادت للتواجد بقوة، عسكريًا ودبلوماسيًا، على امتداد خطوط التماس من سوريا ولبنان، إلى غزة واليمن، وصولًا إلى الخليج، حيث تُحافظ قواتها على أعلى درجات الجاهزية في مواجهة بيئة أمنية متقلبة. ورغم ما يُثار من انتقادات دورية حول تراجع الالتزام الأميركي، فإن المعطيات الميدانية تُظهر استمرار الدور الأميركي بوصفه الضامن الأساسي لاستقرار الإقليم.
في هذا السياق، جاءت قمة شرم الشيخ التي عُقدت في 13 أكتوبر 2025، برعاية مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، لتُجسد ما يمكن وصفه بلحظة التفوق الأميركي في المعادلة الشرق أوسطية، في ظل غياب واضح لأي حضور موازٍ من جانب روسيا، أو الصين، أو الاتحاد الأوروبي. وقد مثّلت هذه القمة منصةً سياسية لإعادة تثبيت موقع واشنطن باعتبارها الفاعل الخارجي الأكثر تأثيرًا في إعادة هيكلة النظام الإقليمي لما بعد تراجع إيران.
وبالنسبة لدول الثلاثي الخليجي، فإن الشراكة مع الولايات المتحدة لم تعد خيارًا تكتيكيًا، بل مكوّنًا بنيويًا في رؤيتها للأمن الجماعي وإدارة ترتيبات ما بعد الحقبة الإيرانية، لذلك فإن أي تصور لتحالف دفاعي خليجي موسّع—بما في ذلك النموذج المطروح تحت مسمى “الناتو الخليجي”—يفتقر إلى المصداقية ما لم يحظَ بدعم أميركي مباشر ومؤسسي. ومن ثمّ، فإن واشنطن مطالبة، من منظور مصلحي صرف، بالتعامل مع هذا الثلاثي الخليجي لا كمجموعة داعمة لسياساتها، بل كمحور إقليمي قادر على توليد التوازن والاستقرار، واحتواء النزاعات، وقيادة ترتيبات انتقالية تُفضي إلى شرق أوسط أكثر قابلية للإدارة والربط الاقتصادي والتعاون الأمني.


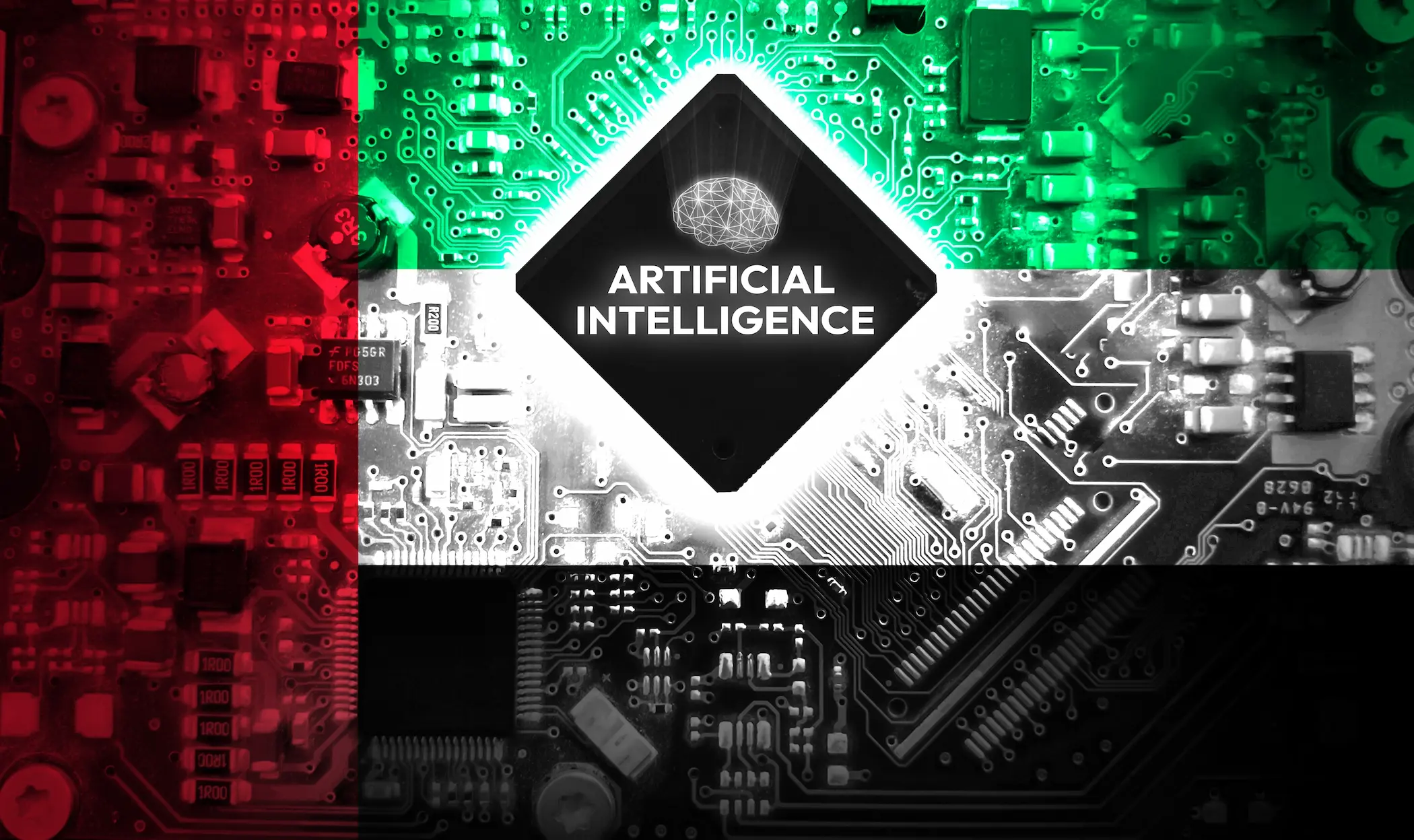








تعليقات