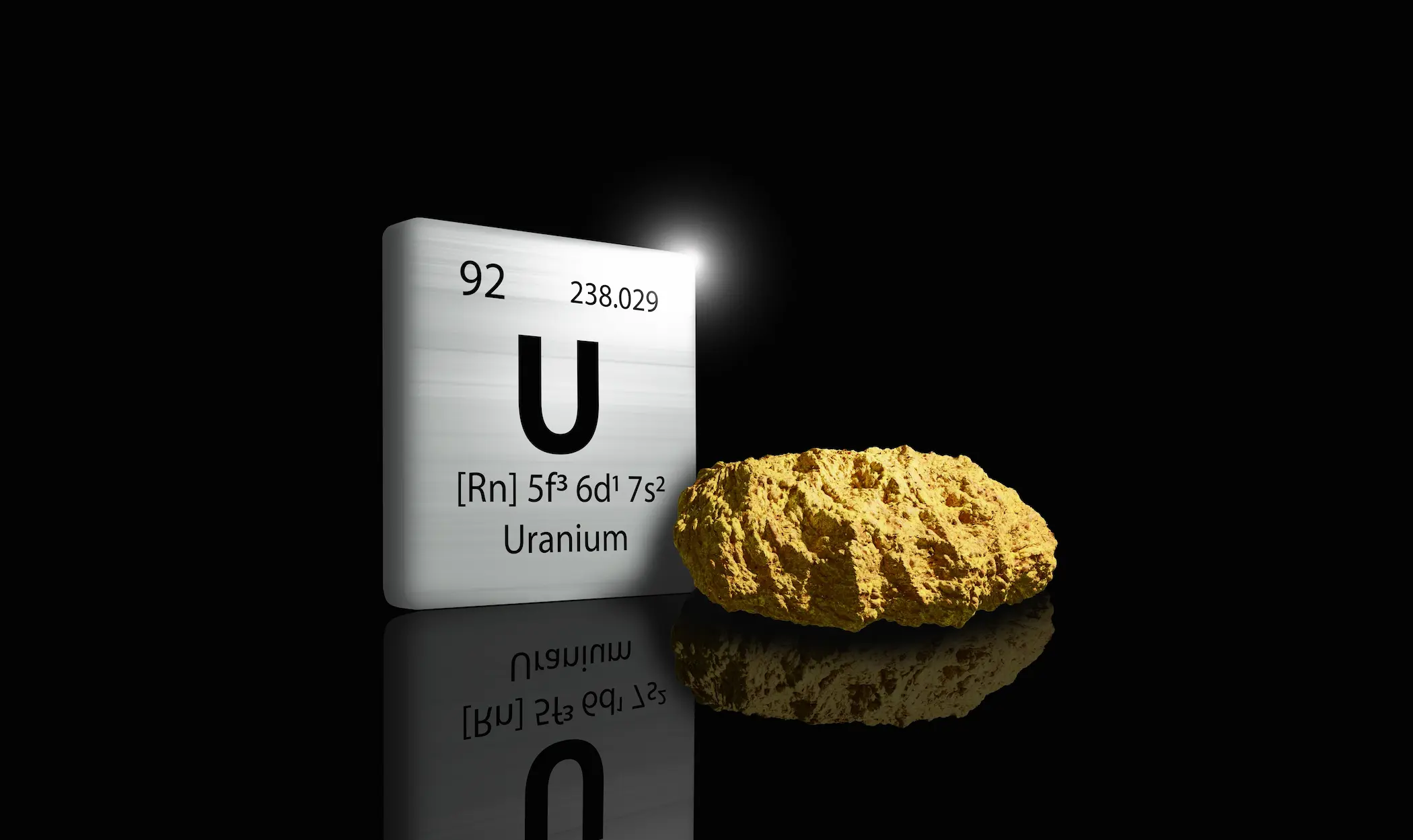17 أغسطس 2025
تأثير الدومينو: هل تتجه المزيد من الدول للاعتراف بفلسطين؟
أثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والتي تبعتها دول أوروبية أخرى، بشأن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المُقبل تحولًا بارزًا في سياسات القوى الغربية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية. جاء هذا التحول في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تجلت في مجاعة واسعة النطاق وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 60 ألف شخص، مما زاد من وتيرة الدعوات الدولية لحل سياسي عاجل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
تمثل إعلانات باريس ولندن وأوتاوا، خصوصًا التعهد غير المشروط من فرنسا والنهج المشروط من المملكة المتحدة وكندا، خروجًا واضحًا عن الاعراف الدبلوماسية التقليدية التي كانت ترتبط بالاعتراف بدولة فلسطينية موكولًا إلى التوصل لاتفاق سلام تفاوضي شامل. يعكس هذا التحول حالة من الإحباط المتزايد تجاه تعثر مسار السلام، بالإضافة إلى تبلور قناعة بأن المسارات التقليدية لم تعد تجدي نفعًا، إذ صار الاعتراف بدولة فلسطين يُنظر إليه ليس فقط كنتيجة للسلام، بل كوسيلة تحفيزية لدفع العملية السياسية قدمًا، ما يعيد صياغة الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمعالجة الصراع ويؤسس لسابقة قد تستفيد منها دول أخرى في تعزيز ضغوطها الدولية.
على الصعيد الدولي، تعترف ما بين 140 إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، وهو إجماع واسع يشكل الإطار المرجعي لفهم القرارات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. ومن اللافت أن هذه الدول الثلاث أعضاء في مجموعة السبع، التي لم تتخذ قبل إعلان فرنسا أي منها خطوة مماثلة، مما يجعل فرنسا، بوصفها أكبر دولة أوروبية سكانًا، تبرز كفاعل بارز في هذا التحول، بينما تستعد فرنسا وكندا لتكونا أول دولتين من المجموعة تعترفان بفلسطين.
في المقابل، تظل الولايات المتحدة العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الدولي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ما يضفي على هذا التغيير بعدًا رمزيًا يؤسس لإعادة توازن الضغوط الدبلوماسية على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وقد يحفز دولًا غربية أخرى مترددة على السير في ذات الاتجاه. كما يبرز اختلاف المواقف داخل القوى الأطلسية تأثير الضغوط الداخلية والأزمة الإنسانية الملحة في بلورة مواقف أكثر تشدّدًا. بناءً على ذلك، يتناول هذا التحليل دوافع هذا التحول وآثاره على الصعيدين الأمني والسياسي للدول المعنية، إلى جانب ردود الفعل المتوقعة من إسرائيل والولايات المتحدة.
14 أغسطس 2025
ماذا لو اشتعلت الحرائق في الشرق الأوسط؟
شكّل عام 2023 محطةً قاتمة في مسار تغيّر المناخ، حيث سُجل فيه أعلى عدد من حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي منذ بدء الرصد في عام 2000، بحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات ((EFFIS. فقد التهمت النيران أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل نصف حجم جزيرة قبرص تقريباً. وتفاقم الوضع في عام 2024، حيث ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بحرائق الغابات بشكل حاد ليبلغ 437 حالة، مقارنة بـ 263 حالة وفاة في عام 2023.
وتشير الأبحاث باستمرار إلى أن تغيّر المناخ يُعد العامل الرئيسي وراء هذه الأزمة المتصاعدة. فهو لا يقتصر على توسيع نطاق الأراضي المحترقة فحسب، بل يُكسب الحرائق الفردية طابعاً أكثر شدة، ويتسبب في تمديد موسم الحرائق إلى ما بعد أشهر الصيف التقليدية، ويؤدي إلى اندلاع النيران في مناطق لم تكن عرضةً لمثل هذه الكوارث من قبل. وبينما يقترب هذا التهديد المتنامي من الشرق الأوسط، يبقى السؤال الملحّ: هل ستكون المنطقة مستعدة له، أم أنّه سيفاجئها على نحو خطير؟
14 أغسطس 2025
زيارة لاريجاني: بناء تحالفات أم إنقاذ للحلفاء؟
في ظل المشهد الجيوسياسي المتقلب في الشرق الأوسط، غالبًا ما تعكس مناورات إيران الاستراتيجية توازنًا دقيقًا بين تأكيد نفوذها الإقليمي وحماية شبكات وكلائها. وتُجسّد الزيارة الأخيرة التي قام بها علي لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المُعيّن حديثًا، إلى بغداد وبيروت يومي 11 و12 أغسطس 2025، هذه الديناميكية. وتُبرز هذه الزيارة الخارجية الافتتاحية، التي عُيّن فيها لاريجاني في 5 أغسطس 2025، مدى إلحاح طهران على معالجة الضغوط المتصاعدة على حلفائها الرئيسيين: حزب الله في لبنان وكتائب حزب الله ضمن قوات الحشد الشعبي العراقية.
ويُركّز جدول الأعمال المُعلن على التعاون الثنائي، بما في ذلك توقيع اتفاقية أمنية مع العراق تُركّز على ضبط الحدود، ومكافحة التهديدات المشتركة، وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية. وفي لبنان، تُركّز المناقشات على المشاورات السياسية والأمنية، وتأكيد الوحدة الوطنية، ومراجعة العلاقات التاريخية في ظل التوترات المستمرة. تأتي هذه الزيارة في ظلّ حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، تشمل صراعاتٍ حديثة مع إسرائيل، وضغوطًا أمريكية، وتحدياتٍ داخليةً تواجه الميليشيات المدعومة من إيران. وبينما تسعى طهران إلى تعزيز "محور المقاومة"، يطرح جدول الزيارة سؤالًا جوهريًا: هل يُمثّل بناء تحالفاتٍ استباقيًا أم جهدًا تفاعليًا لإنقاذ حلفائها المحاصرين؟ فعلى الرغم من وجود عناصر تعزيزٍ طويل الأمد، إلا أن التوقيت والسياق يميلان نحو إدارة الأزمات، بهدف التخفيف من حدة التهديدات المباشرة لنفوذ إيران بالوكالة.
11 أغسطس 2025
الشرق الأوسط وتحولات الطاقة بين الوفرة المؤقتة وصياغة نظام متعدد الأقطاب
في يوم 28 يوليو 2025، وخلال مؤتمر صحفي مشترك في اسكتلندا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن ترامب بشكل مفاجئ أنه يمنح روسيا مهلة جديدة لا تتجاوز عشرة إلى اثني عشر يومًا (حتى 8 أغسطس 2025 تقريبًا) لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددًا بأنه في حال عدم الاستجابة سيواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة عقوبات اقتصادية وقيود تجارية مشددة. وجاء هذا التصعيد بعد فترة من المحاولات الدبلوماسية غير المثمرة والتعبير المتكرر من ترامب عن استيائه من بوتين لاستمراره في العمليات العسكرية.
لاحقًا، وفي 31 يوليو 2025، رد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف (الرئيس الروسي السابق)، بتصريحات حادة عبر قناته على تليغرام، مذكِّرًا ترامب بما أسماه "خطر اليد الميتة"، أي نظام الردع النووي الروسي شبه الآلي المصمم لضمان توجيه ضربة انتقامية نووية حتى في حال القضاء التام على القيادة الروسية. وقد أثار هذا الرد قلق الإدارة الأميركية، ورد ترامب بتحريك غواصتين نوويتين أميركيتين إلى مناطق استراتيجية تحسبًا لأي تصعيد محتمل، مؤكدًا أن التهديدات النووية "خطيرة للغاية" ويجب التحسب لها بقوة.
الرد الأميركي لم يتأخر. ففي الأول من أغسطس، نشر ترامب تدوينة جديدة على منصة "تروث سوشيال"، أكد فيها أنه وجّه أوامر مباشرة بنشر غواصتين نوويتين أميركيتين قرب المياه الإقليمية الروسية. ولم يُفصح الرئيس الأميركي ما إذا كانت الغواصات مزودة برؤوس نووية أم لا، تاركًا الباب مفتوحًا أمام أكثر السيناريوهات غموضًا، في خطوة محسوبة ضمن منطق الردع النووي الاستباقي.
لكن اللافت أن هذا التصعيد لم يبقَ محصورًا في المجال الروسي–الأميركي فقط، بل اتسعت دائرته لتطال الهند، التي وُضعت فجأة في قلب العاصفة. ففي 31 يوليو، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كل الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، وهدد بعقوبات إضافية تطال الشركات التي تواصل استيراد النفط أو بيع الأسلحة مع موسكو. جاءت هذه الخطوة بسبب اعتماد نيودلهي المتزايد على الخام الروسي، والذي بات يُشكل بين 35 و40٪ من احتياجاتها النفطية.
ومع أن الحكومة الهندية لم تُعلن رسميًا التراجع عن التعاقدات الروسية، فإن تعليمات غير مكتوبة صدرت إلى شركات التكرير الوطنية بالبحث الفوري عن بدائل في السوق العالمية، وبدأت فعلاً بوادر التحوّل تظهر، من دون أن تصل إلى حدّ القطيعة الكاملة مع روسيا، في محاولة لإرضاء الطرفين دون خسارة أيٍّ منهما.
غير أن التوتر هنا لا ينحصر فقط في لعبة التهديدات والمواقف. فالأزمة الناشئة بدأت ترسم موجات ارتدادية هائلة تتجاوز السيادة والردع، وتصل إلى قلب الأسواق العالمية. من الطاقة إلى الغذاء، ومن السلاح إلى سلاسل الإمداد، يشهد العالم اختلالًا متسارعًا في التوازنات، سيصُبّ لصالح بعض دول الشرق الأوسط التي ستستفيد من ارتفاع الطلب، بينما ستتضرر أخرى بشدة، سواء بفعل الأسعار أو بفعل خنق ممرات التجارة أو تقلبات التمويل.
يتتبّع هذا المقال بدقة أثر هذا التصعيد الجيوسياسي على أسواق الطاقة العالمية، مع التركيز على السيناريوهات المحتملة في حال استمر الضغط الأميركي وواصلت الهند تقليص اعتمادها على النفط الروسي. إذ تُعدّ الهند، بحجم استهلاكها وقدرتها على المناورة بين الموردين، فاعلًا مرجِّحًا في معادلة العرض والطلب، وتحوّلها المفاجئ نحو أسواق الخليج أو أميركا اللاتينية لا يُعيد فقط تشكيل الجغرافيا التجارية للنفط، بل يُحدث موجة مضاعفة من التأثيرات تمتد إلى الاقتصادات العربية ذات العلاقة العضوية بأسواق الطاقة. في هذا السياق، يرصد المقال الفرص والتحديات التي تواجه دول الخليج بوصفها بديلًا استراتيجيًا للمصدر الروسي.
5 أغسطس 2025
تحذير استراتيجي: نتنياهو يخطط لغزو شامل لقطاع غزة
سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 5 أغسطس 2025 للمصادقة على خطط توسيع السيطرة العسكرية لتشمل القطاع بالكامل، في تصعيد خطير للصراع مع حماس. على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على حوالى 75٪ من غزة، يضغط نتنياهو لتوسيع العمليات لتشمل المناطق المكتظة بالسكان والتي يعتقد بوجود رهائن فيها، وهو اقتراح يواجه معارضة قوية من داخل صفوف الجيش وخاصة من رئيس الأركان إيال زامير، الذي يحذر من تداعيات إنسانية ومخاطر عملياتية كبيرة واصفًا الخطة بالفخ الاستراتيجي، و تعكس هذه الخطة توجهًا لإضعاف حركة حماس نهائيًا، وتأمين تحرير الرهائن، مع العلم أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى قد انهارت.
وفي تطور دراماتيكي، ألغى نتنياهو زيارة مقررة لزامير إلى واشنطن بعد إطلاعه على التوجه الجديد والتحولات الاستراتيجية المتسارعة. رفض زامير الخطة المقترحة صراحةً، مهددًا بالاستقالة في حال الموافقة عليها. تركزت تحفظات الجيش على مخاوفه على حياة الرهائن، لا سيما في مناطق مثل دير البلح التي لم تُطهر بالكامل من مقاتلي حماس. علاوةً على ذلك، أعربت قيادة الجيش عن قلقها إزاء تآكل قدراته القتالية، مشيرةً إلى نقص القوى البشرية بعد قرابة عامين من الصراع المتواصل، و دعا إلى اتباع استراتيجية احتواء أكثر حذرًا من شأنها ممارسة الضغط على حماس دون الانخراط في احتلال طويل الأمد وواسع النطاق.
30 يوليو 2025
الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط: بين وعود التحوّل ومعضلات التطبيق
في عالم تسوده التحوّلات المتسارعة المدفوعة بالتقدم التكنولوجي، يُعاد رسم ملامح المشهد العالمي على وقع الصعود اللافت لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تلك التقنية التي باتت تضطلع بدور جوهري في إحداث تحوّلات اقتصادية كبرى، وإطلاق عصر جديد من النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط من بين أكثر المناطق حيويةً في ما يتعلّق بدمج الذكاء الاصطناعي، إذ لا تكتفي بمجرد الرصد أو مواكبة حركة التطور، بل تتبنّى هذا التحوّل بشكل ثوري، حيث تسعى حكومات المنطقة إلى تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل سياساتها، وتطبيق استراتيجيات وطنية طموحة، واستقطاب استثمارات أكثر ذكاءً، وإعادة بناء مستقبلها على أسس رقمية أكثر تطورًا. وقد بدأت ملامح هذا التحول تؤتي ثمارها، حيث باتت اقتصادات عدّة في المنطقة أكثر مرونةً وديناميكية، وتطورت النظم لتعمل بكفاءة وذكاء أعلى، ما أسهم في توفير خدمات أفضل وأكثر فاعلية لشعوبها.
ورغم التقدّم السريع والنمو المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الشرق الأوسط، لا تزال المنطقة تواجه جملة من التحديات التي تُعيق المسار التحويلي المنشود، من أبرزها النقص في الكوادر البشرية المؤهّلة بالقدر الكافي، والحاجة المستمرة إلى حلول مبتكرة وأساليب جديدة لسد هذه الفجوة. وفي المقابل، تفتقر معظم دول المنطقة إلى إطار تشريعي متكامل ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وأخلاقي، بما يضمن اتساقه مع المبادئ الإنسانية والمعايير الدولية. كما أن الحاجة المتنامية إلى تطوير بنية تحتية رقمية مستدامة تؤكد أن الطريق لا يزال يتطلّب المزيد من الجهود والعمل المؤسسي. غير أن تجاوز هذه التحديات والعقبات كفيل بإطلاق الإمكانات الكاملة للمنطقة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتمكينها من لعب دور محوري في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.
17 يوليو 2025
اتجاهات الرأي العام: المخاطر النووية في الشرق الأوسط
يستعرض استطلاع "اتجاهات الرأي العام"، الذي أُجري في يونيو 2025، تصوّرات المخاطر النووية في المنطقة، بما في ذلك احتمالية وقوع أحداث نووية، ومستويات الاستعداد، والحاجة إلى استجابة طارئة جماعية. وتقدّم نتائجه رؤى معمقة حول كيفية تأثير حالة الغموض الجيوسياسي في تشكيل مخاوف الجمهور حيال التهديدات النووية.
عند طرح سؤال حول احتمالية وقوع حدث نووي في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، أشار غالبية المشاركين إلى أن الاحتمال يتراوح بين مرتفع (41%) ومتوسط (41%). في المقابل، أعربت نسبة محدودة (16%) عن اعتقادها بأن هذا الحدث غير محتمل، فيما استبعده تمامًا 3.1% من المشاركين. ويعكس هذا التوزيع في الآراء تحوّلًا ملحوظًا في وعي الرأي العام؛ إذ لم يعد الحدث النووي يُنظر إليه كاحتمال بعيد، بل كخطر واقعي ومحتمل، تفرضه الديناميكيات الجيوسياسية الراهنة وحالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمر.
ردًا على سؤال الاستطلاع المتعلّق بأكثر الأسباب احتمالًا لحدوث تداعيات نووية، اعتبر المشاركون أن الحرب النووية تُشكّل الخطر الأكثر ترجيحًا (46%)، متقدمة على احتمال وقوع خلل في مفاعل نووي (38%). وعلى الرغم من أن الوقائع التاريخية تُظهر تكرار أعطال المفاعلات، فإن المشاركين بدوا أكثر انشغالًا باحتمالية نشوب حرب نووية، وهو ما يُعزى على الأرجح إلى تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في أعقاب النزاعات الأخيرة، وفي مقدمتها الحرب التي دارت بين إيران وإسرائيل. أما الهجمات السيبرانية، فرغم إمكانيتها من الناحية التقنية، فقد اعتُبرت أقل احتمالًا (13%)، في ظل مقارنتها بتهديدات أكثر إلحاحًا كالحرب والأعطال الفنية. وفي السياق ذاته، نالت الهجمات الإرهابية أدنى نسبة (4.2%)، ما يعزّز الانطباع بأن التهديدات الصادرة عن دول متنازعة تُعدّ أكثر خطورة من تلك التي تُنسب إلى جهات غير حكومية.
عند طرح سؤال حول مدى الحاجة إلى إنشاء نظام مشترك للطوارئ النووية في الشرق الأوسط، أعربت الغالبية الساحقة من المشاركين (91%) عن تأييدهم للتعاون الإقليمي، في دلالة واضحة على تنامي المخاوف من التوترات الراهنة، وإدراك محدودية قدرات بعض الدول على التصدي للتهديدات النووية بشكل منفرد. في المقابل، أعربت نسبة محدودة (9%) عن رفضها لفكرة النظام الجماعي الشامل، مفضّلة حصر التعاون في إطار عدد معيّن من الدول. ومن المحتمل أن تعكس هذه الرؤية اقتناعًا بوجود تفاوت في الجاهزية والمسؤولية بين دول الإقليم، أو تخوّفًا ضمنيًا من إشراك أطراف يُنظر إليها باعتبارها "مستفيدة دون التزام" ضمن منظومة الأمن الجماعي.
في ما يتعلّق بجاهزية الشرق الأوسط لمواجهة خلل نووي أو هجوم سيبراني، أفادت غالبية المشاركين (76%) بأنّ المنطقة غير مستعدة، في حين رأى 12% أنها مستعدة إلى حدّ ما، و12% آخرون أعربوا عن ثقتهم بكفاءة الاستعداد. وتعكس هذه النتائج مستوى مرتفعًا من القلق العام، وتكشف عن إدراك متزايد للفجوة القائمة في القدرات المؤسسية وآليات الاستجابة الطارئة. كما تعزز هذه المعطيات ما ورد سابقًا من دعم قوي لإنشاء نظام إقليمي مشترك للطوارئ النووية، في تأكيد على قناعة راسخة بأنّ التعاون الجماعي يمثّل الخيار الأمثل لسدّ ثغرات الاستجابة الفردية في مواجهة التهديدات النووية أو السيبرانية.
عند السؤال عن مدى استعداد المنطقة لاحتمال نشوب حرب نووية، أشار غالبية المشاركين بنسبة مرتفعة (87%) إلى أنّ الشرق الأوسط غير مؤهّل للتعامل مع هذا السيناريو. وبالمقارنة مع السؤال السابق المتعلّق بالأعطال النووية والهجمات السيبرانية، يكشف هذا التصوّر المتزايد لغياب الجاهزية عن نوع التهديدات التي تُثقل كاهل المشاركين وتشغل أذهانهم بصورة أكبر. ويُستدل من هذا التباين على أنّ الحرب النووية تُعدّ، على وجه التحديد، مصدر القلق الأكثر إلحاحًا، وهو ما يُعزى على الأرجح إلى ما ينطوي عليه هذا السيناريو من آثار كارثية، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر في المنطقة.
يُعَدّ "اتجاهات الرأي العام" سلسلة تحليلية قائمة على البيانات، ترصد اتجاهات الرأي العام حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ويُشرف على إعدادها كبار الباحثين في برنامج الإنذار المبكر التابع لمركز الحبتور للأبحاث: حبيبة ضياء الدين وأحمد السعيد.
وتستند النتائج المعروضة إلى بيانات جُمعت من خلال استطلاعات رأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونماذج إلكترونية وُزّعت بالبريد الإلكتروني. وعلى الرغم من الحرص على تنويع العينة وتوسيع نطاقها، فإن هذه النتائج تعكس آراء المشاركين فحسب، ولا ينبغي اعتبارها تمثّل الرأي العام بمجمله أو تعكس مواقف مركز الحبتور للأبحاث.
17 يوليو 2025
السويداء بين وهم تقرير المصير وحدود الواقع
تبرز محافظة السويداء السورية بوصفها ساحة شديدة التعقيد سياسيًا وهوياتيًا، في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد وتشكّل حكومة انتقالية مركزية جديدة، تطالب بعض أطرافها بتقرير المصير. ويهدف هذا التحليل إلى دراسة سيناريو استفتاء محتمل في السويداء، لا من منطلق الترويج له أو رفضه، بل لفهم العوامل البنيوية والتاريخية التي قد تحدد مآلاته. يعتمد التحليل على مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الانقسام الداخلي الحاد في المجتمع الدرزي، والتنافر بين مشاريع الحكم الذاتي والمركزية الدستورية الجديدة، والانهيار الاقتصادي شبه الكامل، والتداخل الإقليمي الحاد. وذلك استنادًا إلى مصادر قانونية، تاريخية، وميدانية، بما يُبرز كيف أن غياب شروط الاستقرار السياسي والأمني، وتعدد اللاعبين المحليين والدوليين، يجعل من فكرة الاستفتاء، في هذا التوقيت، خطوة شديدة الخطورة قد تؤدي إلى تفكك داخلي وعنف مسلح.
16 يوليو 2025
تحرك الجبل: هل تعيد أحداث السويداء ترتيب أولويات السلطة في سوريا؟
شهدت سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 نقطة تحوّل سياسية محورية أدت إلى دخول البلاد مرحلة جديدة ذات تعقيدات متعددة، اتسمت بتولي أحمد الشرع رئاسة الدولة مؤقتًا. وقد تميزت هذه الفترة الانتقالية بمساعي مكثفة لتحقيق الاستقرار الأمني، وتضافر الجهود لتوحيد الفصائل المسلحة المنقسمة، فضلًا عن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة على الصعيد الوطني. ضمن هذا المشهد المتغير، برزت محافظة السويداء الجنوبية ذات الغالبية الدرزية كبؤرة توتر استراتيجية، حيث اكتسبت التطورات العسكرية الأخيرة فيها أبعادًا هامة قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق البلاد. يركز هذا التحليل على استعراض التطورات السويداء كمفتاح لفهم التوازنات السياسية والعسكرية في سوريا، إضافة إلى تقييم فرص ومسارات الحل السياسي بين دمشق وقسد.
15 يوليو 2025
من العزلة إلى التدخل: الانعطافة الكبرى لترامب في الشرق الأوسط
جرت مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير 2025، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد. وقد عرض ترامب، خلال خطابه الافتتاحي، أجندة واسعة النطاق تمزج بين الأسس التقليدية للمحافظين وبعض ملامح الشعبوية الصاعدة. ومن اللافت للنظر، أنه وقّع في يوم تنصيبه على 26 أمرًا تنفيذيًا، وهو أعلى عدد يوقعه أي رئيس أمريكي في اليوم الأول من ولايته. تتمحور أجندة ترامب في ولايته الثانية حول شعارات "أميركا أولًا"، "الانتقام، و"فرض القانون والنظام"، حيث يسعى إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بوجه أكثر صرامة، واستعادة السياسات المتشددة التي انتهجها خلال فترته الأولى، فضلًا عن إعادة صياغة الدور الأميركي عالميًا من خلال نهج حمائي وتقليص انخراط الولايات المتحدة على المستوى الدولي.
لطالما شدد ترامب على تجنب الحروب الخارجية وتبني سياسة خارجية لا تقوم على التدخل، مع التركيز بدلًا من ذلك على أمن الحدود والنمو الاقتصادي. وقد عارض ما سمّاه "الحروب التي لا تنتهي"، ودعا إلى تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخارج. وأكد مرارًا أن الولايات المتحدة يجب ألا تنخرط في حروب باهظة الكلفة في الشرق الأوسط لا تخدم مصالحها بشكل مباشر، مستخدمًا شعارات من قبيل "لسنا شرطيّ العالم" و"أنهِوا الحروب التي لا تنتهي". كما وجّه انتقادات حادة للإدارات السابقة بسبب انخراطها الطويل في النزاعات العسكرية في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا. غير أن أفعال ترامب، منذ دخوله المكتب البيضاوي في ولايته الثانية، أظهرت انحرافًا ملحوظًا عن نهجه المُعلن القائم على عدم التدخل.
14 يوليو 2025
هل تنجح دبلوماسية الرياضة في تخفيف حدة التوترات السياسية العالمية؟
لم تكن دبلوماسية الرياضة وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ؛ إذ تعود بداياتها إلى العصور القديمة، حين اعتادت المدن-الدول اليونانية تعليق نزاعاتها المسلحة للمشاركة في الألعاب الأولمبية، التي كانت تُقام في أجواء يسودها السلام والاحترام المتبادل. وقد استندت الحركة الأولمبية الحديثة، التي أُعيد إطلاقها عام 1896، إلى المبادئ ذاتها، مناديةً بوحدة البشرية من خلال التنافس الرياضي الشريف.
ومع ذلك، لم تكن الرياضة بمنأى عن التوظيف السياسي، إذ استُغلت أحيانًا كأداة دعائية أو وسيلة لتعزيز النفوذ الدولي. ولعل أبرز مثال على ذلك أولمبياد برلين عام 1936، حين سخّرت ألمانيا النازية الألعاب الأولمبية لترويج أفكارها القومية. وفي المقابل، أثبتت الرياضة في مناسبات أخرى قدرتها على لعب دور إيجابي في تهدئة النزاعات السياسية وبناء جسور التواصل. فعلى سبيل المثال، ساهمت ما عُرف بـ"دبلوماسية كرة الطاولة" بين الولايات المتحدة والصين في مطلع السبعينيات من القرن الماضي في تهيئة الأجواء لزيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى بكين عام 1972، والتي شكّلت منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مدى فاعلية دبلوماسية الرياضة كأداة من أدوات القوة الناعمة في تخفيف حدة التوترات بين الدول، واستكشاف إمكاناتها في تشكيل بيئات أكثر تعاونًا في عالم يزداد استقطابًا.
9 يوليو 2025
معضلة التخصيب الإيراني: بين السيادة النووية وهواجس الانتشار العالمي
تُشكّل أزمة تخصيب اليورانيوم في إيران المحور الجوهري للصراع النووي القائم، حيث تتقاطع الاعتبارات التقنية مع محددات السيادة الوطنية، ويتداخل القانون الدولي مع منطق الردع الاستراتيجي. فمن منظور الجمهورية الإسلامية، يُعدّ امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، بما في ذلك التخصيب على أراضيها، حقًا أصيلًا ومكفولًا بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT). غير أن هذا "الحق" يتجاوز في الوعي السياسي الإيراني كونه خيارًا تكنولوجيًا، ليتحوّل إلى رمز سيادي وركيزة في سردية الاستقلال الوطني والتحدي لهيمنة القوى الغربية.
في المقابل، تنظر الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى التقنية ذاتها بوصفها البوابة المباشرة نحو إنتاج سلاح نووي. فالمعمار الفني القائم على أجهزة الطرد المركزي يتيح – مع توافر القرار السياسي – الانتقال من التخصيب المنخفض إلى إنتاج مادة انشطارية قابلة للتفجير خلال أسابيع معدودة. وقد تعاظمت هذه المخاوف بصورة غير مسبوقة عقب تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2025 أن إيران راكمت ما يزيد عن 400 كيلوغرام من اليورانيوم المُخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي نظريًا لإنتاج ثلاث إلى خمس قنابل نووية بمجرد رفع النقاء إلى 90%، دون حاجة لإضافة بنية تحتية جديدة.
الخبرة التاريخية الإيرانية – من حرمانها من حصتها في مشروع Eurodif عام 1979 إلى انهيار مبادرة مفاعل طهران البحثي عام 2009 – عززت قناعة راسخة لدى النخبة الحاكمة بأن الاعتماد على الخارج في تأمين الوقود النووي ليس خيارًا موثوقًا. ومن ثمّ، فإن أي صيغة تفاوضية تتطلب التخلي عن التخصيب المحلي تُعدّ، من المنظور الإيراني، مساسًا جوهريًا بالكرامة السيادية والأمن الاستراتيجي للدولة.
وعليه، فإن جوهر الأزمة لا يكمن في مستويات التخصيب أو أعداد أجهزة الطرد، بل في البنية السياسية العميقة لانعدام الثقة المتبادل. ولن يكون ممكنًا بلوغ تسوية مستدامة إلا ضمن إطار أمني أشمل يُعيد تعريف العلاقة بين إيران والنظام الإقليمي والدولي على أسس جديدة.
لذلك ينطلق هذا التحليل من مقاربة متعددة المستويات تُعالج أزمة التخصيب الإيراني بوصفها مسألة تتجاوز الطابع التقني، لتلامس جوهر الصراع بين السيادة الوطنية وهواجس الانتشار النووي. ويتناول التحليل أربعة محاور رئيسية: الخصائص التقنية للتخصيب، الدوافع السياسية والاستراتيجية الإيرانية، الحسابات الأمنية الغربية، وأطر الحلول المقترحة، مع التأكيد على أن أي تسوية دائمة تقتضي إعادة تعريف العلاقة بين إيران والنظام الدولي.