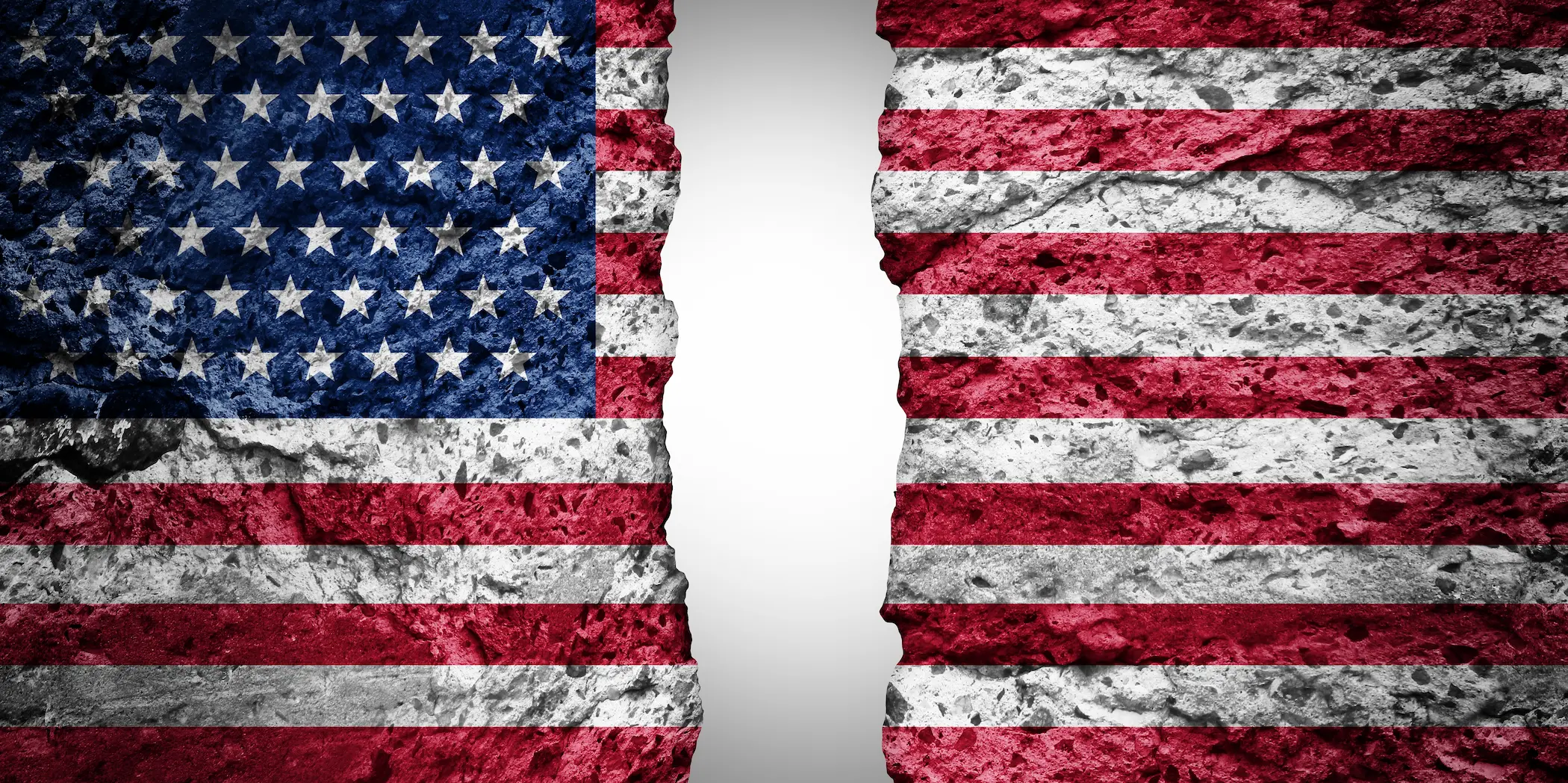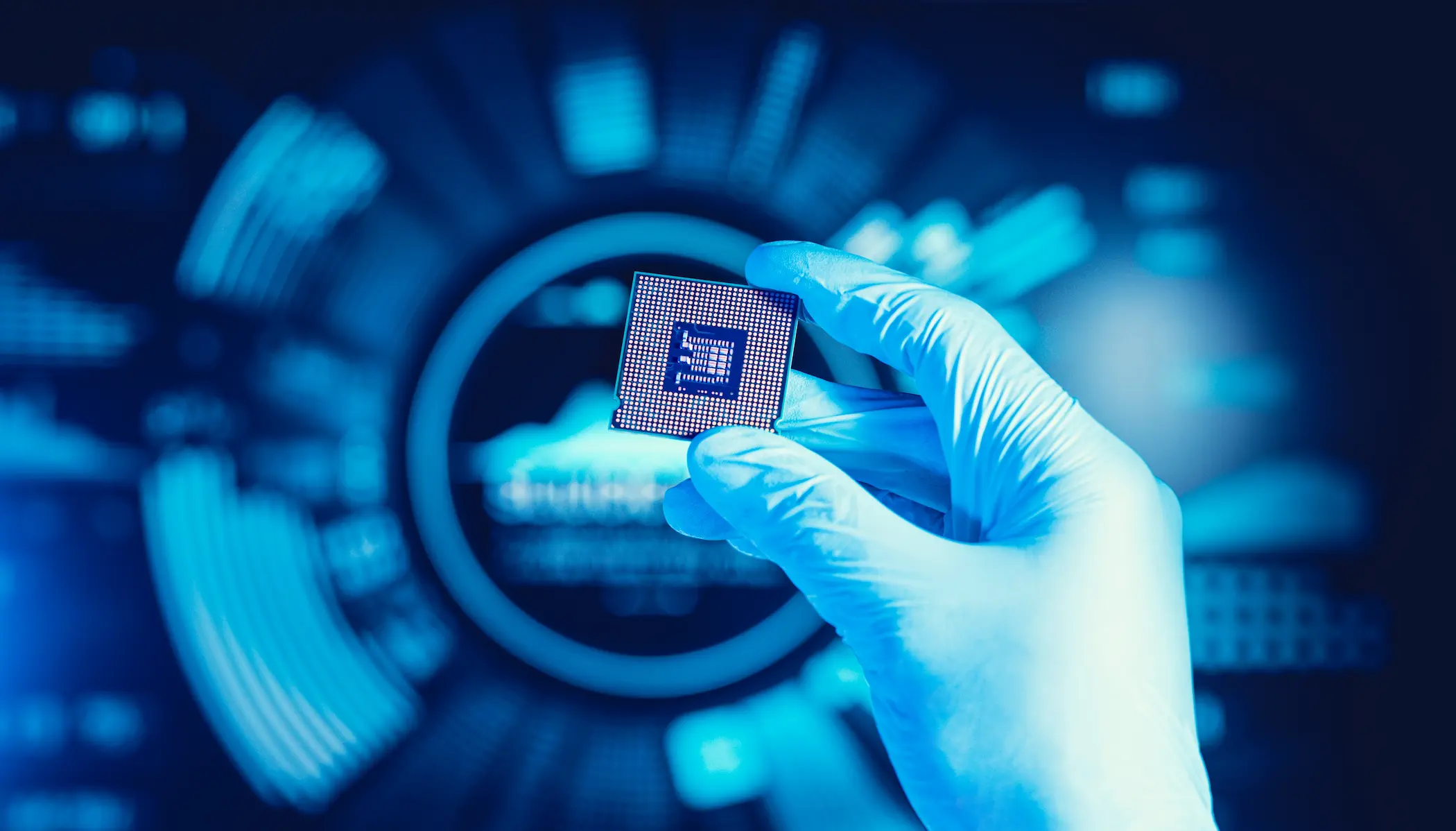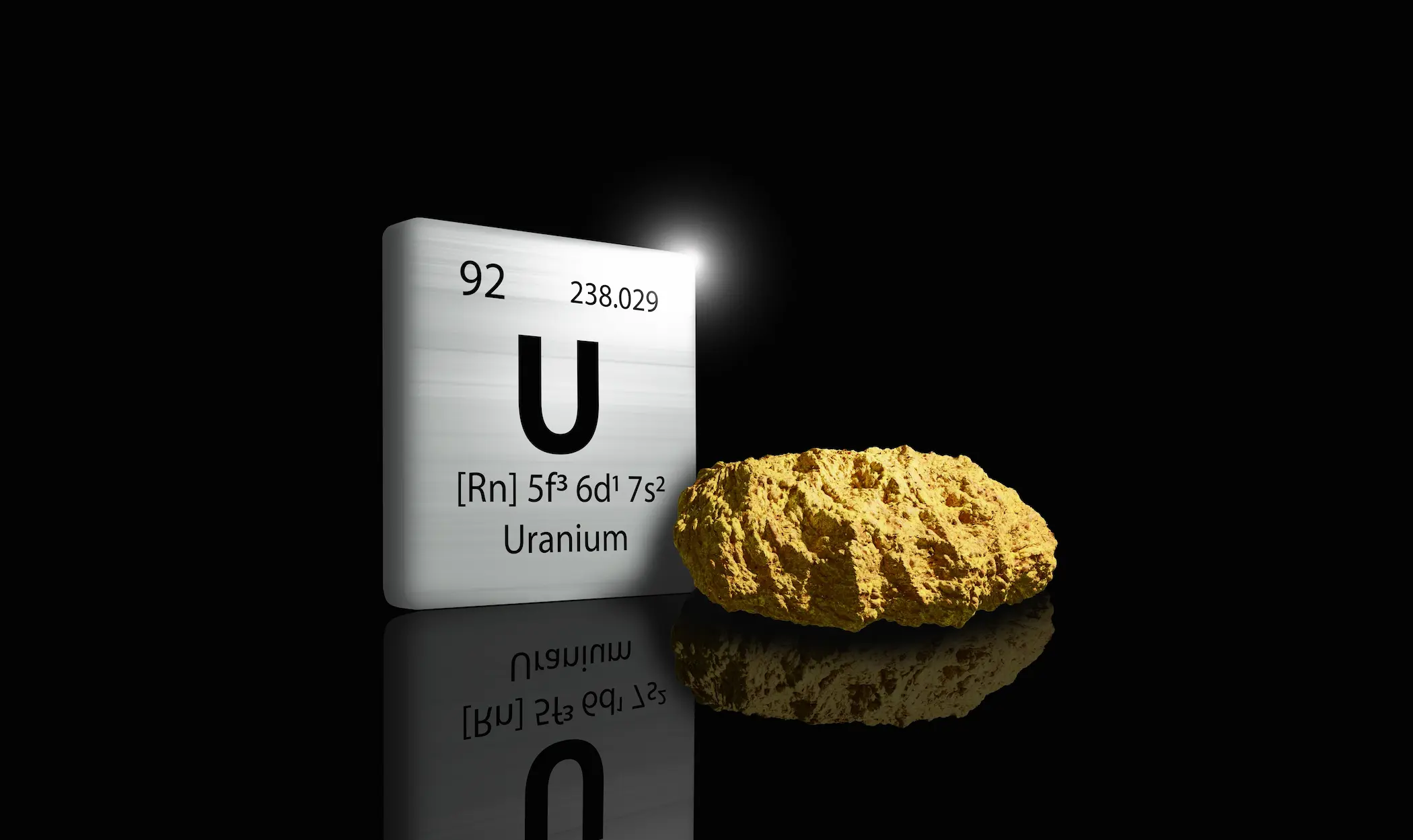16 أكتوبر 2025
صدمة Ozempic: كيف يُساهم عقار واحد تشكيل أنظمة الغذاء والتأمين في العالم؟
شهد العالم صعودًا طبيًّا واقتصاديًّا سريعًا لعقار سيماجلوتايد Semaglutide ، الذي يُسوّق بأسماء تجارية مختلفة أبرزها Ozempic. ورغم اعتماده الأساسي لعلاج السكري من النوع الثاني، فقد تجاوز نطاقه العلاجي الرسمي ليُصبح محورًا لتحوّلات عميقة في سلوك الأفراد، وتفاعلات الأسواق، وأولويات السياسات الصحية.
إذ ترتكز أهمية هذا العقار في آليته المركبة التي تُعيد تنظيم إشارات التمثيل الغذائي والشهية داخل الجسم، وهو ما أسهم في خلق تحول ملحوظ بين استعماله المُعتمد واستخدامه الفعلي المتسارع لأغراض إدارة الوزن. هذا التباين بين التشريع والاستهلاك يتجاوز مجرد الظاهرة الطبية، ليُشكل نقطة تقاطع معقدة بين الثقافة الشعبية، ونماذج التأمين وسلاسل الإمداد وأنماط الزراعة وسلوك الأسواق العالمية.
وفي ظل هذا المشهد المتشابك، تبرز تساؤلات مركزية حول تكلفة العلاج وعدالة الوصول إليه واستدامة الأنظمة الصحية في مواجهته. يهدف هذا التحليل إلى دراسة هذا التحوّل من جذوره الطبية إلى امتداداته العالمية، من خلال قراءة متعددة الأبعاد تشمل آثاره القطاعية داخل الولايات المتحدة، وافتراضات مستقبلية تتعلق بإمكانية تحوّله إلى أداة صحية عالمية منخفضة التكلفة.
10 أكتوبر 2025
ماذا يعني انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟
يشهد الملف النووي الإيراني تصعيدًا متسارعًا، يبرز في خضمه القرار المٌحتمل بانسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو ما قد يعيد تعريف منظومة الحوكمة النووية الدولية. ويطرح هذا التوجه - إن تحقق- سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة ذاتها عام ٢٠٠٣، ليتحول من مجرد موقف تفاوضي إلى نقطة تحول استراتيجية عميقة تؤثر في سياسات الشرق الأوسط والعالم بآسره.
ولم تظهر هذه التهديدات الإيرانية، التي بدأت تتصاعد منذ يونيو ٢٠٢٥ من فراغ، بل جاءت كرد فعل مباشر على تطورات استراتيجية متعاقبة، فقد دفعت الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو ٢٠٢٥ الموقف نحو التعقيد، ثم زادت حدة الأزمة حين أعلنت الترويكا الأوروبية (E3) في سبتمبر ٢٠٢٥ تفعيل "آلية الزناد" التي أعادت فرض العقوبات الأممية على طهران. وقد دفعت هذه الإجراءات مجتمعة إيران إلى اعتبار أن الجدوى الاقتصادية والسياسية من استمرار التزامها بالمعاهدات الدولية قد تلاشت.
وتتجاوز خطورة الموقف أبعاده السياسية لتشمل جوانب فنية وقانونية بالغة الدقة. فعلى الصعيد الفني، تمتلك إيران مخزونًا يتراوح بين ٤٠٠ و٤٥٠ كيلوجرامًا من اليورانيوم المٌخصب المفقود بنسبة ٦٠٪، وهي كمية تضعها على بعد أسابيع قليلة فقط من إنتاج المادة الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي بتخصيب يصل إلى ٩٠٪. أما على الصعيد القانوني، فسيؤدي لجوء إيران إلى تفعيل المادة العاشرة من المعاهدة إلى إنهاء فوري للرقابة الدولية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيُخرج اتفاقية الضمانات الشاملة من المعادلة، مما يفتح الباب أمام عزل دبلوماسي شبه تام. وبذلك، تتخطى التداعيات المترتبة على الانسحاب حدود البرنامج النووي الإيراني لتؤسس لمعضلة أمنية إقليمية واسعة النطاق.
7 أكتوبر 2025
على حافة الهاوية: مآلات تصاعد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة
يعكس حادث إطلاق النار على الناشط اليميني المحافظ تشارلي كيرك في 10 سبتمبر بجامعة وادي يوتا في مدينة أورِم – يوتا، أثناء مناظرة مخصّصة لأسئلة وأجوبة، حجم الانقسامات العميقة في المجتمع الأميركي ومشهدَه السياسي المضطرب. كما يجسّد هذا الحادث إحدى التداعيات الخطيرة لحالة الاستقطاب الحادّ التي تعصف بالولايات المتحدة، وما ترتّب عليها من تصاعد العنف السياسي.
ترسّخ الاستقطاب الأيديولوجي في الولايات المتحدة بعمق داخل المجتمع، فيما أفرزت السنوات الأخيرة مشهدًا سياسيًا أكثر انقسامًا حول توجهات السياسات الداخلية والخارجية للحكومة، بما في ذلك قضايا الضرائب والهجرة والمساعدات لأوكرانيا وحرب إسرائيل في غزة. فمنذ اندلاع الحرب في غزة، دأبت الحكومة الأميركية على تقديم دعم عسكري ومالي ودبلوماسي واسع لإسرائيل، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) مرارًا لإجهاض قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار، وهو ما عمّق الفجوة بين توجهات السلطة الرسمية ومواقف الشارع، لا سيما بين صفوف الأجيال الشابة. وقد شهدت الجامعات الأميركية موجات واسعة من الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة والداعمة لفلسطين، قوبلت بعنف من قوات الشرطة واعتقالات وتهديدات بترحيل الطلاب الأجانب. وفي السياق ذاته، يُعدّ تشارلي كيرك من أبرز المؤيدين لإسرائيل وسياساتها في غزة، غير أنّه أثار شكوكًا حول الخروقات الأمنية الإسرائيلية وكيف تمكنت حركة حماس من اختراق منظومة الدفاع الإسرائيلية.
يشكّل تشارلي كيرك نموذجًا حيًّا لحالة الاستقطاب المتجذّرة في الولايات المتحدة، إذ مثّلت آراؤه المحافظة نقطة جذب لشرائح واسعة من المؤيدين، لكنها في الوقت نفسه كانت مصدرَ صدامٍ متكرر مع توجهات الحزب الديمقراطي. وقد أعاد حادث إطلاق النار عليه طرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا العنف تعبيرًا عن الانقسام العميق الذي يعصف بالمجتمع الأميركي، وحول مدى ارتباط القضايا الجدلية مثل قضايا النوع الاجتماعي والهجرة وحرب غزة بتغذية موجات العنف السياسي المتزايد الناتج عن الاستقطاب الحاد داخل البلاد.
مع اقتراب الانتخابات البلدية وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، تثار تساؤلات حول ما إذا كان الحزب الجمهوري سيسعى إلى توظيف موجة العنف السياسي الناتجة عن الاستقطاب الحاد لتحقيق مكاسب انتخابية، في مقابل قدرة الحزب الديمقراطي على تجاوز انقساماته الداخلية واستثمار المخاوف العامة من النهج المتشدد الذي اتبعته إدارة ترامب في التعامل مع حادث اغتيال تشارلي كيرك.
2 أكتوبر 2025
خوارزميات الإبادة: من وادي السيليكون إلى قطاع غزة
لم تعد أدوات النزاعات العسكرية خلال القرن الحادي والعشرين تقتصر على الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ والدبابات والطائرات، بل اتسعت لتشمل منصات الحوسبة السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرات معالجة البيانات التي تطورها وتديرها شركات تكنولوجيا عملاقة مقرها الولايات المتحدة، مثل مايكروسوفت وجوجل وأمازون. لقد أضحت هذه الشركات ركائز أساسية في دعم الحروب الرقمية الحديثة، فصارت قراراتها وسياساتها تمتد إلى مستويات عميقة من التأثير الجيوسياسي، لتشكل جزءاً محورياً من منظومة القوة الحديثة على الساحة الدولية.
في هذا السياق، شهدت العلاقة بين شركات التكنولوجيا التجارية والجيش الإسرائيلي تطوراً جذرياً، تجاوز نمط التعاون التقليدي في توريد الأجهزة والبرمجيات ليحول البنية الرقمية إلى محور أساسي لإدارة الصراع الحديث، خصوصاً خلال الحرب على غزة. حيث برز نمط جديد من التداخل بين القطاعات العسكرية والخاصة، إذ أضحت البنية الرقمية التجارية جزءاً لا يتجزأ من القدرات العسكرية، ما ساهم في تشويش الحدود بين الخدمات التجارية والمنظومات الأمنية الرسمية. ولم تعد إدارة الرواية العالمية حول الكوارث الإنسانية، مثل أزمة المجاعة المؤكدة والتقارير المستمرة عن جرائم الإبادة، منفصلة عن سياسات المحتوى التي تديرها منصات كبرى تخضع لسيطرة شركات التكنولوجيا، حيث تساهم هذه المنصات في تضخيم الرواية الرسمية وتهميش أو إنكار خطورة المجاعة والصراع، وتتيح في الوقت نفسه إمكانيات مراقبة عميقة تقمع الإعلام المستقل داخل مناطق النزاع.
وسلط الصراع في غزة الضوء على الدور المزدوج والمتزايد التعقيد لشركات التكنولوجيا الكبرى، وتحديدًا جوجل (ألفابت) - Google Alphabet Inc- ومايكروسوفت ( Microsoft Corporation)، في الحروب الحديثة والتحكم العالمي في المعلومات. حيث انخرطت هذه الشركات منخرطة في ديناميكية تآزريه توفر البنية التحتية الأساسية والمخصصة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والتي تُسهّل عمليات عسكرية فتكية غير مسبوقة ومراقبة جماعية داخل قطاع غزة والأراضي المحتلة، بينما تستخدم في الوقت نفسه آليات متطورة للتحكم في المعلومات - بما في ذلك الرقابة الداخلية، والتحيز الخوارزمي، وقمع البيانات - لإعادة تشكيل السرد العام وتخفيف مساءلة الشركات. لذا يسعي هذا التحليل التركيز على دور شركات التكنولوجيا في ديناميات وتداعيات الصراع في غزة، وكيف تسهم في هندسة المجال المعلوماتي والسياسي والإنساني ضمن بيئة النزاع المعاصر وهو ما يحول هذه الشركات من مقدمي خدمات محايدين إلى مشاركين فاعلين في البنية التحتية في الصراع.
23 سبتمبر 2025
الحرب الباردة لأشباه الموصلات: الولايات المتحدة في مواجهة روسيا والصين والهند
أضحى التنافس العالمي حول أشباه الموصلات والتقنيات العسكرية المرتبطة بها المحور المركزي في صراع القوى الكبرى. ولا تزال الولايات المتحدة تحافظ على موقعها الريادي في صناعة أشباه الموصلات عالميًا، حيث تستحوذ الشركات الأميركية على نحو نصف السوق العالمية. غير أن هذه الهيمنة تواجه تحديًا متناميًا من الصين، التي شكّلت مبيعاتها نحو 20% من السوق العالمية لأشباه الموصلات في عام 2024. وتمضي بكين بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، على الرغم من استمرار التوترات التجارية والقيود المفروضة من واشنطن على حقوق الملكية الفكرية في إطار ما يُعرف بـ"الحرب التكنولوجية". وتطمح الصين إلى بلوغ مستوى 50% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج أشباه الموصلات مع نهاية العام، مدعومةً باستثمارات ضخمة في مجال البحث والتطوير والتوسع السوقي لشركاتها الوطنية.
وفي المقابل، فإن موقع روسيا في الصناعات العسكرية المعتمدة على أشباه الموصلات بات يواجه قيودًا متزايدة. فعلى الرغم من احتفاظ موسكو بخبرة واسعة في مجال تصميم الأسلحة، إلا أنّ اعتمادها على المواد المستوردة ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة من الدول الغربية يكشف عن ثغرات حرجة في بنيتها التكنولوجية. وقد أدّت العقوبات الغربية المفروضة ردًّا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تقليص حاد في قدرة موسكو على الوصول إلى هذه المدخلات الأساسية. وفي مواجهة ذلك، سعت روسيا إلى إيجاد مصادر بديلة، لتبرز الصين كمزوّد رئيسي لمواد أشباه الموصلات. وتشكل هذه الديناميات جزءًا من الإطار الثلاثي الأوسع الذي يجمع روسيا والهند والصين (RIC)، والذي يرسّخ التحوّل الاستراتيجي لموسكو نحو شراكاتها الشرقية.
وفي الوقت ذاته، تشهد الهند تطورًا متسارعًا يجعلها لاعبًا بارزًا في قطاع أشباه الموصلات. وقد شكّل إعلانها في سبتمبر عن شريحة محلية الصنع تحمل اسم "فيكرام 32 - Vikram 32" محطة مفصلية في مساعي نيودلهي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، كما يعكس مؤشّرًا على احتمال بروزها كمنافس للهيمنة الأميركية في هذا القطاع الحيوي. ويعكس تزايد انخراط الهند مع روسيا والصين حالة من الاصطفاف البراجماتي القائم على المصالح المتبادلة، لا سيّما في ظل تصاعد التوترات السياسية مع واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أنّ الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على تجارة الهند في النفط الروسي قد شكّلت حافزًا إضافيًا لتعزيز هذا التعاون الثلاثي.
وعلى نحوٍ جماعي، تمثّل "الترويكا" المكوّنة من الصين وروسيا والهند ائتلافًا قائمًا على المصالح المشتركة أكثر من كونها تحالفًا أيديولوجيًا متكاملًا. وإذا ما تعزّزت هذه الشراكة، فقد يسهم ذلك في دعم قدراتها التصنيعية في مجال أشباه الموصلات بشكلٍ ملحوظ، ويمثل تحديًا جسيمًا للصناعة الأميركية. ومع ذلك، تبقى الخلافات العالقة — مثل النزاعات الحدودية غير المحسومة، وتباين الأولويات الاقتصادية، والفجوات التكنولوجية، فضلًا عن تأثير العقوبات — عائقًا أمام تحقيق اندماج تقني سلس. ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا معتبرًا على الهند، من خلال فرص جذبها عبر زيادة الاستثمارات، وخفض الرسوم الجمركية، والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي نهاية المطاف، فإن مسار الشراكة الثلاثية في قطاع أشباه الموصلات يحمل انعكاسات عميقة على النظام الدولي. إذ إن نجاح دمج هذه "الترويكا" لصناعتها في مجال الرقائق مع تقنياتها العسكرية قد يفضي إلى تسريع بروز نظام متعدد الأقطاب، ويحدث ثورة في قدرات المراقبة والدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، إلى جانب القاعدة الصناعية الدفاعية الأوسع، الأمر الذي من شأنه إعادة تشكيل ديناميات القوة على الصعيد الدولي.
1 سبتمبر 2025
هل يستطيع الجيش اللبناني التصدي لحزب الله؟
يواجه لبنان اليوم مفترق طرق حاسم يهدد سيادته الوطنية بشكل مباشر، ويتجلى هذا التحدي في قضية حصر سلاح حزب الله. ففي الخامس من أغسطس 2025، أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا مهمًا يكلف القوات المسلحة بوضع خطة لإرساء احتكار الدولة للأسلحة، بحيث يقصر حمل السلاح على مؤسسات الدولة فقط، تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، مع الالتزام بتنفيذ الخطة قبل نهاية العام الجاري. ويُعتبر هذا القرار نقطة تحول استراتيجية تضع حزب الله أمام خيارات معقدة، ما بين نزع السلاح الطوعي، أو التوجه نحو التحول السياسي، أو مواجهة عسكرية مباشرة مع الجيش اللبناني.
أما حزب الله، فيرفض هذا القرار بوصفه خطيئة كبرى، مهددًا بتجاهله، واعتبار نزع السلاح تهديدًا مباشرًا لمقاومة لبنان في مواجهة العدوان الخارجي. ويواجه القرار تحديات جمة نظرًا للدعم الشعبي والسياسي الكبير الذي يحظى به الحزب، بالإضافة إلى المناورات السياسية الرامية إلى عرقلة تنفيذ أي إجراءات تستهدف سلاحه. وفي ظل هشاشة النظام السياسي والطائفي في لبنان، تبرز مخاطر كبيرة من اندلاع مواجهة تؤدي إلى تصاعد الاحتقان الداخلي وزعزعة الاستقرار الأمني، مما يجعل أي صدام عسكري مباشر بين الجيش وحزب الله محفوفًا بالمخاطر، مع احتمال تفاقم الانقسامات الطائفية واتساع دائرة العنف. فهل سيتمكن الجيش اللبناني من مواجهة حزب الله؟
17 أغسطس 2025
تأثير الدومينو: هل تتجه المزيد من الدول للاعتراف بفلسطين؟
أثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والتي تبعتها دول أوروبية أخرى، بشأن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المُقبل تحولًا بارزًا في سياسات القوى الغربية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية. جاء هذا التحول في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تجلت في مجاعة واسعة النطاق وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 60 ألف شخص، مما زاد من وتيرة الدعوات الدولية لحل سياسي عاجل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
تمثل إعلانات باريس ولندن وأوتاوا، خصوصًا التعهد غير المشروط من فرنسا والنهج المشروط من المملكة المتحدة وكندا، خروجًا واضحًا عن الاعراف الدبلوماسية التقليدية التي كانت ترتبط بالاعتراف بدولة فلسطينية موكولًا إلى التوصل لاتفاق سلام تفاوضي شامل. يعكس هذا التحول حالة من الإحباط المتزايد تجاه تعثر مسار السلام، بالإضافة إلى تبلور قناعة بأن المسارات التقليدية لم تعد تجدي نفعًا، إذ صار الاعتراف بدولة فلسطين يُنظر إليه ليس فقط كنتيجة للسلام، بل كوسيلة تحفيزية لدفع العملية السياسية قدمًا، ما يعيد صياغة الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمعالجة الصراع ويؤسس لسابقة قد تستفيد منها دول أخرى في تعزيز ضغوطها الدولية.
على الصعيد الدولي، تعترف ما بين 140 إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، وهو إجماع واسع يشكل الإطار المرجعي لفهم القرارات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. ومن اللافت أن هذه الدول الثلاث أعضاء في مجموعة السبع، التي لم تتخذ قبل إعلان فرنسا أي منها خطوة مماثلة، مما يجعل فرنسا، بوصفها أكبر دولة أوروبية سكانًا، تبرز كفاعل بارز في هذا التحول، بينما تستعد فرنسا وكندا لتكونا أول دولتين من المجموعة تعترفان بفلسطين.
في المقابل، تظل الولايات المتحدة العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الدولي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ما يضفي على هذا التغيير بعدًا رمزيًا يؤسس لإعادة توازن الضغوط الدبلوماسية على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وقد يحفز دولًا غربية أخرى مترددة على السير في ذات الاتجاه. كما يبرز اختلاف المواقف داخل القوى الأطلسية تأثير الضغوط الداخلية والأزمة الإنسانية الملحة في بلورة مواقف أكثر تشدّدًا. بناءً على ذلك، يتناول هذا التحليل دوافع هذا التحول وآثاره على الصعيدين الأمني والسياسي للدول المعنية، إلى جانب ردود الفعل المتوقعة من إسرائيل والولايات المتحدة.
15 يوليو 2025
من العزلة إلى التدخل: الانعطافة الكبرى لترامب في الشرق الأوسط
جرت مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير 2025، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد. وقد عرض ترامب، خلال خطابه الافتتاحي، أجندة واسعة النطاق تمزج بين الأسس التقليدية للمحافظين وبعض ملامح الشعبوية الصاعدة. ومن اللافت للنظر، أنه وقّع في يوم تنصيبه على 26 أمرًا تنفيذيًا، وهو أعلى عدد يوقعه أي رئيس أمريكي في اليوم الأول من ولايته. تتمحور أجندة ترامب في ولايته الثانية حول شعارات "أميركا أولًا"، "الانتقام، و"فرض القانون والنظام"، حيث يسعى إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بوجه أكثر صرامة، واستعادة السياسات المتشددة التي انتهجها خلال فترته الأولى، فضلًا عن إعادة صياغة الدور الأميركي عالميًا من خلال نهج حمائي وتقليص انخراط الولايات المتحدة على المستوى الدولي.
لطالما شدد ترامب على تجنب الحروب الخارجية وتبني سياسة خارجية لا تقوم على التدخل، مع التركيز بدلًا من ذلك على أمن الحدود والنمو الاقتصادي. وقد عارض ما سمّاه "الحروب التي لا تنتهي"، ودعا إلى تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخارج. وأكد مرارًا أن الولايات المتحدة يجب ألا تنخرط في حروب باهظة الكلفة في الشرق الأوسط لا تخدم مصالحها بشكل مباشر، مستخدمًا شعارات من قبيل "لسنا شرطيّ العالم" و"أنهِوا الحروب التي لا تنتهي". كما وجّه انتقادات حادة للإدارات السابقة بسبب انخراطها الطويل في النزاعات العسكرية في العراق وأفغانستان وليبيا وسوريا. غير أن أفعال ترامب، منذ دخوله المكتب البيضاوي في ولايته الثانية، أظهرت انحرافًا ملحوظًا عن نهجه المُعلن القائم على عدم التدخل.
14 يوليو 2025
هل تنجح دبلوماسية الرياضة في تخفيف حدة التوترات السياسية العالمية؟
لم تكن دبلوماسية الرياضة وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ؛ إذ تعود بداياتها إلى العصور القديمة، حين اعتادت المدن-الدول اليونانية تعليق نزاعاتها المسلحة للمشاركة في الألعاب الأولمبية، التي كانت تُقام في أجواء يسودها السلام والاحترام المتبادل. وقد استندت الحركة الأولمبية الحديثة، التي أُعيد إطلاقها عام 1896، إلى المبادئ ذاتها، مناديةً بوحدة البشرية من خلال التنافس الرياضي الشريف.
ومع ذلك، لم تكن الرياضة بمنأى عن التوظيف السياسي، إذ استُغلت أحيانًا كأداة دعائية أو وسيلة لتعزيز النفوذ الدولي. ولعل أبرز مثال على ذلك أولمبياد برلين عام 1936، حين سخّرت ألمانيا النازية الألعاب الأولمبية لترويج أفكارها القومية. وفي المقابل، أثبتت الرياضة في مناسبات أخرى قدرتها على لعب دور إيجابي في تهدئة النزاعات السياسية وبناء جسور التواصل. فعلى سبيل المثال، ساهمت ما عُرف بـ"دبلوماسية كرة الطاولة" بين الولايات المتحدة والصين في مطلع السبعينيات من القرن الماضي في تهيئة الأجواء لزيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى بكين عام 1972، والتي شكّلت منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مدى فاعلية دبلوماسية الرياضة كأداة من أدوات القوة الناعمة في تخفيف حدة التوترات بين الدول، واستكشاف إمكاناتها في تشكيل بيئات أكثر تعاونًا في عالم يزداد استقطابًا.
10 يوليو 2025
منعطف حاسم: من يرسم ملامح مستقبل الحزب الديمقراطي
بعد خسارته للانتخابات الرئاسية ومجلسي الشيوخ والنواب، كان من الطبيعي أن يبادر الحزب الديمقراطي إلى مراجعة عميقة لأسباب هذا الرفض الشعبي، وأن يعيد النظر في سياساته وخطابه ومرشحيه، تمهيدًا لإعادة بناء صفوفه استعدادًا لمواجهة إدارة ترامب الثانية، التي تبدو أكثر جرأةً واندفاعًا نحو تفكيك أبرز ما أنجزه الحزب من مكتسبات خلال العقود الماضية. لكن ما حدث كان عكس المتوقع. فقد بدا الحزب غارقًا في حالة من التيه السياسي والصراع الداخلي المحتدم، تتنازعه رؤى متباينة حول هويته الحقيقية ومساره المستقبلي، وسط عجز واضح عن التوصل إلى تعريف جامع لمعنى أن يكون المرء ديمقراطيًا في زمن ترامب.
وتُجسّد هذه الانقسامات اختلافًا جذريًا في الرؤية حول جوهر المشروع الديمقراطي: هل المطلوب هو السير في مسار الإصلاح التدريجي أم الدفع باتجاه تغيير جذري في بنية النظام؟ هل السبيل هو اعتماد منطق التسويات السياسية أم تبني نهج المواجهة الصريحة؟ وهل يجب أن تكون القابلية للانتخاب هي الأولوية، أم أن الالتزام بالمبادئ يجب أن يتقدّم على اعتبارات الربح السياسي؟ وبغياب سردية جامعة، وقيادة تمتلك القدرة على تجاوز هذه التصدّعات، يجد الحزب الديمقراطي نفسه مهددًا بالشلل، في لحظة مفصلية من التاريخ الأمريكي، تتطلب وضوحًا في الرؤية وحسمًا في الاتجاه.
9 يوليو 2025
معضلة التخصيب الإيراني: بين السيادة النووية وهواجس الانتشار العالمي
تُشكّل أزمة تخصيب اليورانيوم في إيران المحور الجوهري للصراع النووي القائم، حيث تتقاطع الاعتبارات التقنية مع محددات السيادة الوطنية، ويتداخل القانون الدولي مع منطق الردع الاستراتيجي. فمن منظور الجمهورية الإسلامية، يُعدّ امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، بما في ذلك التخصيب على أراضيها، حقًا أصيلًا ومكفولًا بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT). غير أن هذا "الحق" يتجاوز في الوعي السياسي الإيراني كونه خيارًا تكنولوجيًا، ليتحوّل إلى رمز سيادي وركيزة في سردية الاستقلال الوطني والتحدي لهيمنة القوى الغربية.
في المقابل، تنظر الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى التقنية ذاتها بوصفها البوابة المباشرة نحو إنتاج سلاح نووي. فالمعمار الفني القائم على أجهزة الطرد المركزي يتيح – مع توافر القرار السياسي – الانتقال من التخصيب المنخفض إلى إنتاج مادة انشطارية قابلة للتفجير خلال أسابيع معدودة. وقد تعاظمت هذه المخاوف بصورة غير مسبوقة عقب تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2025 أن إيران راكمت ما يزيد عن 400 كيلوغرام من اليورانيوم المُخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي نظريًا لإنتاج ثلاث إلى خمس قنابل نووية بمجرد رفع النقاء إلى 90%، دون حاجة لإضافة بنية تحتية جديدة.
الخبرة التاريخية الإيرانية – من حرمانها من حصتها في مشروع Eurodif عام 1979 إلى انهيار مبادرة مفاعل طهران البحثي عام 2009 – عززت قناعة راسخة لدى النخبة الحاكمة بأن الاعتماد على الخارج في تأمين الوقود النووي ليس خيارًا موثوقًا. ومن ثمّ، فإن أي صيغة تفاوضية تتطلب التخلي عن التخصيب المحلي تُعدّ، من المنظور الإيراني، مساسًا جوهريًا بالكرامة السيادية والأمن الاستراتيجي للدولة.
وعليه، فإن جوهر الأزمة لا يكمن في مستويات التخصيب أو أعداد أجهزة الطرد، بل في البنية السياسية العميقة لانعدام الثقة المتبادل. ولن يكون ممكنًا بلوغ تسوية مستدامة إلا ضمن إطار أمني أشمل يُعيد تعريف العلاقة بين إيران والنظام الإقليمي والدولي على أسس جديدة.
لذلك ينطلق هذا التحليل من مقاربة متعددة المستويات تُعالج أزمة التخصيب الإيراني بوصفها مسألة تتجاوز الطابع التقني، لتلامس جوهر الصراع بين السيادة الوطنية وهواجس الانتشار النووي. ويتناول التحليل أربعة محاور رئيسية: الخصائص التقنية للتخصيب، الدوافع السياسية والاستراتيجية الإيرانية، الحسابات الأمنية الغربية، وأطر الحلول المقترحة، مع التأكيد على أن أي تسوية دائمة تقتضي إعادة تعريف العلاقة بين إيران والنظام الدولي.
8 يوليو 2025
اليورانيوم الإيراني المفقود: محفز محتمل لتجدد الصراع في الشرق الأوسط
شهدت العمليات العسكرية الأخيرة ضد المنشآت النووية الإيرانية تصاعدًا ملموسًا في المخاوف الدولية حيال طموحات طهران النووية. في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تجسد الصراع العسكري المباشر بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يومًا، حيث نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت منشآت نووية رئيسية في نطنز وفوردو وأصفهان، أعقبها رد إيراني على قاعدة العديد في قطر. ورغم إعلان الولايات المتحدة عن "تدمير كامل" للبنية التحتية النووية الإيرانية، تشير الأدلة إلى أن الضربات لم تحقق أهدافها الاستراتيجية بشكل كامل، إذ بقيت منشأة فوردو وأجهزة الطرد المركزي الأساسية سليمة جزئيًا، مما أبقى جزءًا كبيرًا من القدرات النووية الإيرانية قائمة.
تزداد حالة الغموض حول مصير اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني، خصوصًا بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان أثر نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تكفي نظريًا لصناعة عدة رؤوس نووية. وأقرّت السلطات الإيرانية بنقل هذه المواد إلى "أماكن آمنة" قبل الضربات الأمريكية، في حين تشير تقديرات استخباراتية غربية إلى صعوبة تحديد مواقعها واستهدافها عسكريًا، مما يعزز المخاطر المرتبطة بالانتشار النووي ويمنح إيران ورقة ضغط استراتيجية في أي مفاوضات مستقبلية، مع إبقاء احتمالات التصعيد العسكري قائمة.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة مؤقتة فقط، ولا تزال طهران تحتفظ بمعظم قدراتها التقنية والبشرية لإعادة بناء منشآتها واستئناف التخصيب في المستقبل القريب. لذلك، يصبح مصير اليورانيوم المخصب المحتجز في مواقع غير معلومة عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الصراع الإقليمي، إذ قد يشكل الشرارة لأي تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل، لا سيما إذا قررت طهران استئناف أنشطتها النووية أو سعت الأطراف الأخرى لاستهداف هذه المخزونات مجددًا.
يهدف هذا التحليل إلى دراسة التناقض بين الخطاب السياسي الذي يعلن "تدمير" القدرات النووية الإيرانية والواقع الميداني الذي يشير إلى استمرار التهديد النووي، مع التركيز على المخاطر الاستراتيجية الناجمة عن استمرار وجود اليورانيوم المخصب خارج الرقابة الدولية، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الإقليمي ومستقبل الصراع في الشرق الأوسط.