يشهد سوق العمل تحولاً عميقاً مع ابتعاد ملايين الأفراد حول العالم عن الوظائف التقليدية ذات الرواتب الثابتة، واتجاههم نحو أعمال مرنة ومستقلة تُيسّرها المنصات الرقمية. وقد أسهم هذا التحول في تسريع نمو اقتصاد العمل الحر "gig economy"، الذي يعيد تشكيل أنماط التوظيف، ويحفّز ريادة الأعمال، ويدفع بعجلة الابتكار. وفي المقابل، يثير هذا الواقع تحديات جديدة تتعلق بتقلب الدخل، وحماية حقوق العاملين، والإشراف التنظيمي.
إن مصطلح "gig"، الذي كان يُستخدم سابقاً من قبل الموسيقيين للدلالة على العروض المؤقتة، بات اليوم يشمل طيفاً واسعاً من الأعمال الحرة أو التعاقدية أو المؤقتة التي تمنح الأولوية للمرونة على حساب الاستقرار الدائم. ويستمد اقتصاد العمل الحر زخمه من المنصات الرقمية التي تربط العمال بالعملاء، بدءاً من خدمات النقل التشاركي وتطبيقات التوصيل، مروراً بأسواق العمل الحر، وصولاً إلى منصات التعليم عبر الإنترنت. ورغم أن هذا النموذج يوفّر مزايا اقتصادية تشمل إنتاجية أعلى، وقدرة أكبر على التكيف، وفرصاً ريادية واسعة، فإنه في الوقت ذاته يعرّض العاملين لمخاطر تتعلق بالحقوق، وأمن الوظيفة، والمعاملة العادلة. ومن ثم يبقى التوصل إلى توازن بين الابتكار وضمان الحماية المنصفة أمراً جوهرياً.
في الشرق الأوسط، يشهد اقتصاد العمل الحر توسعاً متسارعاً مدفوعاً بقاعدة شبابية متمرسة رقمياً، وضغوط البطالة، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومات. وبحلول عام 2024، ساهمت المنطقة بأكثر من 7% من حجم سوق العمل الحر العالمي، حيث أصبح العمل الحر وخدمات التوصيل والمنصات الرقمية ركائز أساسية في الاقتصادات المحلية.
وقد بدأ صانعو السياسات بالاستجابة عبر إطلاق تأشيرات عمل حر، وبرامج لبناء المهارات، وتشريعات موجّهة؛ إذ تعمل دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مواءمة اقتصاد العمل الحر مع رؤاها الطموحة للتحول، في حين تعكس مصر في الوقت نفسه قوة نمو هذا القطاع واستمرار تحديات الطابع غير الرسمي وضعف التنظيم.
ورغم ازدهار اقتصاد العمل الحر في الشرق الأوسط، فإن تحقيق إمكاناته الكاملة يظل رهناً بجيل جديد من الإصلاحات الحكومية التي تتجاوز مجرد دعم النمو، لتتجه نحو بناء قوة عاملة حرة مستقرة ومحمية.
الوجه المزدوج لاقتصاد العمل الحر
يوفّر اقتصاد العمل الحر فوائد ملموسة للعاملين، إذ يعيد تشكيل المفهوم التقليدي للتوظيف ويطرح نموذجاً يرتكز على الاستقلالية والمرونة وإمكانات الدخل. وبالنسبة لكثير من الأفراد، يمنحهم هذا النموذج حرية اختيار متى يعملون وكيف ولصالح من، مما يتيح لهم قدرة أكبر على التحكم في جداولهم الزمنية وأنماط حياتهم.
ويُعد هذا النموذج مفيداً على نحو خاص للطلاب، ومقدّمي الرعاية، أو لأي شخص يسعى إلى زيادة دخله من خلال أعمال إضافية. فالعاملون في هذا القطاع يمكنهم تحديد أجورهم بأنفسهم والتعامل مع عدة عملاء في آن واحد، مما يمكّنهم من استكشاف قطاعات متنوعة مع تعظيم عوائدهم المالية.
علاوة على ذلك، يكتسب العاملون خبرة عملية مباشرة، ويُنشئون ملفات مهنية، ويطوّرون مهارات ريادية يمكن أن تمهّد لاحقاً لإطلاق مشاريعهم الخاصة. وهذه الفرص لا تعزّز فقط مستوى الرضا الوظيفي والاستقلالية، بل تسهم أيضاً في الحد من البطالة والبطالة المقنّعة. وبوجه عام، يدعم اقتصاد العمل الحر قوة عاملة أكثر ديناميكية وذاتية الدفع، ما يمكن أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي، ويغذّي الابتكار، ويدعم النمو الاقتصادي الأوسع على المدى الطويل.
تجني الشركات فوائد هائلة من اقتصاد العمل الحر من خلال الوصول إلى قاعدة واسعة من المستقلين المهرة عند الطلب، من دون الأعباء المالية المترتبة على التوظيف بدوام كامل. ويتيح هذا النموذج للمؤسسات خفض التكاليف المرتبطة بالمزايا الوظيفية، وعمليات التوظيف والإعداد، والالتزامات طويلة الأجل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستويات الإنتاجية والكفاءة. كما تستطيع المؤسسات توسيع أو تقليص قواها العاملة بما يتماشى مع الاحتياجات الموسمية أو متطلبات المشاريع، الأمر الذي يعزّز مرونتها التشغيلية.
وعلاوة على ذلك، تستطيع الشركات الاستفادة من الكفاءات العالمية، بما يوفّر خبرات متنوعة تُحفّز الابتكار وتعزّز القدرة التنافسية. كما يساهم توظيف العاملين في اقتصاد العمل الحر في تقليص التعقيدات الإدارية عبر تبسيط عمليات التوظيف وتجاوز الوسطاء التقليديين. وبالنسبة للشركات الناشئة والصغيرة على وجه الخصوص، يعني ذلك سرعة في التنفيذ وقدرة أكبر على التكيف مع تحولات السوق.
ومع قيام المؤسسات بتحسين تكاليفها والحفاظ على مرونتها، فإنها تسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الإنتاجية العامة. وباختصار، لا يقتصر دور اقتصاد العمل الحر على تقوية المؤسسات الفردية فحسب، بل يمتد أيضاً ليعزز المشهد الاقتصادي الأوسع من خلال ترسيخ الكفاءة والقدرة التنافسية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المزايا، فإن اقتصاد العمل الحر لا يخلو من سلبيات جوهرية تؤثر على كلٍّ من العاملين والشركات التي تستعين بخدماتهم. ويأتي في المقدمة عدم استقرار الدخل بالنسبة للعاملين، إذ يكون الدخل غالباً غير متوقع بسبب غياب قاعدة عملاء ثابتة، ما يؤدي إلى تقلبات مالية تُفضي بدورها إلى حالة من انعدام الأمن الاقتصادي.
علاوة على ذلك، يفتقر العاملون في “اقتصاد العمل الحر” غالباً إلى المزايا والحماية الوظيفية، إذ لا يتمتعون عادةً بالتأمين الصحي، أو الإجازات المدفوعة، أو خطط التقاعد. ويُعد غياب هذه الضمانات مصدر ضعف كبير، لاسيما في أوقات الركود الاقتصادي أو عند مواجهة الطوارئ الشخصية. وأخيراً، فإن عدم الاستقرار في بيئة العمل قد يقود إلى شعور بالعزلة. فالعاملون في هذا القطاع كثيراً ما يُحرمون من التفاعلات الاجتماعية وفرص التطوير المهني التي ترافق عادةً التوظيف الدائم، وهو ما قد يعيق مسارهم المهني على المدى الطويل ويؤثر سلباً على مستوى الرضا الوظيفي.
إلى جانب ذلك، يفرض اقتصاد العمل الحر تحديات فريدة على الشركات تتجاوز مسألة مرونة القوى العاملة؛ فالمؤسسات قد تواجه صعوبة في تنسيق عمل المستقلين عبر مناطق زمنية وخلفيات ثقافية مختلفة، وهو ما قد يعيق التعاون في المهام المعقدة.
ولمواجهة ذلك، يتعين على الشركات الاستثمار في أدوات تواصل متطورة وأنظمة إدارة مشاريع شاملة. كما تضيف الأطر القانونية المتغيرة طبقة أخرى من التعقيد، ولا سيما فيما يتعلق بتصنيف العاملين، الأمر الذي قد يعرّض الشركات لغرامات باهظة. ويستلزم الالتزام القانوني الحصول على استشارات متخصصة وصياغة عقود واضحة. وإلى جانب ذلك، قد تؤدي الطبيعة قصيرة الأجل للعمل الحر إلى ضعف مستوى ولاء العاملين، مما يجعل الاحتفاظ بالكفاءات المتميزة أكثر صعوبة.
إن تقديم حوافز قائمة على الأداء، وإتاحة فرص لتطوير المهارات، أو توفير مسارات تؤدي إلى وظائف دائمة يمكن أن يسهم في تعزيز التفاعل والالتزام. كما تبرز مسألة أمن البيانات باعتبارها مصدر قلق متزايد، نظراً لأن العاملين في هذا القطاع غالباً ما يتعاملون مع معلومات حساسة، وهو ما يجعل من الضروري اعتماد بروتوكولات قوية للأمن السيبراني وتوقيع اتفاقيات عدم الإفصاح. وأخيراً، فإن دمج العاملين في اقتصاد العمل الحر بسلاسة في العمليات الأساسية للمؤسسات سيظل مرهوناً بعمليات إعداد مدروسة، وإتاحة الأدوات اللازمة لهم، وبناء ثقافة تعاونية داخل بيئة العمل.
الوضع الراهن: اقتصاد العمل الحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يشهد اقتصاد العمل الحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً عميقاً، تغذّيه سياسات التنويع الاقتصادي المستمرة، والتبني السريع للتقنيات الرقمية، والتحولات المتسارعة في ديناميكيات سوق العمل. ومع تزايد نسبة الشباب، واستمرار تحديات البطالة، وانتشار استخدام الهواتف المحمولة وتقنيات الإنترنت، أصبح العمل الحر بديلاً جذاباً للوظائف التقليدية. وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع هذا التحول، إذ عجّلت بالتحول الرقمي ورسّخت ثقافة العمل عن بُعد في مختلف أنحاء المنطقة. ومع تبنّي الشركات لنماذج عمل أكثر مرونة، بات العاملون في اقتصاد العمل الحر في موقع يؤهلهم للاستفادة من فرص متزايدة الاتساع.
تشهد المنصات الرقمية التي تربط المستقلين (الفريلانسرز) بأصحاب العمل ـ بدءاً من الشركات العالمية الكبرى مثل Upwork وFreelancer.com وصولاً إلى اللاعبين الإقليميين مثل Nabbesh وUreed ـ نمواً لافتاً. ففي عام 2023 وحده، ارتفع عدد المسجلين من المستقلين بنسبة 142%، مع ارتفاع الطلب في مجالات مثل تطوير البرمجيات، والتسويق الرقمي، وإنتاج المحتوى، والتكنولوجيا المالية. ويعكس هذا الاتجاه إعادة توجيه جوهرية في طبيعة القوى العاملة، حيث يجري توظيف الأدوات الرقمية لتيسير أنماط عمل أكثر مرونة قائمة على المشاريع.
وفقاً لمنظمة العمل الدولية، يُتوقَّع أن ينمو اقتصاد العمل الحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي يبلغ 14%، ليصل إلى قيمة سوقية قدرها 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. ولا يقتصر هذا التوسع على دعم أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع فحسب، بل يوفّر أيضاً مساراً حيوياً لخلق فرص عمل، ولا سيما لفئة الشباب المتمرسين رقمياً في المنطقة. ومع نضوج البنية التحتية الداعمة للعمل الرقمي، يُرتقب أن يصبح اقتصاد العمل الحر ركناً أساسياً في سوق العمل المستقبلي بالمنطقة.
بلغ حجم سوق العمل الحر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 11 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يعكس مستوى كبيراً من تبني هذا النهج. وتبرز جنوب أفريقيا بمعدل النمو الأعلى متجاوزة 18%، وهو ما يسلّط الضوء على آفاق توسع قوية. وفي المقابل، تُظهر نيجيريا وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحجام سوق أصغر ومعدلات نمو معتدلة. وبوجه عام، يتسم مشهد اقتصاد العمل الحر في المنطقة بتنوع الفرص وتفاوت مستويات النضج.
في منطقة الشرق الأوسط، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً في حجم اقتصاد العمل الحر. وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، يشهد هذا القطاع تحولاً لافتاً تقوده رؤية 2030 وتسارع وتيرة التحول الرقمي. فقد ازداد الطلب على أنماط العمل المرنة، ولا سيما في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والتسويق الرقمي، وخدمات التوصيل، وهو ما فتح مسارات جديدة أمام كلٍّ من الأفراد المستقلين (الفريلانسر) والشركات. وبحلول أواخر عام 2024، كان أكثر من 2.25 مليون سعودي مسجلين على المنصة الرسمية للعمل الحر، مسهمين بما يقارب 72.5 مليار ريال سعودي (نحو 19 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023. وتتميز هذه القوة العاملة بسمات شبابية وتعليمية، إذ يحمل 62% منهم درجات البكالوريوس، بينما تتراوح أعمار معظم المستقلين بين 25 و34 عاماً.
وبالمثل، يبرز اقتصاد العمل الحر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما في دبي، بوصفه ركناً محورياً في بناء قوة عاملة وطنية مستعدة للمستقبل. ففي الوقت الراهن، يشكل المستقلون والاستشاريون والمهنيون بدوام جزئي أكثر من 10% من إجمالي القوى العاملة في الدولة. وقد شهد القطاع الإبداعي على وجه الخصوص نمواً لافتاً بنسبة 70% في أعداد العاملين المستقلين خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُتوقّع أن ينمو اقتصاد العمل الحر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17%، وهو ما يعكس تزايد أهميته في الاقتصاد الوطني. وقد جعلت البنية التحتية الرقمية المتطورة في دبي وانفتاحها على الابتكار منها مركزاً رئيسياً لهذا النمط من العمل، ولا سيما في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والتصميم، والخدمات المهنية. غير أنّ العاملين في هذا القطاع يُتوقع منهم أيضاً مواصلة تطوير مهاراتهم، خصوصاً مع إعادة تشكيل أنماط العمل بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ومع صعود المنصات الرقمية وتغير اتجاهات التوظيف بعد جائحة كوفيد-19، بات اقتصاد العمل الحر يشكل حجر زاوية في نموذج اقتصادي أكثر ديناميكية ومرونة وشمولية في دولة الإمارات.
في مصر، يشهد اقتصاد العمل الحر توسعاً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتحولات ديناميكيات سوق العمل، والضرورات الاقتصادية. ويستفيد المستقلون من فرص متزايدة لزيادة الدخل، ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتنامي الطلب على أنماط العمل المرنة. وتُعد مجالات العمل الحر الرقمي، والدروس الخصوصية عبر الإنترنت، وخدمات النقل التشاركي، وخدمات التوصيل من بين أكثر القطاعات نشاطاً، مع إقبال ملحوظ من النساء والشباب على هذه الأدوار المرنة، خصوصاً أولئك الذين يوازنون بين مسؤوليات الرعاية والعمل.
ويبلغ عدد المصريين المنخرطين حالياً في العمل الحر أو الأعمال الرقمية عبر الإنترنت أكثر من مليوني شخص، مما يجعل مصر واحدة من أسرع خمس أسواق نمواً للعمل الحر على مستوى العالم، حيث ارتفعت أرباح المستقلين بنسبة +22% على أساس سنوي (مؤشر Payoneer لاقتصاد العمل الحر العالمي، 2023). وفي الوقت ذاته، يواجه هذا القطاع تحديات هيكلية مثل الطابع غير الرسمي، وضعف حماية العاملين، والفجوات التنظيمية، وهي مسائل يتعين معالجتها لضمان استدامته وشموليته على المدى الطويل.
وعلى الرغم من وعوده، يثير اقتصاد العمل الحر جملة من المخاوف، إذ يفتقر العاملون فيه إلى الأمان الوظيفي، والدخل المستقر، وإلى شبكات الحماية الاجتماعية مثل التأمين وخطط التقاعد. كما أن تقلب الدخل وضعف القدرة على الوصول إلى المنصات الدولية للعمل الحر يضيفان ضغوطاً إضافية. وتظل السياسة الضريبية قضية غير محسومة، تتطلب إصلاحات تشجع المشاركة من دون أن تفرض أعباء غير عادلة على المستقلين.
ويرى خبراء أن اقتصاد العمل الحر يمكن أن يسهم في تخفيف البطالة وتوليد عملة صعبة. غير أن استغلال إمكاناته الكاملة يستدعي إقرار تشريعات شاملة وحمايات اجتماعية مصممة خصيصاً له. ومع ذلك، يواجه القطاع في مصر تحديات كبرى على وجه التحديد، تشمل ضعف البنية التحتية، وغياب الحمايات القانونية، وارتفاع معدلات الطابع غير الرسمي، حيث بلغت نسبة العمالة غير الرسمية 64% والعمل غير المنتظم 21% في عام 2019، وفقاً لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي عرضته رشا حسن في عام 2023. ولمعالجة هذه التحديات الواسعة النطاق وإطلاق كامل إمكانات القطاع، شرعت الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة في تنفيذ إصلاحات سياساتية موجهة.
من الرؤية إلى التنظيم
يرتبط صعود اقتصاد العمل الحر في الشرق الأوسط ارتباطاً وثيقاً بالتدخلات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين المرونة والاستقرار. فبدلاً من الاكتفاء بتحفيز نمو السوق، تسعى هذه السياسات إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العمل الحر ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية الأوسع. وكان من أبرز مجالات الإصلاح تكييف قوانين العمل لتستوعب هذا النموذج الجديد.
فعلى سبيل المثال، دمجت المملكة العربية السعودية منصات العمل الحر مثل “مرسول” و”حراج” ضمن أجندة رؤية 2030، من خلال إدخال أنظمة ترخيص وأطر تنظيمية تُضفي الشرعية على العمل الحر، وفي الوقت نفسه تعزز ريادة الأعمال ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إلى جانب ذلك، تعمل مبادرة إصلاحات سوق العمل في السعودية على دمج العاملين في الاقتصاد الحر من خلال عقود منظَّمة، وآليات تحقق عبر منصة “قوى”، وأهداف تتماشى مع سياسات السعودة، بما يعزز من مستويات الحماية، ويلزم أصحاب العمل، ويرسخ مبادئ العدالة والتنافسية، وهو ما يقوي حقوق العاملين ويدعم تنمية رأس المال البشري. وتمضي هذه الإصلاحات باتجاه إرساء عقود واضحة للمستقلين.
ومع أن هذه التدابير توسع نطاق الفرص المتاحة، إلا أن فجوة أساسية لا تزال قائمة فيما يتعلق بضمان شبكات حماية اجتماعية شاملة، مثل التأمين ضد البطالة أو مزايا التقاعد، الأمر الذي يترك المستقلين عرضة لانعدام الأمن المالي وتقلبات الدخل، فضلاً عن هشاشة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتماشى توسع اقتصاد العمل الحر مع رؤية مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى جعل الدولة الأفضل عالمياً بحلول عامها المئوي. وقد أطلقت الحكومة تدابير موجهة مثل تأشيرات العمل الحر والمناطق الحرة المتخصصة لدعم المهنيين المستقلين، وجذب المواهب العالمية، وتعزيز الابتكار.
ومن خلال الجمع بين تبسيط إجراءات الترخيص وبيئة الدخل المعفاة من الضرائب، تعزز هذه التدابير مكانة الإمارات كمركز للمستقلين، غير أن هذا النموذج القائم على دعم النمو قد أعطى حتى الآن أولوية أكبر لجذب الكفاءات الأجنبية عالية المهارة على حساب إرساء شبكات حماية اجتماعية متينة للقوة العاملة الحرة الأوسع نطاقاً.
يستفيد المستقلون في دولة الإمارات من بيئة الدخل المعفاة من الضرائب، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، والمرونة في إدارة جداولهم الزمنية وشبكات عملائهم. وقد أسهمت البنية التحتية الرقمية المتقدمة في الدولة في تسريع نمو اقتصاد العمل الحر بشكل ملحوظ، من خلال تمكينهم من الوصول السلس إلى المنصات الإلكترونية والعملاء الدوليين والفرص عن بُعد. كما أن معدلات انتشار الإنترنت المرتفعة، والخدمات الحكومية الذكية، ونظم الدفع الرقمية واسعة الاستخدام، قد أوجدت منظومة متكاملة تدعم كفاءة المستقلين ومرونتهم وقدرتهم التنافسية على المستوى العالمي.
يمتد هذا النمو إلى ما هو أبعد من الأفراد العاملين، إذ تسهم الصناعات الداعمة مثل مساحات العمل المشتركة والمنصات الرقمية في تعزيز منظومة عمل أكثر ديناميكية وترابطاً. ونتيجة لذلك، فإن اقتصاد العمل الحر لا يقوي فقط فرص ريادة الأعمال، بل يعزز أيضاً النشاط الاقتصادي الحضري وقدرة المجتمعات على الصمود.
أما في مصر، فتبرز معضلة مختلفة. فعلى الرغم من إطلاق الحكومة مبادرات مثل “مبادرة العمل الحر والعمل عن بُعد“ ومراكز الابتكار “كرييتيفا” لتدريب العاملين وربطهم بالفرص، إلا أن فعالية هذه السياسات الموجهة من الأعلى إلى الأسفل ما تزال معقدة بشكل كبير بسبب الهيمنة المستمرة للطابع غير الرسمي على سوق العمل.
مع وجود أكثر من 60% من القوة العاملة في نطاق العمالة غير الرسمية، يبقى المستقلون في الغالب خارج نطاق الحمايات التنظيمية، وأنظمة الضرائب، وبرامج الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة على حماية العاملين من جهة، والاستفادة الكاملة من الإمكانات المالية لاقتصاد العمل الحر من جهة أخرى.
ولمواجهة هذه التحديات، يتعيّن على مصر أن تعطي الأولوية لعملية إضفاء الطابع الرسمي، وهو ما يستدعي الانتقال من البرامج التدريبية الفوقية إلى إصلاحات تنظيمية شاملة تدمج العاملين المستقلين في القطاع الرسمي. كما ينبغي للحكومة أن تعتمد إجراءات تسجيل وضريبية مبسطة مصممة خصيصاً للمستقلين، بما يجعل الامتثال سهلاً وجذاباً.
عبر الدول الثلاث جميعها، تكشف الجهود السياساتية عن توتر مشترك يتمثل في السعي إلى تشجيع المرونة الريادية مع توفير الحماية الكافية في الوقت نفسه. ولتعزيز مساهمة اقتصاد العمل الحر على المدى الطويل، يمكن للحكومات أن تتجه نحو تبني مقاربات متكاملة تجمع بين سهولة الدخول إلى سوق العمل وتوفير مزايا قابلة للنقل، إلى جانب نظم ضريبية موجهة، والاستثمار في المنصات الرقمية التي تكفل الشفافية.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن الأمر يقتضي تعميق آليات الحماية إلى جانب السياسات الحالية الداعمة للنمو. فبينما ينجح النموذج الإماراتي في جذب الكفاءات الدولية عالية التأهيل، فإنه يترك العديد من العاملين في اقتصاد العمل الحر من دون مزايا أساسية مثل التأمين الصحي أو خطط التقاعد. وبناءً على ذلك، ينبغي على الحكومة أن تؤسس نظاماً للمزايا القابلة للنقل يمكن للمستقلين المساهمة فيه، إلى جانب توسيع الإطار التنظيمي بما يضمن حماية قانونية واضحة لا لبس فيها.
وبالمثل، يتعيّن على المملكة العربية السعودية أن تتجاوز تركيزها الحالي على الشرعية وتعزيز ريادة الأعمال لتتعامل مع الفجوة الأساسية في الحماية الاجتماعية، من خلال إنشاء نظام قانوني للمزايا القابلة للنقل مثل التأمين ضد البطالة وصناديق التقاعد، بما يوفّر مظلة تحمي المستقلين من انعدام الأمن المالي.
أما في مصر، فتتمثل الأولوية في إضفاء الطابع الرسمي، حيث يمكن أن يؤدي إدماج المستقلين ضمن الإطار التنظيمي إلى توسيع الإيرادات الضريبية وتحسين حماية العاملين في الوقت نفسه. إن إنشاء سجل رقمي للعاملين في اقتصاد العمل الحر من شأنه أن يزيد من مستوى الشفافية، ويتيح للدولة توسيع نطاق شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين ضمانات الأمان للعاملين، وفي الوقت نفسه توسيع القاعدة الضريبية، بما يسمح لهذا القطاع بتحقيق كامل إمكاناته المالية.
المراجع
AL-KINANI, MOHAMMED. “2.25m Freelancers in Saudi Arabia Join National Economy.” Arab News, Arabnews, 25 Dec. 2024, www.arabnews.com/node/2584265/business-economy Accessed 2 Sept. 2025.
“Arab Finance – Egypt’s Gig Economy: Thriving amid Uncertainty.” ArabFinance, 2024, www.arabfinance.com/News/newdetails/20314
Asfahani, Ahmed M., et al. “Navigating the Saudi Gig Economy: The Role of Human Resource Practices in Enhancing Job Satisfaction and Career Sustainability.” Sustainability, vol. 15, no. 23, 1 Jan. 2023, p. 16406, www.mdpi.com/2071-1050/15/23/16406, https://doi.org/10.3390/su152316406
Bahu, Anastasia. “The Gig Economy: Challenges and Advantages for Employers and Employees.” DevelopmentAid, 2024, www.developmentaid.org/news-stream/post/183798/gig-economy-challenges-and-advantages
Caledonia Resources. “The Rise of the Gig Economy: Senior Talent in the Middle East.” Caledonia Resources, 2024, www.caledonia-resources.com/blog/f/the-rise-of-the-gig-economy-senior-talent-in-the-middle-east. Accessed 2 Sept. 2025.
Cognitive Market Research. “Global Gig Economy Market Report 2024 Edition, Market Size, Share, CAGR, Forecast, Revenue.” Cognitive Market Research, 11 Nov. 2022, www.cognitivemarketresearch.com/gig-economy-market-report
Corporate Finance Institute. “Gig Economy.” Corporate Finance Institute, 7 Nov. 2022, www.corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/gig-economy/
“Gig Economy Platforms Market Size & Share Trends, 2033.” Globalgrowthinsights.com, 2025, www.globalgrowthinsights.com/market-reports/gig-economy-platforms-market-116778 Accessed 2 Sept. 2025.
Lutkevich, Ben. “What Is the Gig Economy? – Definition from WhatIs.com.” WhatIs.com, Feb. 2022, www.techtarget.com/whatis/definition/gig-economy
“Work Arrangements in the Informal Sector and Gig Economy/Digital Platform Economy in Egypt – Economic Research Forum (ERF).” Economic Research Forum (ERF), 2023, www.erf.org.eg/publications/work-arrangements-in-the-informal-sector-and-gig-economy-digital-platform-economy-in-egypt/



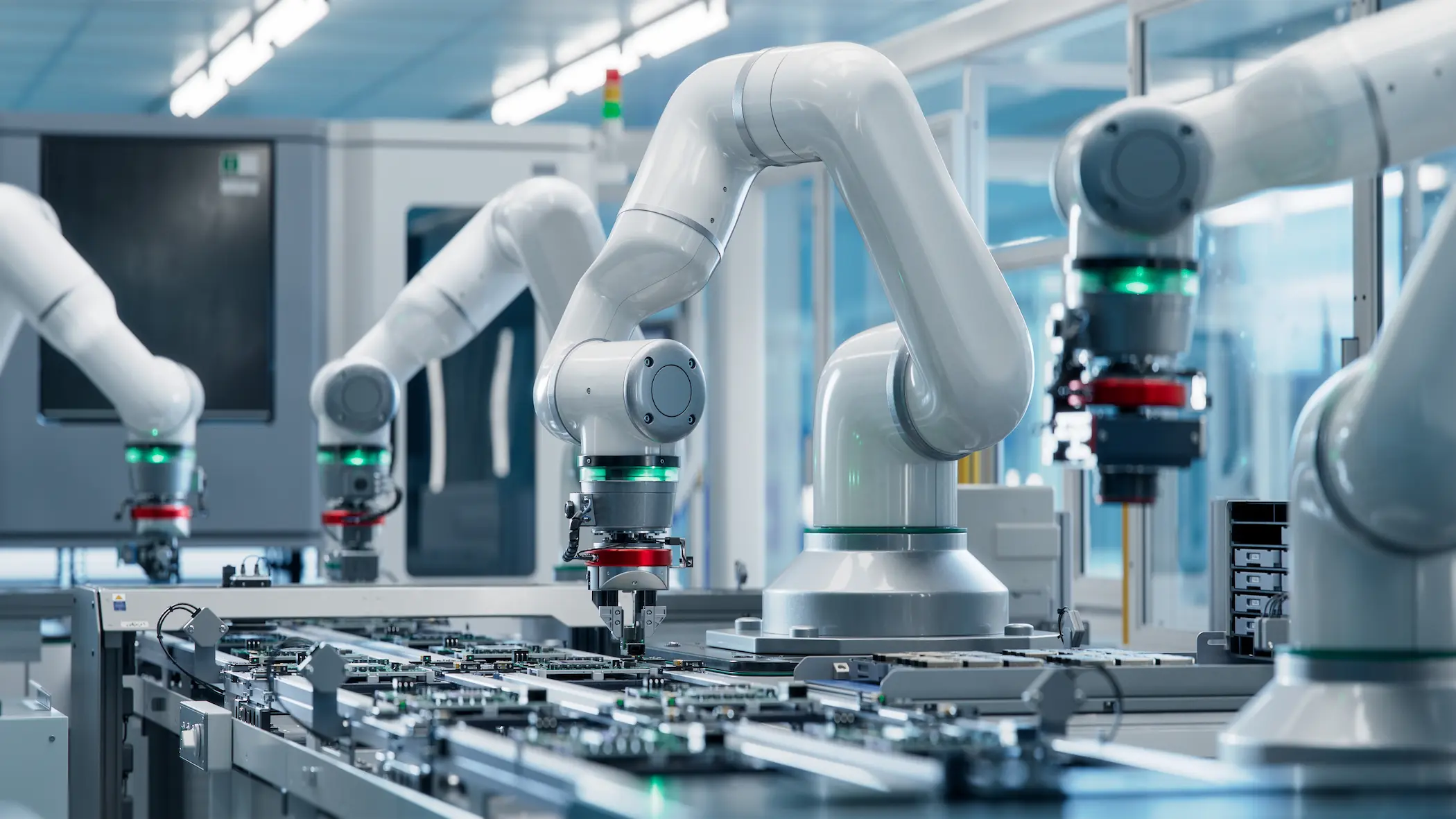



















تعليقات