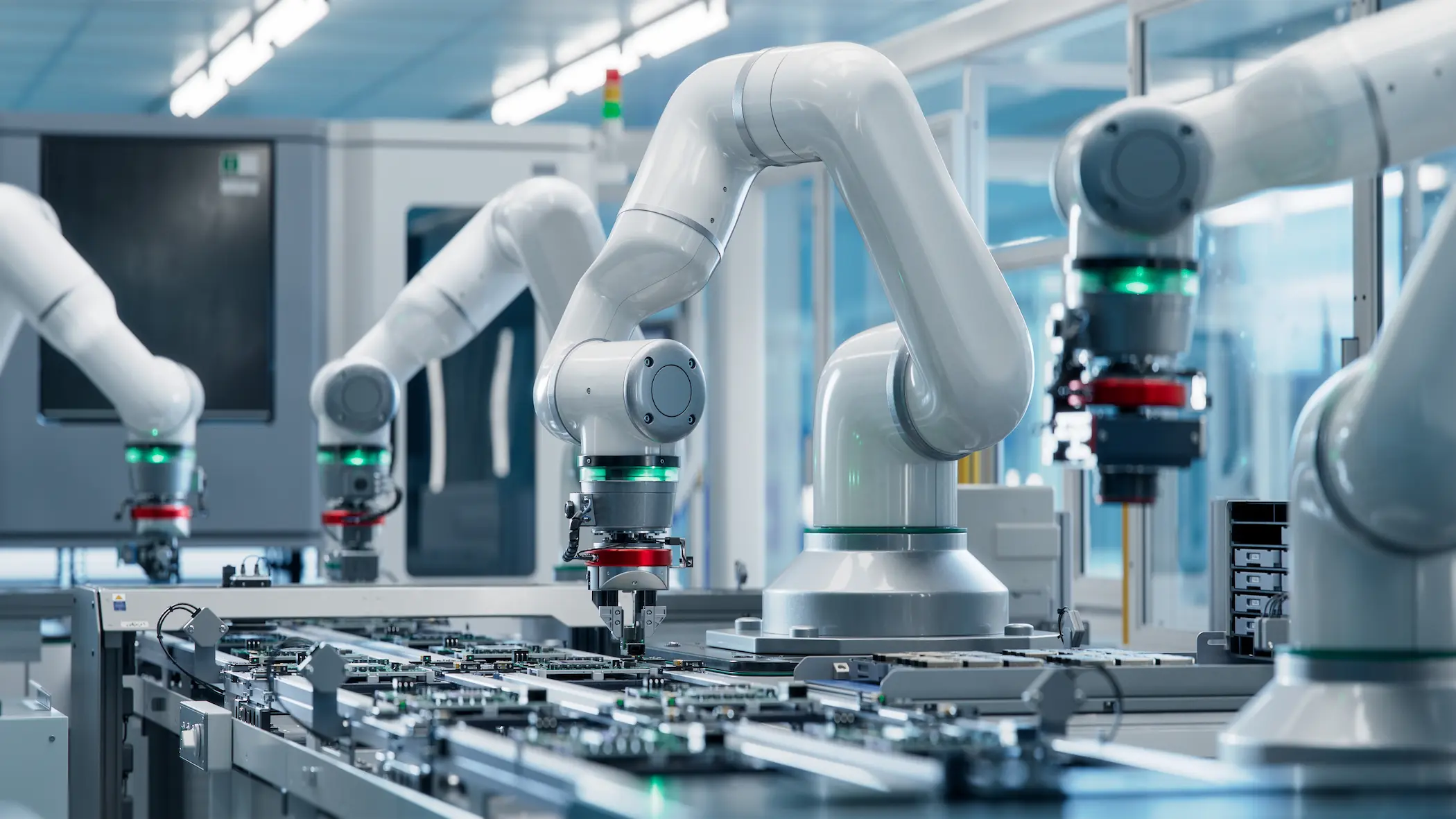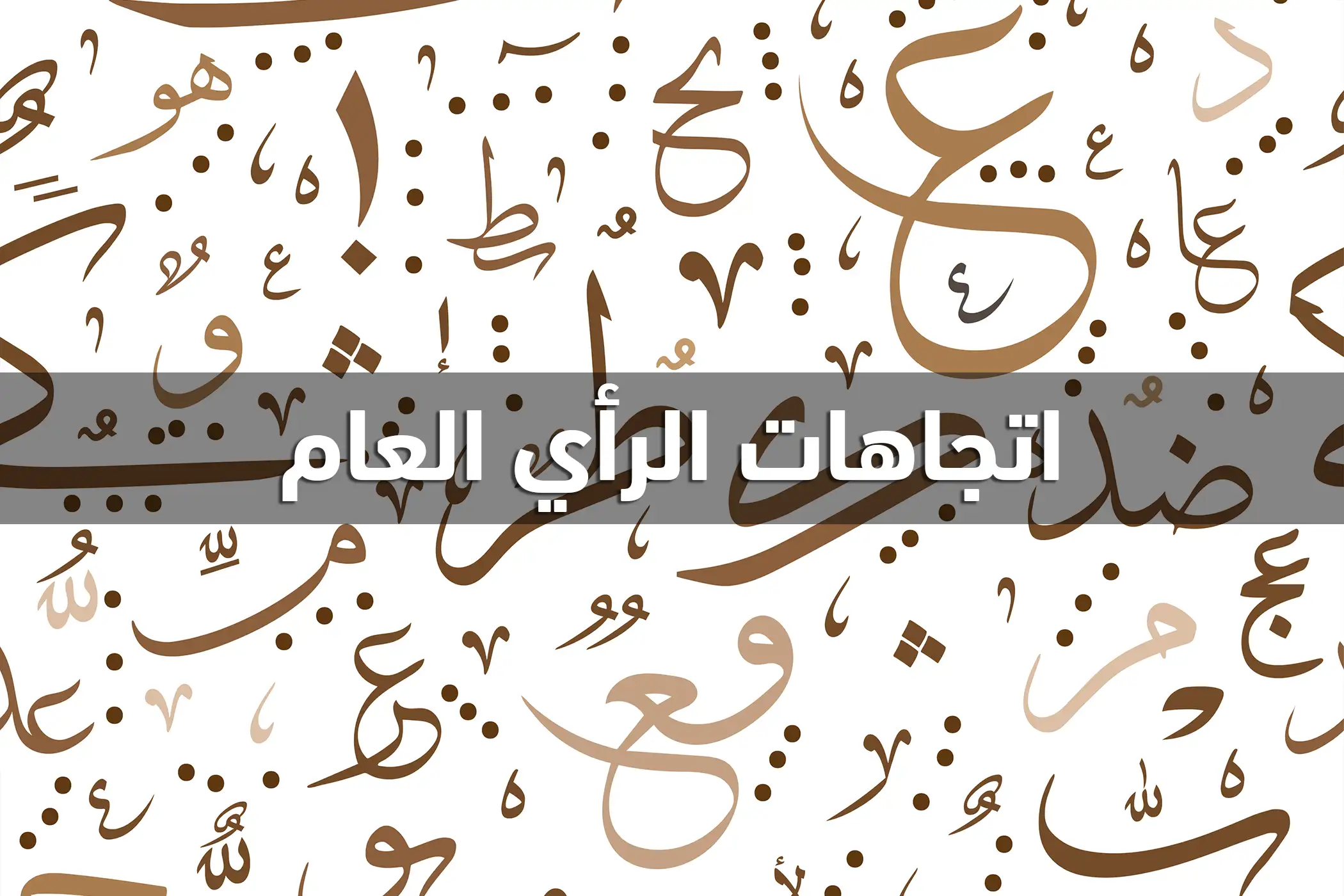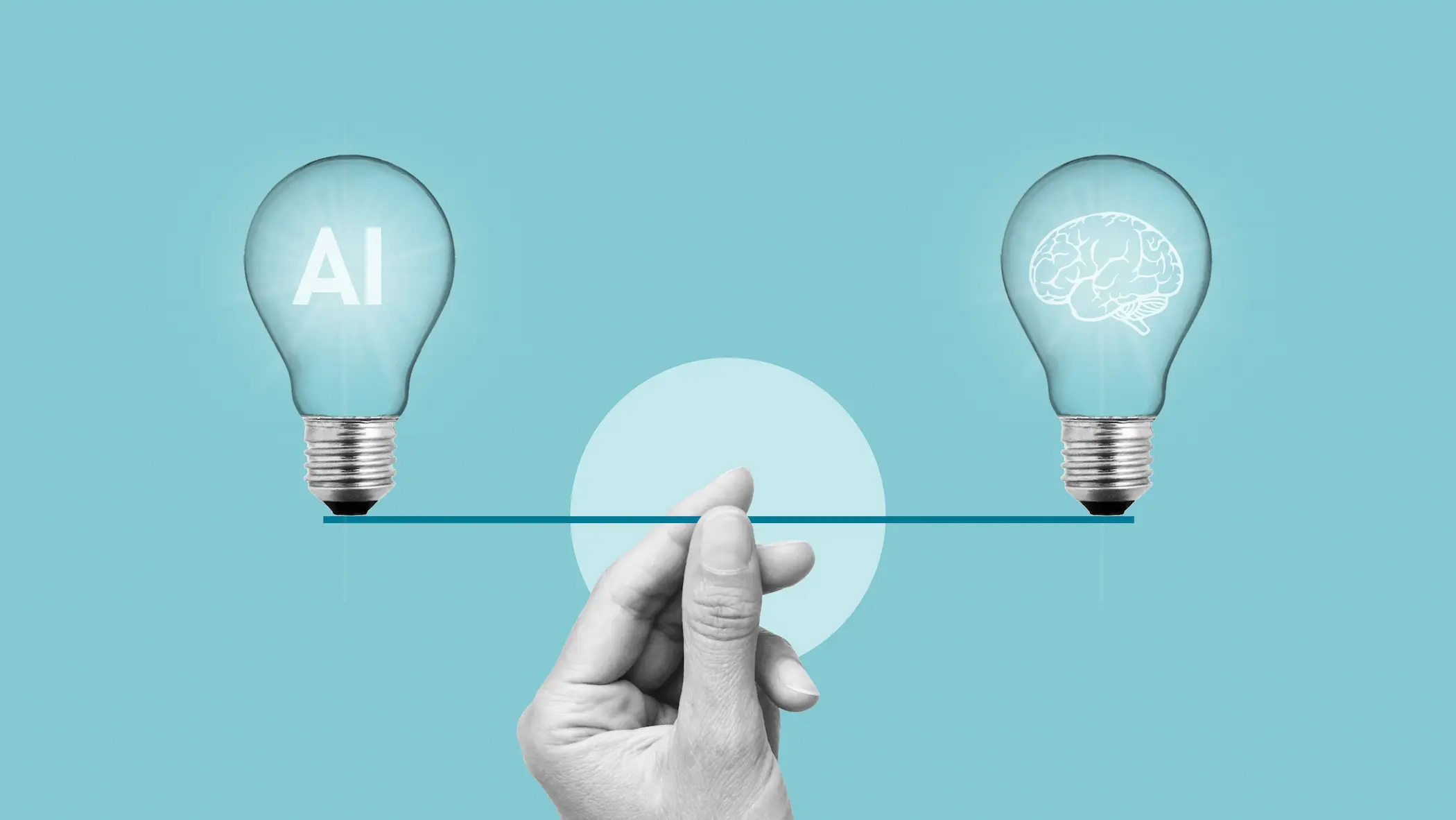30 أكتوبر 2025
أجنّة المستقبل: حياة بلا بويضات أو حيوانات منوية
في عالم لم يَعُد فيه التكاثر محتاجاً إلى رابطٍ أو نسبٍ أو حتى الدين، قطعت البشرية أوثق عُراها، ألا وهي العائلة. بحلول عام 2070، لم تعُد الحكومات تنتظر الأزواج كي يُنجبوا، بل تُصنّع الحياة في مصانعٍ من زجاجٍ وفولاذ يطنّ أزيزها، وتُنشئ أجيالاً كاملة في أرحام اصطناعية. يخرج الأطفال بلا أم ولا أب، ولا يجدون أمامهم سوى الدولة وآلاتها.
في قصة قصيرة بعنوان “أجنّة المستقبل: حياة بلا بويضات أو حيوانات منوية“، ضمن سلسلة "عوالم متخيَّلة" تصدر عن مركز الحبتور للأبحاث، نتخيّل غداً تُواجَه فيه أزمة تراجع السكان لا بالإصلاح، بل بالاستبدال. إنّها حكاية عن البقاء وعن الفقد في آنٍ معاً، تتساءل عمّا سيؤول إليه معنى الهوية والانتماء والحب حين تقرّر المجتمعات أن الجذور الإنسانية مجرّد خيار.
22 أكتوبر 2025
ثورة الروبوتات الصينية: هل تعيد تشكيل الخريطة الصناعية في الشرق الأوسط
لم تعد النهضة الصينية في مجال الروبوتات مجرّد مسعى لتحسين كفاءة الإنتاج، بل تحوّلت إلى ثورةٍ صناعيةٍ شاملة تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. فمع نشر مئات الآلاف من الروبوتات الذكية سنويًا، ترسّخ الصين مكانتها في صدارة المشهد الصناعي العالمي وتُعيد توزيع الأدوار في سلاسل التوريد العالمية وتُبدّل موازين القوة التكنولوجية بين الدول.
أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذا التحوّل يطرح أسئلةً مصيريةً لا تحتمل التأجيل. فالأتمتة لم تَعُد تفصيلاً هامشيًا في العملية الاقتصادية، بل باتت المحرّك الأساسي للاستراتيجيات التنموية، فيما تُواجه الدول التي تتباطأ في بناء قدراتها الذاتية خطر الارتهان لأنظمةٍ صناعيةٍ وتقنيةٍ تُصمَّم وتُدار من الخارج، بما يُقوّض استقلال قرارها الاقتصادي والتكنولوجي.
ومن ثمّ، فإنّ مستقبل الروبوتات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتعلّق بمن يُسارع إلى تركيب الآلات أو توسيع نطاق استخدامها فحسب، بل بمن يمتلك القدرة على وضع المعايير الناظمة، والتحكّم في تدفّقات البيانات، ورسم قواعد المنافسة الصناعية في العقود المقبلة. فإمّا أن تتحوّل المنطقة إلى مُنتِجةٍ ومبتكِرةً للتقنيات التي سترسم ملامح هذا القرن، وإمّا أن تظلّ مستهلكةً لها، تُساق في ركبٍ تكنولوجيٍّ يُقرَّر مساره خارج حدودها.
21 أكتوبر 2025
توترات متصاعدة: هل تتجه أوروبا الى حرب جديدة؟
تعود أوروبا إلى أجواء التوتّر التي ظنّت أنها طوتها منذ عقود. ففي تحذيرٍ صريح، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إنّ "بولندا اليوم في أقرب نقطةٍ من اندلاع صراعٍ مفتوح منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك عقب انتهاكٍ مفاجئٍ للمجال الجوي البولندي من قِبل روسيا أثار قلقًا واسعًا داخل البلاد وخارجها. ففي التاسع من سبتمبر، اخترقت أسرابٌ من الطائرات المسيّرة الروسية الأجواء البولندية، ما دفع طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الإقلاع لاعتراض عددٍ منها، في أول مواجهةٍ مباشرةٍ بين الحلف وموسكو منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. ورغم أنّ الحادثة قد تُفسَّر بوصفها اختبارًا من الرئيس فلاديمير بوتين لمدى جاهزية الناتو واستجابة أوروبا، فإنّها تُسلّط الضوء على هشاشة المشهد الأمني الإقليمي واحتمال انزلاق القارّة نحو مواجهةٍ جديدة. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤدّيه بولندا ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو دور يتجاوز في وزنه وتأثيره موقع أوكرانيا، فإنّ اندلاع صراعٍ مباشرٍ بينها وبين روسيا قد يضع الأمن الأوروبي بأسره أمام اختبارٍ وجودي غير مسبوق. والسؤال المطروح اليوم: إلى أيّ مدى تقترب أوروبا من هذه المواجهة؟ وهل تملك القدرة على احتواء تداعياتها؟
1 أكتوبر 2025
اتجاهات الرأي العام: اللغة العربية ومستقبل الأمن العربى
يستعرض استطلاع "اتجاهات الرأي العام"، الذي أُجري في أغسطس 2025، تصوّرات الجمهور حيال اللغة العربية ودورها في تشكيل الهوية الإقليمية، والأمن، والتماسك الاجتماعي. وتُبرز نتائجه أنّ تراجع العربية يُنظر إليه كتهديد محتمل، لا للوحدة الثقافية والاجتماعية فحسب، بل أيضاً للاستقرار الاقتصادي والأمن القومي. ومن خلال تناول المخاوف الآنية وتلك الممتدة على المدى البعيد، يقدّم الاستطلاع رؤى بالغة الأهمية حول كيفية إدراك اللغة بوصفها ركناً من أركان الصمود في العالم العربي.
30 سبتمبر 2025
المدن العائمة: حين تختبئ الهيمنة خلف رايات الابتكار
ظلت فكرة تشييد مدن عائمة فوق سطح البحر تراوح بين أجواء الخيال العلمي وطموحات وادي السيليكون، إلى أن تحولت في أواخر العقد الأول من الألفية إلى مشروع واقعي عُرف باسم (المدن العائمة- (Seasteading. وقد رُوِّج لهذا المشروع بوصفه تجربة راديكالية ذات نزعة تحررية، تعد بالخلاص من عبء الضرائب والأنظمة والسلطات، وتتيح لمموليها الأثرياء فرصة تأسيس مجتمعات جديدة خارج نطاق سيادة الدول. في منظور أنصاره، لم يكن الأمر محاولةً لترميم النظم المتهالكة، بل مسعى لإعادة التأسيس من نقطة الصفر في أعالي البحار، حيث تُكتب القواعد من جديد باسم الحرية والابتكار وإمكانات غير محدودة.
غير أنّ اقتراب هذه الفكرة من عتبة الواقع يجعل الأسئلة التي تثيرها أكثر إلحاحًا: فلمن ستُقام هذه المجتمعات الجديدة حقًّا؟ ومن هم الذين سيجدون أنفسهم مستبعدين بالضرورة؟ ففي عالم يتسم أصلًا باتساع فجوات اللامساواة وتسارع وتيرة الأزمة المناخية، قد لا تبدو المدن العائمة صورًا لمستقبل واعد بقدر ما تبدو نُذرًا محذِّرة من حاضر مأزوم.
26 سبتمبر 2025
من مسار الدبلوماسية إلى دروب التوسع: حرب نتنياهو غير المتوقعة
لم تعد طموحات نتنياهو محصورة في الدبلوماسية أو في السعي وراء اتفاقات التطبيع. اتفاقات أبراهام، التي عُدّت في وقتٍ من الأوقات الهدف الأسمى لاستراتيجيته الإقليمية المعاصرة، تبدو اليوم بلا قيمة، وقد أُزيحت جانبًا لصالح رؤية أشدّ عدوانية. فما نشهده اليوم ليس سياسة السلام، بل سياسة التوسع، حيث لا يمكن لأي دولة عربية أن تفترض أنها بمنأى عن الخطر. السؤال المتعلق بأي دولة ستكون الهدف المقبل بات عصيًا على التنبؤ، لأن أفعال نتنياهو لا تحكمها حسابات عقلانية بقدر ما تستند إلى الثقة التي يمدّه بها الدعم الأميركي غير المشروط. قلّة هم من كانوا يتخيلون أن الدوحة، بما تحويه من قاعدة عسكرية أميركية وبما تمثله من حليف وثيق لواشنطن، قد تتعرض لغارة جوية، إلا أن ذلك حدث ذلك بالفعل. تكشف حالة عدم القدرة على التنبؤ واقعًا بالغ الخطورة وهو أن نطاق الحرب مرشح للتوسع، وأن أي دولة في المنطقة قد تجد نفسها الهدف القادم لإسرائيل.
22 سبتمبر 2025
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS): ساحة الحرب الخفية في الشرق الأوسط
لم تعد الحروب تقتصر على الصواريخ والطائرات المسيّرة أو الجنود في ساحات القتال؛ فقد انتقل الصراع الحاسم تدريجيًا إلى فضاء الإشارات غير المرئية التي تُوجّه الطائرات بهدوء عبر السماء، والسفن عبر المضائق الضيقة، بل وتضبط إيقاع الأسواق المالية. وفي قلب هذا التنافس الجديد يقف النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، الذي عُدّ يومًا إنجازًا علميًا مبهرًا ومُنِح للعالم كمنفعة عامة مجانية، لكنه يتحول تدريجيًا إلى سلاح يسهل تعطيله بتكلفة زهيدة، ويصعب تتبّعه، وقادر على إحداث تداعيات تتجاوز ميدان القتال لتطال ساحات أشد اتساعًا.
لقد شكّل التشويش الأخير على طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" تذكيرًا صارخًا بأن مستويات القيادة العليا ليست بمنأى عن هذه الظاهرة. غير أن ما قد يبدو حوادث متفرقة في أوروبا إنما يندرج في الواقع ضمن نمط أوسع وأكثر تجذّرًا في الشرق الأوسط. ففي منطقة تتقاطع فيها أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة عالميًا، لم يعد التدخل في أنظمة الملاحة حدثًا نادرًا أو استثنائيًا، بل بات سمة متكررة من سمات الصراع، بما يحمله من انعكاسات تمتد من الجاهزية العسكرية إلى الاستقرار الاقتصادي، وصولًا إلى الحياة اليومية لملايين البشر.
10 سبتمبر 2025
تحذير استراتيجي: إسرائيل تأمر بإخلاء كامل لمدينة غزة
في تصعيد جديد للحرب المستمرة منذ نحو عامين، أصدرت إسرائيل يوم الثلاثاء أمراً بالإخلاء الكامل لمدينة غزة، التي يقطنها ما يقارب مليون فلسيني، تمهيداً لما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"بداية" مناورة برية مكثفة.
أسقط الجيش الإسرائيلي آلاف المنشورات التي تأمر السكان بالنزوح جنوباً باتجاه منطقة المواصي المكتظة، والمسمّاة بـ"المنطقة الإنسانية"، فيما واصلت الغارات الجوية استهداف الأبراج السكنية والأحياء الحضرية. وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول في الحملة الإسرائيلية، إذ تشير إلى انتقالها من السيطرة العسكرية الجزئية على مدينة غزة إلى السعي نحو فرض احتلال كامل لها.
24 أغسطس 2025
مستقبل الذكاء الاصطناعي والمجتمعات: كيف سيعيد تشكيل الاستقرار بدلاً من تقويضه
في ظلّ تصاعد موجة الحماس إزاء الذكاء الاصطناعي (AI) يوماً بعد آخر، تتنامى في الوقت نفسه الهواجس المرتبطة بتداعياته المحتملة على أسواق العمل واستقرار المجتمعات. وتشير دراسات متعددة إلى أن الأتمتة الكاملة قد تفضي إلى خلخلة البنى الاقتصادية وإرباك المنظومات السياسية. ورغم وجاهة هذه المخاوف وأهميتها، فإن من الأجدر التذكير بأن الذكاء الاصطناعي، كغيره من التحولات التكنولوجية الكبرى، يُجسّد مجالاً مزدوج الأبعاد: فهو يثير القلق من مخاطره بقدر ما يفتح آفاقاً رحبة لفرصه.
إن استدامة المجتمعات المستقرة مرهونة بفاعلية قوة العمل فيها؛ فإلغاؤها كلياً يتناقض مع أبسط مبادئ الاقتصاد مثل العرض والطلب، ويقوّض أسس الاستقرار السياسي التي تقوم على صلابة الطبقة الوسطى وتماسكها. وتُبرز هذه الحقائق البنيوية أن الذكاء الاصطناعي لن يفضي إلى اندثار العمل البشري بصورة مطلقة، بل سيُدمج، سواء عبر مسارات تلقائية أو من خلال سياسات واعية، في أنماط من شأنها الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنظور، يغدو المستقبل الذي يرسمه الذكاء الاصطناعي أقل قتامة بكثير مما يتوجس منه البعض.
14 أغسطس 2025
ماذا لو اشتعلت الحرائق في الشرق الأوسط؟
شكّل عام 2023 محطةً قاتمة في مسار تغيّر المناخ، حيث سُجل فيه أعلى عدد من حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي منذ بدء الرصد في عام 2000، بحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات ((EFFIS. فقد التهمت النيران أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل نصف حجم جزيرة قبرص تقريباً. وتفاقم الوضع في عام 2024، حيث ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بحرائق الغابات بشكل حاد ليبلغ 437 حالة، مقارنة بـ 263 حالة وفاة في عام 2023.
وتشير الأبحاث باستمرار إلى أن تغيّر المناخ يُعد العامل الرئيسي وراء هذه الأزمة المتصاعدة. فهو لا يقتصر على توسيع نطاق الأراضي المحترقة فحسب، بل يُكسب الحرائق الفردية طابعاً أكثر شدة، ويتسبب في تمديد موسم الحرائق إلى ما بعد أشهر الصيف التقليدية، ويؤدي إلى اندلاع النيران في مناطق لم تكن عرضةً لمثل هذه الكوارث من قبل. وبينما يقترب هذا التهديد المتنامي من الشرق الأوسط، يبقى السؤال الملحّ: هل ستكون المنطقة مستعدة له، أم أنّه سيفاجئها على نحو خطير؟
5 أغسطس 2025
تحذير استراتيجي: نتنياهو يخطط لغزو شامل لقطاع غزة
سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 5 أغسطس 2025 للمصادقة على خطط توسيع السيطرة العسكرية لتشمل القطاع بالكامل، في تصعيد خطير للصراع مع حماس. على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على حوالى 75٪ من غزة، يضغط نتنياهو لتوسيع العمليات لتشمل المناطق المكتظة بالسكان والتي يعتقد بوجود رهائن فيها، وهو اقتراح يواجه معارضة قوية من داخل صفوف الجيش وخاصة من رئيس الأركان إيال زامير، الذي يحذر من تداعيات إنسانية ومخاطر عملياتية كبيرة واصفًا الخطة بالفخ الاستراتيجي، و تعكس هذه الخطة توجهًا لإضعاف حركة حماس نهائيًا، وتأمين تحرير الرهائن، مع العلم أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى قد انهارت.
وفي تطور دراماتيكي، ألغى نتنياهو زيارة مقررة لزامير إلى واشنطن بعد إطلاعه على التوجه الجديد والتحولات الاستراتيجية المتسارعة. رفض زامير الخطة المقترحة صراحةً، مهددًا بالاستقالة في حال الموافقة عليها. تركزت تحفظات الجيش على مخاوفه على حياة الرهائن، لا سيما في مناطق مثل دير البلح التي لم تُطهر بالكامل من مقاتلي حماس. علاوةً على ذلك، أعربت قيادة الجيش عن قلقها إزاء تآكل قدراته القتالية، مشيرةً إلى نقص القوى البشرية بعد قرابة عامين من الصراع المتواصل، و دعا إلى اتباع استراتيجية احتواء أكثر حذرًا من شأنها ممارسة الضغط على حماس دون الانخراط في احتلال طويل الأمد وواسع النطاق.
23 يوليو 2025
الفصل الجيني: حين يصبح التفوّق الاصطناعي جدارًا يفصل البشر
في مستقبل يُعاد فيه تشكيل مفهوم "الإنسان" من خلال "التحرير الجيني"، لم تعد الحدود الفاصلة تُرسم على أساس العِرق أو الثروة أو الطبقة الاجتماعية، بل على أساس "التفوّق الاصطناعي". لقد انقسمت المدن إلى عالمين متباعدين؛ حيث حُظرت محاولات الاندماج، وعاش المحظوظون حياةً معزّزة بالتكنولوجيا، بينما بقي الآخرون غير معدّلين جينيًا، ومُهمَّشين، وغير مرغوب فيهم.