شهد النظام الدولي تحوّلًا جذريًّا في النظرة إلى الفضاء الخارجي، حيث لم يعد يُمثّل مجرد امتداد تقني للاستكشاف العلمي، بل أصبح يُجسّد موردًا استراتيجيًّا بالغ الأهمية. ساهمت الثورة الرقمية والاعتماد المتزايد على الأقمار الصناعية في تعظيم القيمة الجيوسياسية للمدارات، ودفع هذا التحوّل مؤسسات التنظيم الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إلى توسيع دورها في إدارة ما يُعرف بالموارد المدارية الطيفية (orbit-spectrum resources). رغم ذلك، حافظت هذه المؤسسات على آليات تنظيمية تعود جذورها إلى حقبة الستينيات، في وقت تضاعفت فيه أعداد الفاعلين وأهداف الاستخدام.
اعتمدت منظومة الـITU على مبدأ "الأسبقية في التقديم" (First Come, First Served – FCFS)، فسمحت للأطراف القادرة على تقديم ملفاتها مبكرًا بالحصول على أولوية قانونية في الوصول إلى المدارات والترددات، دون أن تربط ذلك بمدى الجاهزية التقنية أو الالتزام الفعلي بالتشغيل. هذا الإطار التنظيمي، الذي استجاب في حينه لمتطلبات فنية محدودة ولعدد قليل من الدول، لم يواكب التغيرات اللاحقة، فساهم في تكريس تفاوتات هيكلية بين من امتلك قدرات مبكرة ومن بقي على هامش النظام الفضائي العالمي.
دفع هذا الخلل النظامي الدول القادرة على بناء وتشغيل منظومات فضائية معقدة إلى استغلال قواعد الـFCFS، فاستحوذت على المواقع المدارية ذات القيمة الاستراتيجية. وتشير بيانات عام 2025 إلى وجود أكثر من 12,000 قمر صناعي نشط حول الأرض، تُشغّل الولايات المتحدة وحدها نحو 70% منها، بينما لا تتجاوز حصة الغالبية الساحقة من الدول النامية نسبًا هامشية. ارتبط هذا التوزيع غير المتكافئ بطفرة الكوكبات الضخمة (mega-constellations) في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، حيث أطلقت شركات مثل SpaceX آلاف الأقمار ضمن شبكات مستقلة تُهيمن على البنية التحتية للاتصال العالمي.
لم تقتصر الإشكاليات على التوزيع غير العادل، بل امتدت لتشمل تحديات تتعلق بالاستدامة البيئية والأمن التقني. أسهمت الوتيرة المرتفعة لإطلاق الأقمار الصناعية في ازدحام طبقات المدار، ورفعت احتمالات التصادم، وعمّقت أزمة الحطام الفضائي. ومع أنّ النظام الحالي يُركّز على منع التداخل الترددي، إلا أنه لا يمتلك أدوات تنظيم حقيقية لإدارة الكثافة المدارية أو لتقليل مخاطر الاصطدام. ونتيجة لذلك، نشأت فجوة بين أهداف التنظيم التقني ومقتضيات الإدارة البيئية والأمنية.
في ضوء هذه التحولات، يهدف هذا التحليل إلى دراسة المنظومة القانونية والإجرائية القائمة، وتفكيك منطق عمل مبدأ FCFS، من خلال دراسة بيانات الامتلاك المداري، ورصد أنماط التمركز الاستراتيجي، وتتبع تداعياتها البيئية والجيوسياسية والاقتصادية.
النظام الإجرائي للولوج المداري: كيف تُنتج القواعد التنظيمية تفاوتًا بنيويًّا؟
يُظهر التوزيع غير المتكافئ للموارد المدارية أن العائق لا يكمن فقط في القدرات التقنية أو التمويل، بل يتجسّد أيضًا في بنية الوصول نفسها. فقد رسّخ الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) نظامًا إجرائيًّا مُعقّدًا لتنظيم الوصول إلى المورد المدار-الطيفي (orbit-spectrum resource)، يقوم على لوائح الراديو (Radio Regulations) باعتبارها المرجعية القانونية الدولية المُلزمة. وتُجسّد هذه البنية آلية بيروقراطية دقيقة، لكنّها تمنح الأسبقية القانونية بناءً على التوقيت لا على الجدوى أو العدالة، مما أتاح للدول القوية ترسيخ وضعها المداري عبر أدوات تنظيمية لا تُدرك ظاهرًا طبيعتها التراكمية التمييزية.
يتطلب الحصول على موقع مداري وتردد مصاحب، المرور بخمس مراحل أساسية تبدأ بتقديم إخطار النشر المسبق (Advance Publication Information – API)، الذي يحتوي على معلومات أولية عن خصائص القمر المزمع إطلاقه. بمجرد تسجيل الـAPI لدى الـITU، تُمنح الجهة المُقدّمة “أولوية التقديم” التي تُحدّد ترتيبها في أي نزاع لاحق حول التداخل الراديوي. ولا تسمح القواعد بالتقدّم للمرحلة التالية، وهي طلب التنسيق (Coordination Request – CR/C)، إلا بعد مرور ستة أشهر من نشر الـAPI، ما يُؤسس لنظام زمني جامد يُحدد أحقية الوصول بناءً على ترتيب الورود لا على القيمة أو الجدارة.
تفرض المرحلة التالية الدخول في مفاوضات تنسيقية ثنائية مع كل دولة ترى أن القمر الجديد قد يُسبّب تداخلاً مع شبكاتها. وتُلزم هذه القواعد الجهة المُتأخرة بتقديم حلول تقنية تضمن عدم الإضرار بأنظمة سابقة، مما يضع عبء الإثبات كاملًا على الكيانات الجديدة. تستغرق هذه المرحلة غالبًا سنوات طويلة، خاصة في حالة الكوكبات الكبيرة (mega-constellations) ، وتُنتج حالة من التعقيد التفاوضي تُجيد الشركات الكبرى إدارتها، بينما تُرهق الإدارات الوطنية الضعيفة.
عندما تُنجز اتفاقيات التنسيق، تُقدّم الجهة الراعية إخطارًا نهائيًّا للتسجيل في السجل الدولي الرئيسي للترددات (Master International Frequency Register – MIFR)، وهو السجل الذي يمنح الحماية القانونية الدولية من التداخلات اللاحقة. لكن النظام لا يكتفي بالإجراءات الورقية؛ إذ يفرض شرطًا نهائيًّا بتفعيل الشبكة فعليًّا خلال سبع سنوات من تسجيل الـAPI، وإلا يُلغى الحق المكتسب وتُزال البيانات من السجل، توضّح المراحل الإجرائية الخمس التي تتطلبها عملية التسجيل المداري، وما يقابل كل مرحلة من وثائق تنظيمية ومتطلبات زمنية ومخرجات قانونية، طبيعة التعقيد الزمني والمؤسسي الذي يُنتج هذا التفاوت البنيوي. يُظهر الجدول التالي ملخصًا لهذه المراحل كما وردت في لوائح الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.
تُبرز هذه البنية التنظيمية ثلاث نتائج رئيسية. أولًا، حوّلت هذه القواعد الأسبقية الزمنية إلى شكل مستقر من الامتياز القانوني طويل الأجل. ثانيًا، رفعت كلفة الدخول إلى النظام، حيث تتجاوز رسوم ملف التسجيل الواحد 100,000 فرنك سويسري، دون احتساب التكاليف الهندسية والقانونية الممتدة لسنوات. وثالثًا، صنعت فجوة مؤسسية بين الفاعلين، حيث تمتلك الدول المتقدمة القدرة على التعامل مع البيروقراطية التقنية المعقّدة، بينما تواجه الدول النامية صعوبات هيكلية في مجرد خوض المسار التنظيمي، ناهيك عن استكماله بنجاح.
تكشف هذه القواعد أنّ المورد المدار-الطيفي لا يُوزَّع فقط عبر التنافس التقني أو السياسات الفضائية، بل عبر منظومة إجراءات تُنتج بحد ذاتها شكلًا من أشكال “التملك التنظيمي”، يُمكّن اللاعبين الكبار من فرض أسبقيتهم باستخدام القواعد القانونية، حتى قبل الوصول إلى المدار الفعلي. بهذا المعنى، لا تُشكّل اللوائح مجرد أدوات حيادية، بل تُعيد إنتاج موازين القوة داخل الفضاء، من خلال آليات لا تُقيّم الحاجة أو طبيعة الاستخدام، بل تُكافئ القدرة على الامتثال المبكر والمُكلّف للمنظومة الإجرائية القائمة.
الهيمنة التنظيمية على أغلى نطاق مداري في الفضاء
يتميّز المدار الثابت (Geostationary Orbit – GSO) بارتفاعه المحدد عند 35,786 كيلومترًا فوق خط الاستواء، وبقدرته على الحفاظ على موقع ثابت نسبيًّا بالنسبة لنقطة أرضية محددة. وتُنتج هذه الخاصية ثلاث نتائج عملية شديدة الأهمية. أولًا، تسمح الأقمار في هذا المدار بتغطية متواصلة لمنطقة واسعة دون الحاجة إلى إعادة توجيه المحطات الأرضية، ما يُقلل التكاليف التشغيلية ويُبسّط البنية التحتية. ثانيًا، يستطيع كل قمر تغطية نحو 42% من سطح الأرض، ما يجعل من الممكن نظريًّا تحقيق تغطية شبه عالمية بثلاثة أقمار فقط. ثالثًا، يوفّر هذا الموقع المدار المثالي للمهام التي تتطلب المراقبة المستمرة، كالأرصاد الجوية، والبث المباشر، والملاحة التصحيحية.
لكن القيمة الكبرى لهذا المدار لا تنبع فقط من هذه القدرات، بل من ندرته الفيزيائية. إذ لا يمكن تشغيل عدد غير محدود من الأقمار فيه، بسبب متطلبات التباعد الزاوي لتجنّب التداخل الراديوي. وتُقدّر السعة النظرية للمدار بما يتراوح بين 1800 و2000 موقع، لكن السعة الفعلية أقل من ذلك بكثير، لا سيما في النطاقات الترددية الأكثر طلبًا. وتزداد الندرة حين يتعلق الأمر بمواقع الطول التي تُتيح تغطية اقتصادات كبرى، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، ما يجعل المواقع المدارية “المربحة” محدودة للغاية وتتناقص بمرور الوقت.
استغلّت الدول القادرة هذه المعادلة التنظيمية، فعمدت إلى تسجيل مواقعها مبكرًا وفق مبدأ الأسبقية في التقديم (FCFS)، ثم حافظت عليها بفضل القاعدة التي تتيح “الاستمرارية التنظيمية” طالما جرى استبدال القمر بعد انتهاء عمره التشغيلي. هذا يعني أن الأسبقية الزمنية الأولى تنتج امتيازًا مداريًّا دائمًا، دون آلية لإعادة توزيع المواقع أو إخضاعها لتقييم دوري أو مقابل مالي. ومن خلال هذا النظام، تمكّنت كيانات مثل Intelsat وSES وغيرهما من الاحتفاظ بحصص استراتيجية في المدار منذ عقود، دون منافسة فعلية.
تشير بيانات عام 2025 إلى أنّ الولايات المتحدة وروسيا والصين تستحوذ مجتمعة على أكثر من نصف المواقع النشطة في GSO، بينما تتقاسم بقية دول العالم—بما في ذلك القوى المتوسطة والدول النامية—ما تبقّى من المساحات القابلة للتشغيل. وقد فشلت محاولات إعادة التوازن داخل مؤتمرات الـITU في تغيير هذا الوضع، نتيجة مقاومة الدول المالكة للمواقع وقوة مركزها القانوني والإجرائي.
تكشف هذه الحالة أن الحيازة المدارية لا تعتمد على النشاط الفضائي بحد ذاته، بل على الحيازة المبكرة للحق القانوني في الموقع، وعلى القدرة المؤسسية في تجديده باستمرار. وبهذا، يتحول GSO من مورد مشترك إلى أصل مؤسسي خاضع للهيمنة التنظيمية، يحظى بحماية القانون الدولي دون أن يخضع لأي شرط لإعادة التوزيع العادل أو الاستخدام الأمثل، ما يُعيد إنتاج احتكار طويل الأمد مقنن داخل بنية التنظيم نفسها.
دليل التمركز الاحتكاري: قراءة كمية وكيفية في مؤشرات السيطرة المدارية
تُظهِر البيانات الحديثة أنّ الهيمنة التنظيمية على المدار الثابت (GSO)، التي جرى تحليلها في القسم السابق، لا تُعد استثناءً، بل تمثّل حالة مُركّزة داخل نمط أوسع من التمركز الاحتكاري في توزيع الموارد المدارية. ويتجلّى هذا النمط بشكل كمي مباشر في بيانات ملكية الأقمار الصناعية، وبشكل نوعي في ممارسات تنظيمية وتجارية تُعزز سيطرة عدد محدود من الدول والشركات على البنية التحتية المدارية الكوكبية.
إذ تُظهر إحصاءات أوائل عام 2025 أنّ الولايات المتحدة تُشغّل نحو 8,530 قمرًا صناعيًّا، ما يُعادل أكثر من 70٪ من إجمالي الأقمار النشطة عالميًّا. ويليها كل من روسيا (1,559 قمرًا) والصين (906 أقمار)، بينما تمتلك المملكة المتحدة واليابان والهند وفرنسا وألمانيا أعدادًا أقل بكثير. وتشير هذه الأرقام إلى أن أكثر من 99٪ من إجمالي السعة المدارية النشطة يتركّز في أيدي ثماني دول فقط. ويُعمّق هذا التفاوت حين نُفرّق بين الأقمار العاملة في المدار الثابت (GSO) وتلك العاملة في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، إذ تستحوذ الولايات المتحدة وحدها على أكثر من 8,300 قمر في LEO، معظمها ضمن منظومة Starlink التابعة لشركة SpaceX.، يعرض الشكل التالي التوزيع العالمي للأقمار الصناعية النشطة بحسب الدول الرئيسية المالكة، مع تصنيف تفصيلي بين الأقمار العاملة في المدار الثابت (GSO) والمدارات غير الثابتة (NGSO)، ويُقدّم تصورًا كميًّا دقيقًا لمستويات التمركز في البنية المدارية العالمية حتى أوائل عام 2025.
تتجاوز هذه السيطرة البعد الكمي إلى بُعد نوعي أكثر خطورة يتمثل في نشوء أوليغوبوليات فضائية (space-based oligopolies)، تتكوّن من تحالفات بين شركات عملاقة وحكومات داعمة. وتُشكّل منظومات مثل Starlink (الولايات المتحدة)، OneWeb (المملكة المتحدة)، Kuiper (أمازون – الولايات المتحدة)، وGuowang (الصين) أمثلة واضحة على هذا التمركز المؤسسي. ويُلاحظ أنّ هذه الكيانات لا تُقدّم طلبات لتشغيل عشرات أو مئات الأقمار، بل لآلاف أو عشرات الآلاف دفعة واحدة، ما يُمكّنها من حجز نطاقات ضخمة من المدار والطيف، وإجبار أي جهة لاحقة على التفاوض معها وفق قواعد FCFS.
ويُبرز مثال مشروع Cinnamon-937 التابع لشركة E-Space، المُسجّل باسم رواندا، كيف تحوّلت الاستفادة من نظام FCFS إلى ممارسة إستراتيجية مستقلة عن القدرة التقنية. فقد قدمت الشركة طلبًا لتسجيل أكثر من 330,000 قمر صناعي، رغم عدم امتلاكها أي سجل فعلي في عمليات الإطلاق. وبهذا، لم تُستخدم أولوية التقديم لتشغيل شبكة اتصالات، بل لانتزاع مركز تفاوضي يُمكّنها من تحصيل تنازلات مستقبلية أو إعاقة دخول منافسين محتملين، عبر ما يُعرف اصطلاحًا بـ”الأقمار الورقية” (paper satellites).
تمثّل هذه الممارسات امتدادًا تاريخيًّا لنموذج “تونغاسات” الذي اشتهر في تسعينيات القرن العشرين، حين استخدمت مملكة تونغا نظام الـITU لحجز 16 موقعًا مداريًّا دون وجود برنامج فضائي وطني، لتقوم لاحقًا بتأجير تلك المواقع بملايين الدولارات. لم تُخالف تونغا اللوائح، لكنها كشفت عن ثغرات هيكلية تسمح بتحويل الأسبقية الزمنية إلى أصل مالي قابل للتداول دون قيد تشغيلي.
تُبيّن هذه الحالات أنّ النظام الحالي لا يُنتج احتكارًا فعليًّا فقط، بل يسمح أيضًا ببناء احتكار محتمل يُمنح كامل الحماية القانونية قبل أن يدخل أي قمر إلى الفضاء. ويعني ذلك أنّ آليات التسجيل والتنظيم لم تعد ترتبط بواقع التشغيل الفضائي، بل تحوّلت إلى أدوات استراتيجية تُوظّفها الشركات والدول لبناء مواضع تفاوضية، وتجميد الموارد، وتعميق الفجوة بين الفاعلين الحاليين والداخلين الجدد. ومع تصاعد حجم الطلب على المدار والطيف، تتحوّل هذه الفجوة إلى مصدر تهديد متزايد لبنية الحوكمة الدولية للفضاء.
النتائج البنيوية لانحراف النظام: من التفاوت في الوصول إلى تهديد الاستدامة والكفاءة
أظهرت الأقسام السابقة كيف أسّس نظام التخصيص المدار-الطيفي لحالة من التمركز الاحتكاري في الفضاء القريب من الأرض. غير أن هذا التمركز لا يُنتج فقط تفاوتًا في التوزيع، بل يفرز ثلاث نتائج بنيوية تؤثر مباشرة في مبادئ العدالة، والاستدامة البيئية، والكفاءة الاقتصادية، ما يستدعي قراءة نقدية متعددة الأبعاد لهذا النظام.
أولًا، قوّض هذا الإطار التنظيمي مبدأ “الوصول العادل” المنصوص عليه في المادة 44 من دستور الـITU، التي تنص على ضمان استخدام منصف وفعال للموارد المدارية. في الممارسة، فرضت البنية الإجرائية المعقّدة للنظام عوائق تنظيمية ومالية لا تستطيع الدول النامية تجاوزها بسهولة. فغياب الخبرات المتخصصة، وضعف القدرات المؤسسية، وانعدام البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتنسيق، كلها عوامل منعت هذه الدول من التقدّم بفعالية داخل النظام. وعندما فشلت مبادرة “إعلان بوجوتا” عام 1976 في نيل الاعتراف الدولي، رغم ما طرحته من منطق سيادي موجه نحو العدالة المدارية، ظهر جليًّا أن الإطار القانوني السائد لا يُمكنه معالجة هذا الخلل البنيوي دون تعديل جذري في فلسفته التوزيعية.
ثانيًا، أدّى التوسع غير المنظم في إطلاق الأقمار العملاقة (mega-constellations) إلى تسريع ظاهرة “الاستحواذ على الأملاك المشاع” في المدار الأرضي المنخفض (LEO). إذ كشفت النماذج الحديثة أن تنفيذ جزء بسيط من الكوكبات المسجلة حاليًّا قد يرفع احتمالات وقوع اصطدامات كارثية بأكثر من عشرة أضعاف، ما قد يؤدي إلى حادثة تصادم رئيسية كل عام. ورغم اعتماد القاعدة التنظيمية المعروفة باسم “قاعدة 25 عامًا” (25-year rule) لتفكيك الأقمار المنتهية صلاحيتها، إلا أن استمرار الالتزام بهذه القاعدة دون تحديث قد يُفضي إلى تراكم أكثر من 100 ألف قطعة حطام بحلول عام 2100، وهو ما يهدد جدوى الاستخدام طويل الأجل للمدار ويفتح المجال أمام سلسلة ارتدادية من الحوادث تعرف بـ”متلازمة كيسلر”.
ثالثًا، خلقت هذه الحالة من التركّز تشوّهًا واضحًا في البنية السوقية، ما أثّر سلبًا على الكفاءة الاقتصادية الكلية. تُقدّر الدراسات أن البنية الأوليغوبولية التي يفرزها النظام الحالي تخفّض الكفاءة الاقتصادية بنسبة تصل إلى 12%، أي ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار سنويًّا مقارنة بنموذج الخدمة العامة المنظّمة. احتفاظ الشركات الكبرى بملفات تشغيلية لأقمار غير نشطة فعليًّا، مع استمرارها في منع دخول منافسين جدد، أدى إلى تباطؤ الابتكار، وتأخير الاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة، وتقليص ديناميكية السوق الفضائية.
مستقبل الحوكمة المدارية: المسارات المحتملة للإصلاح
أوضحت الفقرات السابقة كيف أفضى الإطار التنظيمي القائم على مبدأ الأسبقية في التقديم (FCFS) إلى إنتاج احتكار قانوني وبيئي واقتصادي داخل المجال المداري. غير أن إدراك خطورة هذه التشوهات لا يكفي ما لم يُقترن بمراجعة جذرية لبنية الحوكمة نفسها. وقد طرحت السنوات الأخيرة عددًا من المقترحات التي تتوزع بين توجهين رئيسيين: الأول يسعى إلى إصلاح تدريجي داخل الإطار القائم للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والثاني يدعو إلى إعادة هيكلة شاملة لنموذج إدارة الموارد المدارية، بما يتجاوز الأطر الحالية نحو تأسيس ميثاق جديد للحوكمة الفضائية.
المقترح الأول يعتمد على تعزيز متطلبات “الجدية التشغيلية” كشرط لحماية أولوية التسجيل. وقد بدأ تطبيق هذا الاتجاه في مؤتمر الاتصالات الراديوية عام 2019 (WRC-19) من خلال اعتماد نظام قائم على مراحل إلزامية لنشر الأقمار الصناعية ضمن الكوكبات غير الثابتة (NGSO)، حيث تُلزم الجهات المُسجّلة بإطلاق 10٪ من الكوكبة خلال عامين، و50٪ خلال خمسة أعوام، و100٪ خلال سبعة أعوام. هذا المسار يُشكّل تطورًا مهمًّا للحد من ظاهرة “الأقمار الورقية”، إلا أنّه لا يعالج جذور التفاوت في القدرة على الاستجابة لمثل هذه الالتزامات، خاصة من جانب الدول منخفضة القدرة التنظيمية أو الشركات الناشئة.
مقترح آخر يُركّز على تفعيل ما يُعرف بـ”نموذج التخطيط المسبق” (a priori planning)، والذي يقوم على تخصيص مدارات وترددات محددة سلفًا لكل دولة عضو في الـITU، كما هو الحال في خطة خدمات البث بالأقمار الصناعية (BSS). ورغم أنّ هذا النموذج طُبّق في قطاعات محدودة، إلا أنّ توسيعه ليشمل نطاقات استخدام أوسع قد يسمح للدول النامية بضمان الحد الأدنى من الوصول إلى المدار والطيف، دون الحاجة إلى الدخول في منافسة مفتوحة تُرجّح كفّة الدول الغنية والمؤسسات المهيمنة. لكن تطبيق هذا النموذج يطرح إشكاليات تتعلق بكفاءة استخدام الموارد، إذ قد تُخصّص مدارات لدول لا تملك القدرة على تشغيلها فعليًّا، ما يُعيد إنتاج حالة من الهدر التنظيمي في الاتجاه المعاكس.
على الجانب الآخر، تدعو بعض المقترحات إلى تجاوز منظومة الـITU ذاتها عبر تطوير نظام ترخيص مزدوج يشمل المدار إلى جانب الطيف، بحيث تخضع كل عملية تشغيل لتقييم بيئي وتقني مُسبق يأخذ في الحسبان خطر الحطام الفضائي، واحتمالية التصادم، والتداخل الترددي، والتأثير على السوق. هذا التوجه يتطلب إنشاء جهة تنظيمية جديدة ذات طابع دولي، أو توسيع ولاية جهة قائمة مثل لجنة الأمم المتحدة لاستخدامات الفضاء في الأغراض السلمية (COPUOS). كما طُرحت فكرة اللجوء إلى آليات اقتصادية مثل المزادات المفتوحة لتخصيص الموارد المدارية، إلا أن هذا الخيار يلقى رفضًا واسعًا من دول الجنوب التي ترى فيه تهديدًا مباشرًا لما تبقى من مبدأ المساواة في الوصول، وتحويلًا للفضاء إلى سوق خاضعة لقوانين الثروة فقط.
في ظل تعقّد هذه المسارات، يبرز خيار ثالث يتمثل في النموذج الهجين، والذي يجمع بين تخصيص أساسي مُسبق لكل دولة يضمن الحد الأدنى من العدالة، وآليات سوق شفافة تضمن الكفاءة في استخدام الموارد الزائدة عن هذا الحد. هذا النموذج يوفّر أساسًا عمليًّا للتوازن بين مبدأي الكفاءة والتوزيع العادل، ويُجنّب الوقوع في مفاضلة صفرية بين الإنصاف والتشغيل.
بالمجمل، يُشير الاتجاه العام داخل مؤتمرات الـITU إلى الاعتراف بتآكل صلاحية النظام القائم، إلا أن التباين العميق في مصالح الدول يُعيق التوصل إلى توافق حقيقي حول نموذج جديد. ويبقى السؤال المفتوح: هل يمكن للمجتمع الدولي التوصّل إلى ميثاق مداري يعيد تعريف قواعد اللعبة قبل أن تُقفل المدارات المتاحة فعليًّا بفعل الأمر الواقع القانوني؟
المراجع
“Paper Satellites” and the Free Use of Outer Space – Globalex, accessed September 25, 2025, https://www.nyulawglobal.org/globalex/paper_satellites_free_use_outer_space1.html
SPACE PROCEDURES – ITU, accessed September 25, 2025, https://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=eng&year=2009&issue=02&ipage=26
Regulation of satellite systems – ITU, accessed September 25, 2025, https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/Regulation-of-Satellite-Systems.aspx
ITU RADIO REGULATORY FRAMEWORK FOR SPACE SERVICES, accessed September 25, 2025, https://www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Documents/ITU-Space_reg.pdf
Geostationary Orbit – Oxford Public International Law, accessed September 25, 2025, https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1171?p=emailAO8s4UvJ5NXho&d=/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1171&print
Geostationary Orbit Slot Reconceptualization In Accommodating the South – UI Scholars Hub, accessed September 25, 2025, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1555&context=ijil
International Satellite Coordination | Federal Communications Commission, accessed September 25, 2025, https://www.fcc.gov/space/international-satellite-coordination
Navigating the Spectrum: An Overview of ITU’s Regulatory Process for Small Satellites, accessed September 25, 2025, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2024/all2024/134/
WRS-22: Regulation of satellites in Earth’s orbit – ITU, accessed September 25, 2025, https://www.itu.int/hub/2023/01/satellite-regulation-leo-geo-wrs/
Limited Space: Allocating the Geostationary Orbit – Scholarly Commons, accessed September 25, 2025, https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1216&context=njilb
Basics of the Geostationary Orbit – CelesTrak, accessed September 25, 2025, https://celestrak.org/columns/v04n07/
Chapter 5: Planetary Orbits – NASA Science, accessed September 25, 2025, https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter5-1/
Catalog of Earth Satellite Orbits – NASA Earth Observatory, accessed September 25, 2025, https://earthobservatory.nasa.gov/features/OrbitsCatalog/page2.php
Legal Issues Related to Satellite Orbits | Oxford Research Encyclopedia of Planetary Science, accessed September 25, 2025, https://oxfordre.com/planetaryscience/display/10.1093/acrefore/9780190647926.001.0001/acrefore-9780190647926-e-78?d=%2F10.1093%2Facrefore%2F9780190647926.001.0001%2Facrefore-9780190647926-e-78&p=emailA2w3%2F4JmXZlt
Wealthy nations are carving up space and its riches — and leaving other countries behind, accessed September 25, 2025, https://www.astronomy.com/space-exploration/wealthy-nations-are-carving-up-space-and-its-riches-and-leaving-other-countries-behind/
Geostationary Orbit: A Strategic Domain for European Space Resilience – Exotrail, accessed September 25, 2025, https://www.exotrail.com/blog/www-exotrail-com-blog
How smaller satellites are reshaping the geostationary orbit market, accessed September 25, 2025, https://space4peace.org/how-smaller-satellites-are-reshaping-the-geostationary-orbit-market/
What are geostationary satellites and what are they used for? – Blog Hispasat, accessed September 25, 2025, https://blog.hispasat.com/en/articulo/147/what-are-geostationary-satellites-and-what-are-they-used-for
The future risk of space assets and contested environments increases the intrinsic and actual cost of geostationary orbit slots – AMOS Conference, accessed September 25, 2025, https://amostech.com/TechnicalPapers/2023/Poster/Shahady.pdf





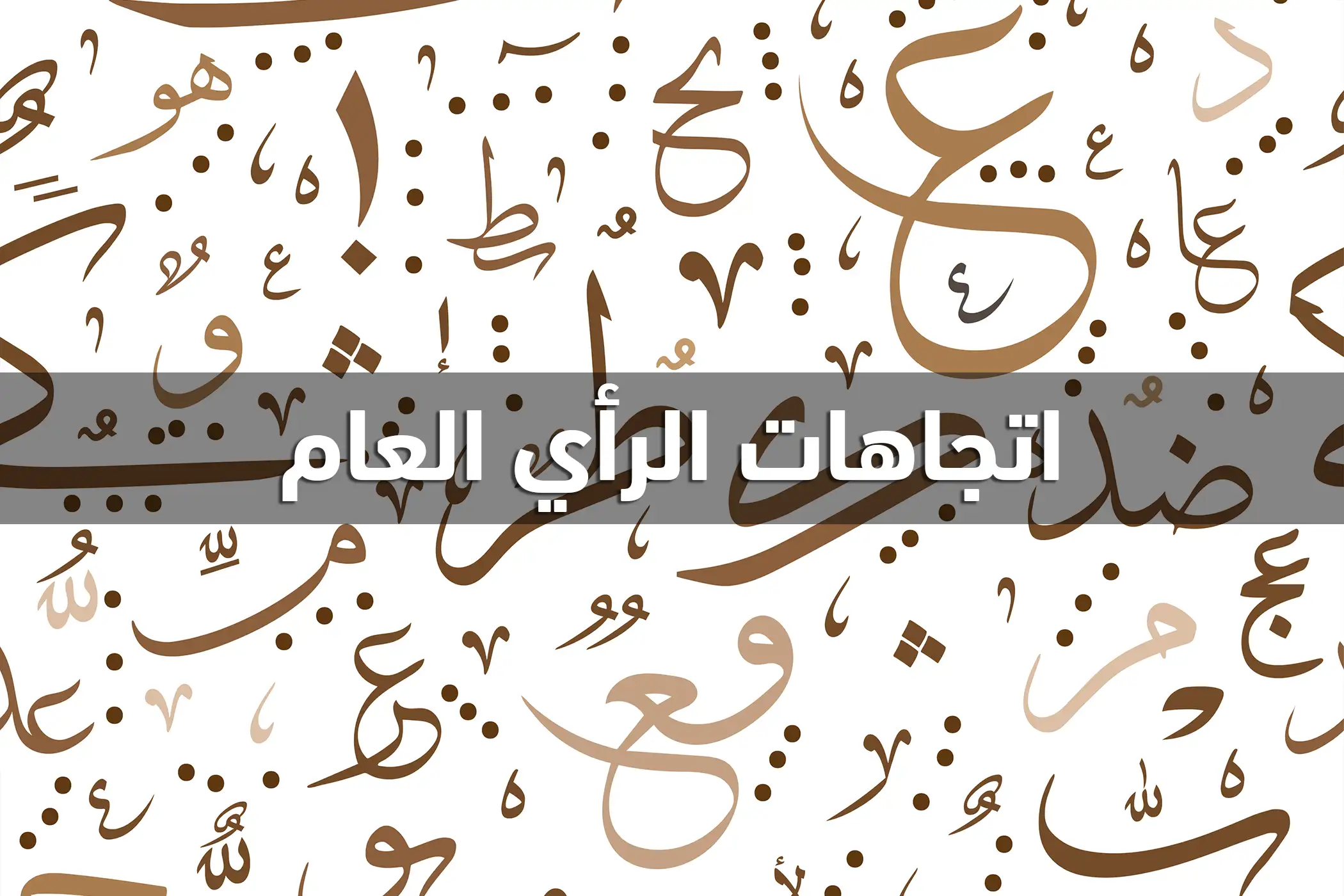

















تعليقات