شهد المدار القريب من الأرض Low Earth Orbit (LEO) منذ إطلاق القمر الصناعي الأول عام 1957 تحوّلًا جوهريًا من فضاء شبه فارغ إلى بيئة ملوّثة ومزدحمة بمخلّفات النشاط الفضائي. فقد تراكمت الأقمار الصناعية غير الوظيفية Dead Satellites، ومراحل الصواريخ المستهلكة Spent Rocket Stages، والقطع المُتفككة الناتجة عن الانفجارات والاصطدامات Fragmentation Debris، حتى تجاوزت الكتلة الاصطناعية في المدار 14,700 طن، كما وأسهمت أحداث محددة في تضخيم هذه الأزمة، أبرزها التجربة الصينية المضادة للأقمار الصناعية Anti-Satellite Test (ASAT) عام 2007، والاصطدام بين القمر الأميركي Iridium-33 والقمر الروسي Kosmos-2251 عام 2009، واللذان ولّدا معًا ما يقارب ثلث الحطام المرصود في المدار الأرضي المنخفض.
تتوزع هذه المخلفات عبر نطاقات مدارية مختلفة، لكنها تتركز بكثافة في الحزام الممتد بين 750 و1000 كيلومتر، وهو أكثر المدارات استخدامًا لأغراض الرصد الأرضي Earth Observation والاتصالات. وفي هذه الارتفاعات قد تبقى الأجسام قرونًا قبل أن تدخل الغلاف الجوي، فيما يكتسب المدار الثابت Geostationary Orbit (GEO) خطورته من استدامة وجود أي حطام يتولد فيه، نظرًا لندرة عودة الأجسام المتواجدة فيه إلى الأرض. الأمر الذي حول المدار من مجرد ساحة مفتوحة إلى موردًا محدودًا ملوّثًا يستدعي إدارة جماعية رشيدة.
يتناول هذا الملف بالدراسة والتحليل الأبعاد الاقتصادية والسياسية لظاهرة الحطام الفضائي Space Debris. ويركّز على قياس الكلفة المباشرة التي تتحملها الشركات والوكالات في إدارة مخاطرها، ثم ينتقل إلى تفكيك الانعكاسات غير المباشرة لهذه الظاهرة على البنية التحتية الأرضية مثل أنظمة الملاحة العالمية Global Navigation Satellite Systems (GNSS) والأرصاد الجوية Weather Forecasting. كما يخصص مساحة لتوضيح العقبات التي تواجه الدول النامية، من نقص التمويل إلى ضعف القدرات التقنية والتنظيمية، في ظل بيئة مدارية صاغتها أفعال القوى الفضائية الكبرى. وينتهي إلى بحث الاستجابات الممكنة، من إجراءات التخفيف Mitigation إلى الإزالة النشطة لهذه الأجسام Active Debris Removal (ADR).
المدار المشترك: مورد ملوث ومحدود
يمثل المدار القريب من الأرض موردًا عالميًا مشتركًا محدودًا يزداد تلوثه يومًا بعد يوم بفعل تراكم الأجسام غير الوظيفية. وقد انتقلت هذه المشكلة من كونها مجرد أثر جانبي للنشاط الفضائي إلى كونها أزمة بيئية واقتصادية قائمة، تُقارن من حيث طبيعتها بمشكلة التغير المناخي على الأرض، لكن في مجال مداري مغلق. فالتركة الفضائية الحالية ليست مجرد أقمار صناعية متوقفة أو مراحل صاروخية قديمة، بل شبكة معقدة من المخلفات تتراوح بين قطع ضخمة يسهل تتبعها وجزيئات دقيقة يصعب رصدها لكنها تظل قادرة على إلحاق الضرر، بأي نشاط قادمة.
تشير البيانات الصادرة عن شبكات المراقبة الفضائية إلى أن عدد الأجسام القابلة للتتبع، أي التي يتجاوز قطرها عشرة سنتيمترات، بلغ نحو 34 إلى 43 ألف قطعة. أما الأجسام المتوسطة الحجم بين سنتيمتر واحد وعشرة سنتيمترات فيصل عددها إلى ما بين 900 ألف و1.2 مليون جسم، وهي تمثل الخطر الأكثر جدية نظرًا لاستحالة تتبعها بموثوقية رغم قدرتها على تدمير قمر صناعي عامل بالكامل. في المقابل، يُقدّر عدد الجسيمات الأصغر من سنتيمتر واحد بأكثر من 140 مليون قطعة، وهي وإن لم تكن قاتلة بذاتها فإنها تسبب تآكلًا تدريجيًا لمكونات حيوية مثل الألواح الشمسية والمستشعرات. هذا التدرج في الأحجام يعني أن البيئة المدارية مهددة بمزيج من الأخطار المرئية والمستترة في آن واحد، يوضح الشكل التالي توزيع العدد والحجم للأجسام في المدار.
يتضح عمق الأزمة عند النظر إلى الطاقة الحركية الهائلة التي تحملها هذه الأجسام. ففي LEO تتحرك الأجسام بسرعات تتراوح بين 7 و8 كيلومترات في الثانية، ما يجعل متوسط سرعة الاصطدام يقارب 10 كيلومترات في الثانية، وهو ما يعادل عشرة أضعاف سرعة الرصاصة. عند هذه السرعات، يكفي جسم معدني صغير بقطر سنتيمتر واحد ليتسبب في دمار كامل لمركبة فضائية، وهو ما يفسر الخطر المتصاعد حتى من الجزيئات التي لا يمكن رصدها بشكل مباشر. هذا الطابع الفيزيائي يضع حدودًا واضحة أمام قدرة التكنولوجيا الحالية على التعامل مع هذه التهديدات التي باتت تُهدد النشاط الاقتصادي الفضائي بشكل كامل.
كذلك يزيد البعدين الزمني والمداري من خطورة الوضع. فالأجسام التي تدور تحت ارتفاع 600 كيلومتر تميل إلى الاحتراق في الغلاف الجوي خلال سنوات قليلة بفضل تأثير السحب الجوي والجاذبية الأرضية، بينما تستمر الأجسام على ارتفاع 800 كيلومتر لمئات السنين، وتبقى الأجسام في المدارات الأعلى، بما فيها GEO، لآلاف السنين تقريبًا، يجعل هذا الفارق الزمني أي حادثة إطلاق أو انفجار أو اصطدام تقع اليوم مشكلة تمتد آثارها إلى أجيال قادمة، وهو ما يفرض على صانعي السياسات اعتبار المدار موردًا غير متجدد للبشرية، يجب العمل على إطالة استدامته.
وقد أثبتت الأحداث التاريخية أن التراكم لا يحدث فقط ببطء، بل يمكن أن يقفز فجأة نتيجة حدث واحد. فقد أضافت تجربة ASAT الصينية عام 2007 وحدها أكثر من 3,000 قطعة قابلة للتتبع إلى المدار، فيما أطلق اصطدام Iridium-33 وKosmos-2251 عام 2009 آلاف القطع الجديدة، وهو ما رفع مستوى المخاطر في شرائح مدارية كاملة بصورة مفاجئة. هذه الوقائع تعزز من وجاهة النظرية التي طرحها دونالد كيسلر عام 1978 والمعروفة باسم “متلازمة كيسلر”، والتي تحذر من وصول الكثافة المدارية إلى نقطة يصبح فيها الاصطدام هو المصدر الأساسي لمزيد من الحطام، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة قد تجعل بعض المدارات غير قابلة للاستخدام لعقود أو قرون.
إن هذه الحقائق تبرز أن المدار لم يعد مجرد فضاء مفتوح للاستخدام الحر، بل بات بيئة اقتصادية وجيوسياسية ذات حدود صارمة. فالخطر لا يكمن فقط في فقدان أصول باهظة الثمن، بل في تهديد الاستدامة العامة للفضاء كمورد مشترك. وبالتالي، فإن التعامل مع المدار المشترك لم يعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل أصبح التزامًا اقتصاديًا وسياسيًا على المجتمع الدولي لضمان بقاء الفضاء قابلًا للاستغلال والتنمية في المستقبل.
التكلفة الاقتصادية المباشرة على النشاط الاقتصادي الفضائي
تتمثل أهم أوجه النشاط الاقتصادي الفضائي في الوقت الحالي في إطلاق الأقمار الصناعية، وفي هذا الصدد تتجاوز تداعيات الحطام الفضائي الطابع البيئي لتنعكس مباشرة في صورة تكلفة مالية متزايدة تفرض نفسها على كل مراحل دورة حياة القمر الصناعي، بدءًا من التصميم والإطلاق وصولًا إلى التشغيل ونهاية الخدمة. ويمكن النظر إلى هذه الكلفة باعتبارها ضريبة غير معلنة يتحملها القطاع الفضائي العالمي نتيجة التراكم التاريخي للأجسام غير الوظيفية في المدار، وهي ضريبة باتت أكثر وضوحًا مع ارتفاع عدد المناورات، وازدياد تكاليف التأمين، وتكرار حالات فقدان الأصول المدارية.
تمثل المناورات لتفادي الاصطدام Collision Avoidance Maneuvers (CAMs) أحد أبرز أوجه الكلفة التشغيلية. فمحطة الفضاء الدولية نفذت منذ عام 1999 أكثر من 27 مناورة لتجنب الاصطدام بهذا الحطام، بينما تتلقى الأقمار الصناعية التجارية مئات الإشعارات سنويًا حول احتمالات التقارب أو التصادم المداري. ومع زيادة المُناورات تستهلك كل مناورة وقودًا مُعينًا يحدد العمر الافتراضي للقمر، وتؤدي إلى خسارة في الإيرادات نتيجة توقف الخدمات أثناء التنفيذ، والذي قد يستمر لساعات أو حتى يومين كاملين. وتشير تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن الاعتماد المتزايد على هذه المناورات يقلّص العمر الاقتصادي للقمر بنسبة مؤثرة، ويؤدي إلى تراجع معدل العائد على الاستثمار.
يضاف إلى ذلك كلفة دمج الحماية في التصميم. إذ أظهرت دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن تجهيز الأقمار الصناعية بأنظمة تدريع Shielding، وأنظمة التخلص من البقايا بعد انتهاء العمر التشغيلي Post-Mission Disposal (PMD)، وأنظمة المناورة، يضيف ما بين 5 و10% إلى الكلفة الكلية للمهمة. وفي حالة الأقمار عالية القيمة التي تصل كلفتها إلى مئات الملايين من الدولارات، يعني ذلك زيادة مباشرة بعشرات الملايين مخصّصة فقط لتقليل المخاطر الناجمة عن بيئة غير نظيفة. وتُعد محطة الفضاء الدولية المثال الأكثر تطرفًا، حيث جُهزت بأنظمة Whipple Shielding للتعامل مع أجسام يصل قطرها إلى سنتيمتر واحد.
على صعيد التأمين الفضائي Space Insurance، تكشف المؤشرات عن سوق يتسم باضطراب متزايد. فقد بلغت قيمة هذا السوق حوالي 700 مليون دولار في عام 2023 مع توقعات ببلوغه 1.2 مليار دولار بحلول 2032. إلا أن حجم المطالبات في العام نفسه تجاوز 995 مليون دولار مقابل أقساط بقيمة 557 مليون فقط، ما يعني نسبة خسائر قاربت 180%، وهي الأعلى منذ أكثر من عقدين. هذا الوضع دفع العديد من شركات التأمين إلى رفع الأقساط، وتقييد شروط التغطية، خصوصًا للبعثات العاملة في المدارات المنخفضة المزدحمة. ونتيجة لذلك، يجد المشغلون أنفسهم في حلقة مفرغة: ارتفاع المخاطر يؤدي إلى زيادة أقساط التأمين، ما يرفع كلفة التشغيل ويحفّز على إطلاق مزيد من الأقمار لتغطية التكاليف، وهو ما يزيد بدوره من حدة الازدحام.
أما الخطر الأكبر فيكمن في فقدان الأصول المدارية بالكامل. فحادث الاصطدام بين Iridium-33 وKosmos-2251 عام 2009 أدى إلى تدمير قمرين تشغيليين وتوليد آلاف القطع الإضافية. وتشير تقديرات إلى أن فقدان قمر واحد قد يعني خسارة مباشرة تتجاوز 30 مليون دولار، فيما يضيف الحطام الناتج عن الحادثة ما يقارب 200 مليون دولار أخرى في صورة مخاطر بيئية يتحملها باقي المشغلين. أما المطالبات التأمينية المرتبطة بالأقمار عالية القيمة، خاصة في قطاع الاتصالات، فقد تصل إلى 400 مليون دولار للحادثة الواحدة.
هذه المؤشرات تبرز أن الكلفة الاقتصادية المباشرة للحطام الفضائي لم تعد احتمالًا نظريًا بل واقعًا يوميًا يتجسد في ارتفاع الكلفة التشغيلية، وانخفاض المردودية، وتفاقم تقلبات سوق التأمين. وإذا كان النقاش في الجزء السابق قد ركز على طبيعة المدار كمورد محدود وملوث، فإن هذه الحقائق توضح الوجه المالي الملموس للأزمة، حيث تتحمل الصناعة الفضائية اليوم عبئًا متناميًا يعيد تشكيل حسابات الاستثمار والجدوى الاقتصادية لمشروعات الفضاء.
الآثار الاقتصادية غير المباشرة على الصناعات الأرضية
تتمثل خطورة الحطام الفضائي في أن آثاره لا تتوقف عند حدود المدار، بل تمتد إلى النشاطات الأرضية عبر القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على البنية التحتية الفضائية. فإذا كانت التكاليف المباشرة التي يتحملها المشغلون قد تحولت إلى عبء يومي، فإن الأثر غير المباشر على الصناعات الحيوية يضاعف من حجم المشكلة ليأخذ طابعًا منهجيًا يهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
أكثر القطاعات حساسية أمام هذه المخاطر هي أنظمة الملاحة العالمية Global Navigation Satellite Systems (GNSS). فقد قدّرت وزارة التجارة الأميركية أن القيمة الاقتصادية المتراكمة لخدمات GPS في الولايات المتحدة وحدها تجاوزت 1.4 تريليون دولار منذ إنشائها، بينما تساهم هذه الأنظمة سنويًا بما يزيد على 13.6 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني. الخسائر المحتملة في حال تعطل هذه الأنظمة تكاد تكون كارثية، إذ تشير دراسة رسمية أميركية إلى أن انقطاعها لمدة 30 يومًا يكلف نحو مليار دولار يوميًا، مع احتمال بلوغ 1.5 مليار يوميًا إذا تزامن الانقطاع مع مواسم زراعية حرجة. أما التقديرات البريطانية فقدّرت الخسائر بقرابة 7.6 مليار جنيه إسترليني في حال توقف الأنظمة لسبعة أيام فقط، ما يوضح الأثر المباشر على خدمات الطوارئ والنقل البري والبحري.
قطاع الأرصاد الجوية Weather Forecasting يمثل بدوره ركيزة أساسية للاقتصادات الحديثة. فالولايات المتحدة وحدها تجني نحو 30 مليار دولار سنويًا من دقة التنبؤات الجوية، التي تتيح التخطيط في مجالات الزراعة، والنقل، والطاقة. إلا أن فقدان الأقمار العاملة في المدارات القطبية، والتي تشكل العمود الفقري لهذه الخدمة، سيؤدي إلى انخفاض دقة النماذج المناخية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وهو ما يعني تكبد خسائر اقتصادية قد تصل إلى 15.9 مليار جنيه إسترليني في حالة المملكة المتحدة إذا تعطلت هذه القدرات نتيجة حادث فضائي كبير. إن هذه الأرقام تُظهر أن الخطر غير المباشر للحطام لا يتمثل فقط في الأضرار المادية بل في فقدان القدرة على إدارة الموارد وحماية الأرواح.
الأثر لا يتوقف عند هذين القطاعين، بل يمتد إلى البنى التحتية المالية والطاقوية. إذ تعتمد شبكات الكهرباء على التوقيت الدقيق الذي توفره الأقمار الصناعية لمزامنة عملياتها، كما أن الأسواق المالية تحتاج إلى طوابع زمنية عالية الدقة لإتمام الصفقات، بالتالي فإن أي تعطيل في هذه الخدمات قد يؤدي إلى انهيار في تدفقات رأس المال وتعطل واسع في نظم الدفع العالمية. كما تعتمد الطائرات والسفن والشاحنات على بيانات GNSS لإدارة المسارات والعمليات اللوجستية، ما يعني أن أي خلل ينعكس مباشرة على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، يوضح الجدول التالي التكلفة الاقتصادية لتوقف خدمات تحديد المواقع العالمية على بعض القطاعات في المملكة المُتحدة خلال سبعة أيام.
يتبلور هنا ما يمكن تسميته بـ “متلازمة كيسلر الاقتصادية”، حيث تصبح بعض المدارات غير مجدية اقتصاديًا قبل أن تُصبح غير قابلة للاستخدام تقنيًا. فمع زيادة الكثافة المدارية ترتفع كلفة التدريع والمناورة وأقساط التأمين، وفي الوقت نفسه تتزايد احتمالات فقدان الأقمار وتدهور الخدمات. عند نقطة معينة، تصبح الجدوى الاقتصادية لإطلاق أقمار جديدة سالبة، فيتوقف الاستثمار في هذه المدارات، وتتحول من مصدر للقيمة إلى عبء مالي.
ساحة غير متكافئة: كيف يعيق الحطام الفضائي الدول النامية
إذا كان الحطام الفضائي قد تحول إلى عبء مالي مباشر على الاقتصادات المتقدمة التي تمتلك القدرات التقنية والمالية، فإنه يمثل تحديًا مضاعفًا بالنسبة للدول النامية التي تسعى لتأسيس موطئ قدم في قطاع الفضاء. فبينما تملك القوى الكبرى مؤسسات متكاملة للتخفيف Mitigation والتأمين والاستثمار في الإزالة النشطة Active Debris Removal (ADR)، تواجه الدول ذات الموارد المحدودة بيئة مدارية مشبعة بالمخاطر من دون امتلاك الأدوات اللازمة لإدارتها أو حتى التكيف معها.
يتضح هذا التفاوت عند النظر إلى كلفة الالتزام بالمعايير الدولية لتخفيف الحطام. فكما أشرنا سابقًا تُشير التقارير إلى أن تطبيق أنظمة التخلص بعد نهاية العمر التشغيلي Post-Mission Disposal (PMD) والتدريع Shielding يضيف ما بين 5 و10% إلى الكلفة الكلية للمهمة. في حالة وكالة فضاء أوروبية أو أميركية قد تكون هذه النسبة هامشًا مقبولًا، لكن بالنسبة لدول إفريقية أو آسيوية بميزانيات فضائية محدودة، فإنها قد تساوي حرمانها من إطلاق مهمات جديدة. على سبيل المثال، بلغ إجمالي ميزانية الفضاء في القارة الإفريقية نحو 465 مليون دولار عام 2024، وهو مبلغ أقل من كلفة قمر اتصالات واحد تطلقه وكالة متقدمة. بالتالي فإن فرض ضريبة إضافية بحجم ملايين الدولارات على كل مهمة يجعل الطموحات الوطنية أقرب إلى عدم التحقق.
تفاقم هذه الفجوة السياسات التنظيمية العالمية. فالاتحاد الدولي للاتصالات ITU يعتمد نظام “الأسبقية” في تخصيص المدارات والترددات، ما يسمح للدول والشركات الكبرى بالاستحواذ على مواقع استراتيجية من خلال ما يعرف بالأقمار الورقية Paper Satellites، أي تسجيل مواقع مدارية دون استخدامها فعليًا. هذا السلوك يؤدي إلى تكدس الموارد المدارية بأيدي قوى محدودة ويترك الدول النامية في موقع التابع، تضطر إما لشراء حقوق الاستخدام بأسعار مرتفعة أو للتخلي عن خططها بالكامل. النتيجة أن الخلل في توزيع الموارد لا يعود فقط إلى الفيزياء المدارية بل يتجذر في البنية المؤسسية للنظام الفضائي العالمي.
تظهر أبعاد هذا التفاوت أيضًا في القدرة على إدارة المخاطر. ففي حين أن شركات متقدمة تمتلك أنظمة ملاحة دقيقة لتجنب الاصطدام Collision Avoidance، لا تستطيع معظم الدول النامية الاستثمار في بنى تحتية مماثلة. على سبيل المثال، تمتلك الولايات المتحدة عبر شبكة مراقبة الفضاء Space Surveillance Network القدرة على تتبع عشرات الآلاف من الأجسام المدارية، بينما تظل معظم الدول النامية معتمدة على بيانات تُمنح لها بشكل محدود أو متأخر. هذا الاعتماد يعرضها لمخاطر تشغيلية إضافية ويحد من استقلالها في اتخاذ القرارات المرتبطة بسلامة أقمارها الصناعية.
الأثر الاقتصادي لهذا الخلل يظهر بوضوح في الجدوى الاستثمارية. فالشركات الخاصة في الدول النامية، والتي قد تفكر في الدخول إلى قطاع الأقمار الصناعية الصغيرة SmallSats أو أنظمة الرصد الأرضي، تجد نفسها أمام كلفة تأمين مرتفعة، واحتمال أعلى لفقدان الأقمار، وافتقار إلى البيانات اللازمة للتخطيط. هذه البيئة تجعل العوائد المتوقعة أقل بكثير مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة، ما يحد من قدرة هذه الاقتصادات على بناء صناعة فضائية محلية تنافسية.
إن الحطام الفضائي بهذا المعنى لا يشكل فقط تحديًا بيئيًا عالميًا، بل يعمق التفاوت القائم بين من يملك القدرة على إدارة المخاطر ومن يظل في موقع المتأثر بها. وإذا كان الاقتصاد العالمي برمته عرضة لتداعيات الحطام كما ناقشنا في القسم السابق، فإن الدول النامية تدفع ثمنًا مضاعفًا لأنها تدخل ساحة غير متكافئة تُصاغ قواعدها وفق مصالح القوى الكبرى، وتُحرم فيها من فرص التنمية الفضائية التي يمكن أن تعزز استقلالها الاقتصادي والتقني.
خلاصة القول إذن أن مستقبل النشاط الفضائي العالمي لن يتحدد فقط بالقدرة على تطوير تكنولوجيا أكثر تقدمًا، بل بمدى نجاح المجتمع الدولي في التعامل مع إرث الحطام المتراكم وإدارته كجزء لا يتجزأ من البنية التحتية للاقتصاد العالمي. فالتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تناولها التحليل ليست سوى إشارات مبكرة إلى مسار قد يقود -إن لم تتم مواجهته- إلى إغلاق قطاعات كاملة من المدارات المُنخفضة أمام الاستخدام الاقتصادي.
كما أنه من المتوقع خلال العقدين القادمين، أن يتضاعف عدد الأقمار الصناعية العاملة بفعل سباق الكوكبات الضخمة Mega-constellations، وهو ما سيجعل أي تقاعس عن تبني قواعد إلزامية للتخفيف Mitigation أو الاستثمار في الإزالة النشطة ADR بمثابة تسريع لمتلازمة كيسلر الاقتصادية. وفي حال استمرت البنية الحالية لإدارة المدارات، ستظل الكلفة موزعة بشكل غير عادل، حيث تستطيع القوى الكبرى امتصاص المخاطر، بينما تجد الدول النامية نفسها خارج اللعبة، مضطرة للاعتماد على خدمات مستوردة، ما يعمّق تبعيتها الاقتصادية والتقنية.
لكن هذا المسار ليس حتميًا. فكما أظهرت تجارب سابقة في إدارة السلع العامة العالمية، مثل اتفاقيات المناخ أو أطر الأمن النووي، فإن خلق آلية دولية ملزمة لإدارة المدار قد يحول الأزمة إلى فرصة، مثل الاستثمار في أنظمة تتبع مشتركة، وتمويل جماعي لمشروعات ADR، وتوزيع أكثر عدالة للموارد المدارية، يمكن أن يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للدول النامية، ويحوّل الفضاء إلى رافعة تنموية لا إلى ميدان استبعاد.
وعليه، فإن الخيار المطروح أمام المجتمع الدولي هو بين ترك المدار يواصل تحوله إلى بيئة غير قابلة للاستغلال الاقتصادي، أو إعادة صياغة قواعد اللعبة بما يضمن استدامته كمورد عالمي.
المراجع
Economic Dynamics of Orbital Debris: Theory and Application – Universities Space Research Association, accessed September 24, 2025, https://www.hou.usra.edu/meetings/orbitaldebris2019/orbital2019paper/pdf/6072.pdf
Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – UNOOSA, accessed September 24, 2025, https://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_49E.pdf
Space debris | EBSCO Research Starters, accessed September 24, 2025, https://www.ebsco.com/research-starters/astronomy-and-astrophysics/space-debris
Cost and Benefit Analysis of Orbital Debris Remediation | NASA, accessed September 24, 2025, https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/03/otps_-_cost_and_benefit_analysis_of_orbital_debris_remediation_-_final.pdf
About space debris – ESA, accessed September 24, 2025, https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/About_space_debris
ARES | Orbital Debris Program Office | Frequently Asked Questions, accessed September 24, 2025, https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/faq/
Space debris poses growing threat to satellite infrastructure – Global Resilience Institute, accessed September 24, 2025, https://globalresilience.northeastern.edu/space-debris-poses-growing-threat-to-satellite-infrastructure/
Space Debris – NASA, accessed September 24, 2025, https://www.nasa.gov/headquarters/library/find/bibliographies/space-debris/
Space Environment Statistics · Space Debris User Portal, accessed September 24, 2025, https://sdup.esoc.esa.int/discosweb/statistics/
SPACE DEBRIS:AL AW AND ECONOMICS ANALYSIS OF THE ORBITAL COMMONS – Stanford Law School, accessed September 24, 2025, https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/11/19-2-2-salter-final_0.pdf
Does the debris around Earth affect the atmosphere? – BBC Science Focus Magazine, accessed September 24, 2025, https://www.sciencefocus.com/space/does-the-debris-around-earth-affect-the-atmosphere
Orbital Debris – Office of Safety and Mission Assurance, accessed September 24, 2025, https://sma.nasa.gov/sma-disciplines/orbital-debris
Space Debris, accessed September 24, 2025, https://www.dlr.de/en/ar/topics-missions/space-safety/space-debris
SatMagazine, accessed September 24, 2025, http://satmagazine.com/story.php?number=1149658926
What if orbital debris destroyed satellites? | Epthinktank | European Parliament, accessed September 24, 2025, https://epthinktank.eu/2025/02/28/what-if-orbital-debris-destroyed-satellites/
What is space junk and why is it a problem? – Natural History Museum, accessed September 24, 2025, https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-space-junk-and-why-is-it-a-problem.html



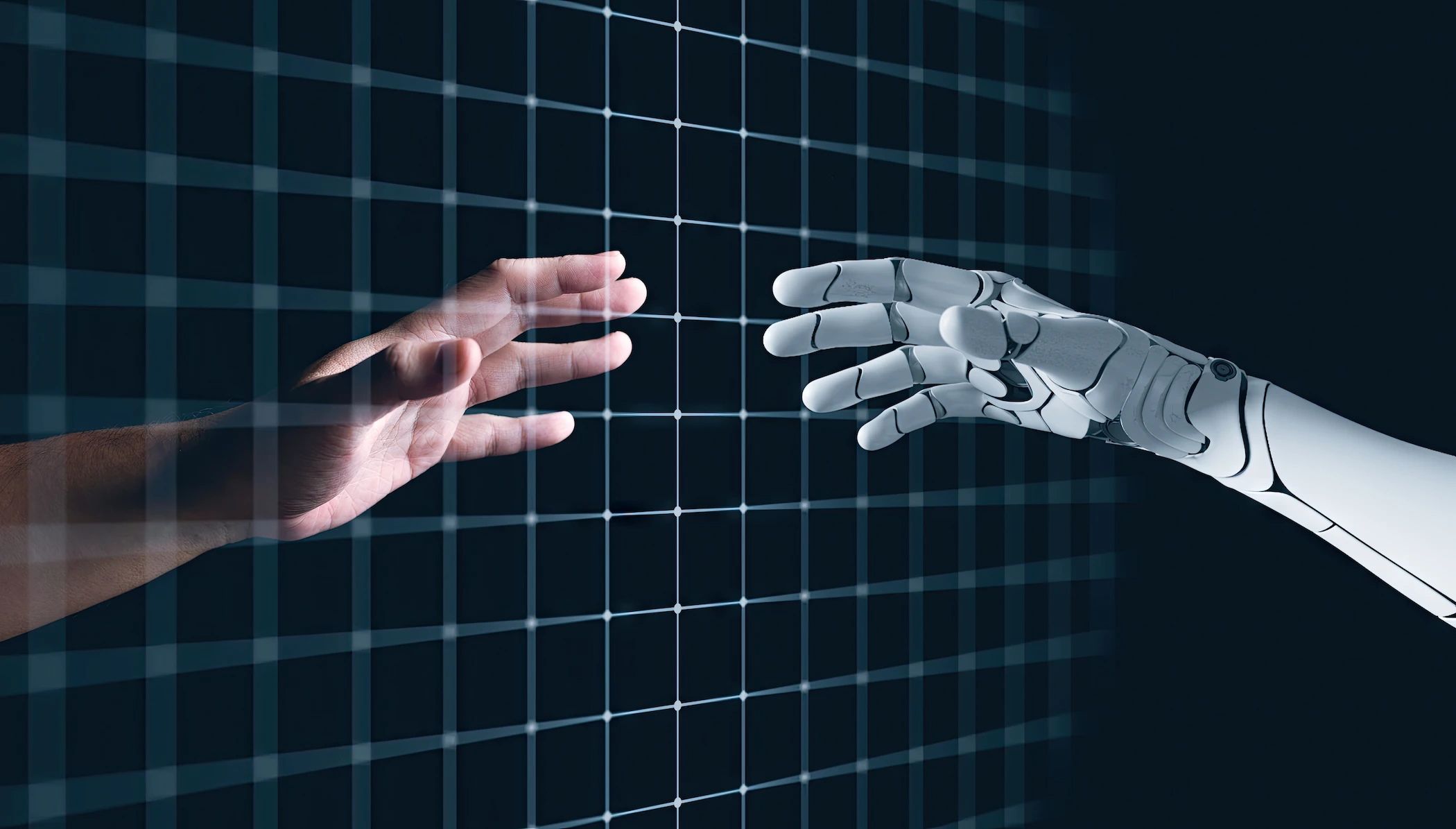




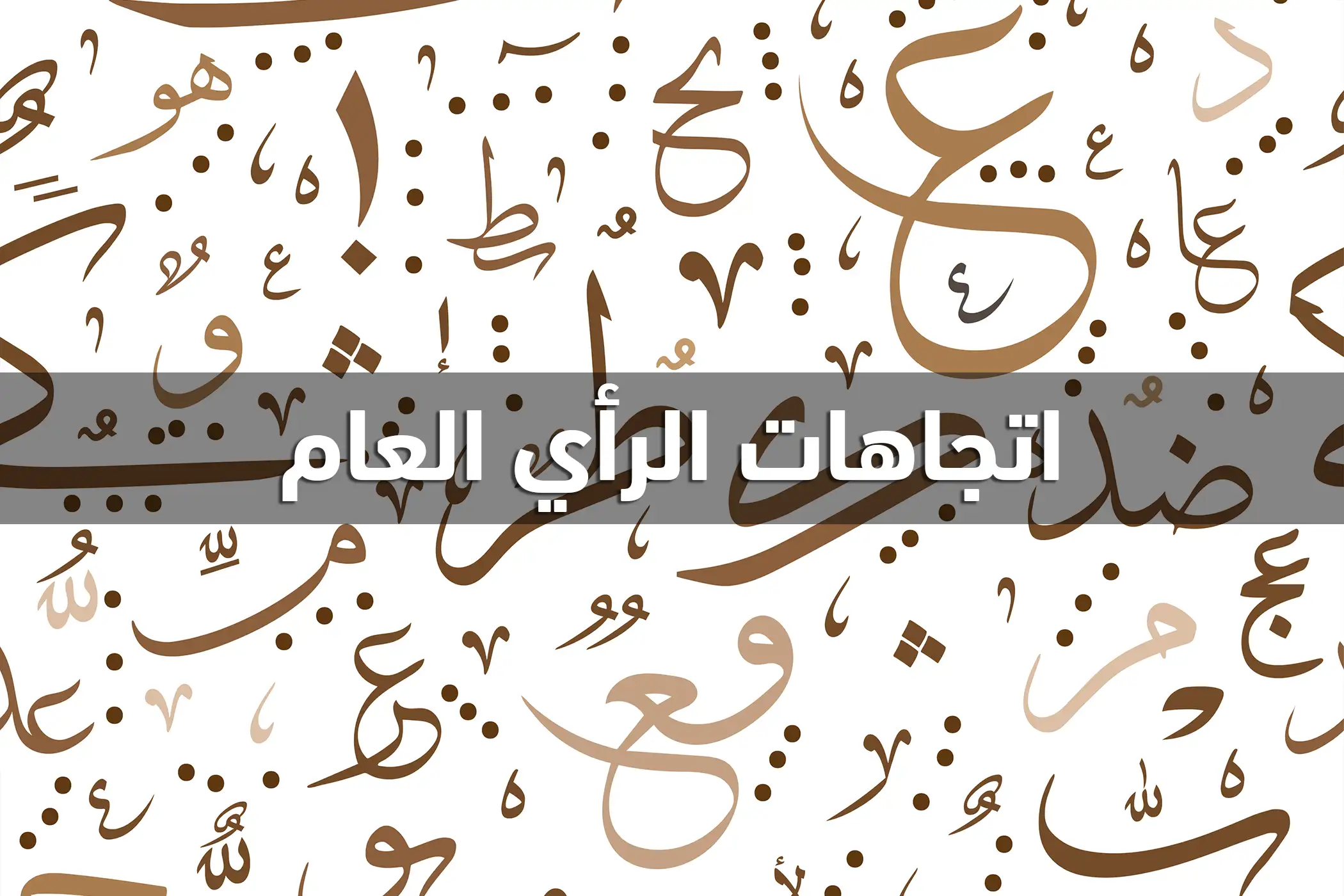














تعليقات