يرتكز النظام العالمي المعاصر على قاعدةٍ تبدو راسخة في ظاهرها، لكنها تخفي وراء صلابتها هشاشةً بنيويةً عميقة. فعلى مدى عقودٍ متتالية، حافظ هذا النظام على تماسكه عبر منظوماته ومؤسساته الدولية والإقليمية المتشابكة؛ غير أنّ هذا الاستقرار الظاهري يحجب عجزًا جوهريًا عن استشراف العامل أو اللحظة التي قد تُطيح به في نهاية المطاف. وفي قلب هذه المنظومة، تقف الأسلحة النووية بوصفها إحدى ركائزها الجوهرية؛ إذ تمنح من يمتلكها — إلى جانب ما يملكه من قدراتٍ عسكريةٍ واقتصاديةٍ أخرى — سلطةَ صياغة قواعد اللعبة الدولية والتحكم في اتجاهات النفوذ العالمي. ومع ذلك، فإن التسارع العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم يثير تساؤلًا عميقًا يتجاوز حدود الإطار العسكري إلى جوهر مفهوم القوة ذاته: هل اقتربت الأسلحة النووية من لحظة أفولها التاريخي؟ وهل يمكن للتطور العلمي أن يُسقط مفهوم الردع النووي الذي ظل لعقودٍ طويلة حجر الزاوية في منظومة الأمن الدولي، ليغدو فكرةً تجاوزها الزمن؟ ما هو السلاح الرادع الذى سيحل محل السلاح النووي؟
توصل العلماء اليوم إلى تقنياتٍ متقدمة في تحرير الجينوم تمكّنهم من اكتشاف الخلايا المتضرّرة بالإشعاع المؤيَّن(Ionised Radiation)، وإصلاحها، بل وحتى هندستها لتصبح محصّنة ضد تأثيراته. ويطرح هذا التطوّر العلمي العميق تساؤلاتٍ مصيريةً حول مستقبل الردع النووي والنظام الدولي برمّته؛ إذ إنّ تحييد القدرة التدميرية للأسلحة النووية على المستوى البيولوجي قد يمهّد لتآكل الأسس التي قامت عليها الهيمنة النووية لعقودٍ طويلة. ومن هنا، تتوالى سلسلةٌ من الأسئلة المعقّدة التي تمسّ جوهر موازين القوى في العالم: هل سيظل النفوذ التقليدي للدول النووية قائمًا كما كان؟ وإذا فقدت أسلحة الدمار الشامل قيمتها الاستراتيجية، فهل سنشهد نشوء نمطٍ جديدٍ من الردع، أم أنّ مفهوم الردع ذاته سيندثر تدريجيًا؟ ومن هي القوة العالمية التي قد تتقدّم لتملأ هذا الفراغ؟ وبأي أدواتٍ أو تقنياتٍ ستفرض نفوذها؟ وربما يكون السؤال الأهم: هل ستسمح الدول النووية الراهنة بحدوث مثل هذا التحوّل التاريخي، أم ستقاومه بضراوة حفاظًا على مكانتها وهيمنتها في النظام العالمي القائم
كيف يعمل تحرير الجينوم؟
يُعرَّف الإشعاع المؤيَّن بأنه أحد أشكال الانبعاثات عالية الطاقة الصادرة عن الذرّات غير المستقرة، سواء في هيئة موجاتٍ كهرومغناطيسية — مثل الأشعة السينية وأشعة جاما — أو في صورة جسيماتٍ عالية الطاقة، كجسيمات ألفا وبيتا أو النيوترونات. ورغم أنّ الإشعاع المؤيَّن المستخدم في مجالات الطب، كالتصوير الإشعاعي أو علاج الأورام، يشترك في طبيعته مع ذلك الناتج عن الأسلحة النووية، فإنّ الفارق الجوهري بينهما يكمن في مقدار الإشعاع المنبعث والغاية من استخدامه.
في المستشفيات يُعطى الإشعاع بجرعات محكومة ومحدّدة بدقّة، وتُدار تحت إشرافٍ مهني صارم بهدف التشخيص أو استهداف الخلايا السرطانية للقضاء عليها؛ أما الأسلحة النووية فتُطلِق دفعةً هائلةً وفوريةً من الإشعاع لا تسيطر عليها آليات تنظيمية، وبنَفْس الطابع التدميري تسعى إلى إحداث خسائر واسعة النطاق. وبالمثل، قد تنبعث إشعاعات مؤيّنة من محطات الطاقة النووية عبر نفاياتها المشعّة، ما يولّد مخاطر بيئيّة وصحيّة ممتدّة الأثر على المدى البعيد. وبالتالي، ومع اختلاف السياق والغاية وكمية الانبعاث، يظلّ المعيار الحاسم في تحديد الأثر البيولوجي هو الجرعة الممتصّة في أنسجة الكائن الحي — بما في ذلك مقدار الإشعاع ومدة التعرّض — إذ تتناسب شدّة الأذى طرديًا مع مستوى التعرض ومدة استمراره.
تُعدّ تقنية كريسبر–كاس9 (CRISPR–Cas9) أداةً جينية متقدّمة استُلهِمت في الأصل من نظامٍ دفاعي طبيعي موجود في البكتيريا، وتعمل كمقصٍّ جزيئيٍ بالغ الدقة يستهدف تسلسلاتٍ محددة في الحمض النووي. وتعتمد هذه التقنية على جزيءٍ موجِّه يُعرف باسم الحمض النووي الريبوزي الأحادي (sgRNA) لتحديد تسلسلٍ بعينه داخل الـDNA، بينما يقوم إنزيم كاس9 (Cas9) بقطع الشيفرة الوراثية في هذا الموضع بدقّةٍ متناهية. وعقب حدوث القطع، تسعى الخلية إلى إصلاح مادتها الوراثية، مما يمنح العلماء فرصة للتدخّل من أجل حذف أو تعديل أو استبدال أجزاءٍ من الجينوم. وقد غدت هذه التقنية اليوم أداةً محورية في الأبحاث الحديثة، إذ تُستخدم على نطاقٍ واسع لتحديد الجينات التي تتحكم في استجابة الخلايا للإشعاع المؤيَّن. ومن خلال تشغيل أو تعطيل جيناتٍ معيّنة في الخلايا السرطانية ومراقبة سلوكها أثناء التعرّض للإشعاع، يتمكّن الباحثون من تحديد أيّ الجينات تُكسب الخلايا قدرةً أكبر على المقاومة، وأيّها يجعلها أكثر هشاشةً أمام العلاج الإشعاعي.
يتركّز العمل البحثي الحالي بصورةٍ أساسية على توظيف تقنية “كريسبر” لفهم كيفية تأثير الإشعاع في الخلايا وتحسين فعالية العلاج الإشعاعي. فإذا تبيّن أن جينًا معيّنًا يجعل الخلايا السرطانية أكثر عُرضةً للتلف الإشعاعي، يمكن للعلماء استهداف ذلك الجين لتعزيز نتائج العلاج. وعلى العكس، فإن تحديد الجينات التي تمنح الأورام قدرةً على مقاومة الإشعاع يُسهم في صياغة استراتيجياتٍ تهدف إلى إبطال تلك المقاومة. ورغم أن هذا النهج لا يزال في طوره التجريبي، فإن ما يتيحه من نتائج يُعدّ بالغ الأهمية؛ إذ يسمح بتصميم علاجاتٍ أكثر دقّة ومواءمة للخصائص الجينية لكل مريض، بما قد يمكّن الأطباء مستقبلاً من استخدام جرعاتٍ إشعاعيةٍ أقل لتحقيق الفاعلية العلاجية ذاتها.
ومع مرور الوقت، يُتوقَّع أن يمتد هذا النهج ليشمل حماية الأنسجة السليمة من التأثيرات الضارة للإشعاع المؤيَّن. فإذا تمكّن الباحثون من تحديد الجينات التي تجعل الخلايا الطبيعية أكثر حساسيةً للإشعاع، فقد يُصبح بالإمكان — من الناحية النظرية — تعديل هذه الجينات أو تثبيط نشاطها مؤقتًا لحماية الأنسجة السليمة أثناء جلسات العلاج الإشعاعي أو في حالات التعرّض العرضي للإشعاع. وبالمنطق ذاته، يمكن لتقنيات كريسبر أن تُسهم في الحد من الأضرار المزمنة الناتجة عن الإشعاع عبر تعزيز مسارات إصلاح الحمض النووي في الخلايا غير السرطانية، بما يقلل من آثارها طويلة الأمد. ورغم أن هذا الاتجاه لا يزال في طور البحث المبكر وتقيّده حاليًا اعتبارات السلامة والضوابط الأخلاقية، فإنه يوفّر أساسًا علميًا واعدًا لتطوير استراتيجياتٍ مبتكرة تهدف إلى التخفيف من الآثار الجانبية للإشعاع المؤيَّن، مع الحفاظ على فعاليته العلاجية وربما تحسينها في المستقبل.
ورغم أن هذه المصطلحات العلمية قد تبدو معقّدةً للوهلة الأولى، فإنها تمنحنا لمحةً مبكرة عن الكيفية التي قد يوفّر بها الطب المستقبلي حمايةً للبشر من الأخطار الواسعة للتعرّض للإشعاع. فحاليًا، تُستخدم أدوات تحرير الجينات مثل كريسبر في نطاقٍ محدود يركّز على مساعدة مرضى السرطان عبر تقليل الأضرار الناتجة عن العلاج الإشعاعي السريري؛ غير أنّ المبادئ نفسها قد تُطبّق مستقبلًا على فئاتٍ أخرى من البشر المعرّضين للإشعاع في حالات الطوارئ النووية أو الكوارث أو حتى النزاعات العسكرية واسعة النطاق. وإذا نجح العلماء في منع الإصابات الخلوية الناتجة عن الإشعاع المؤيَّن أو عكس آثارها الحيوية، فقد تتجاوز هذه الأدوات دورها العلاجي لتصبح وسيلةً وقائية فاعلة. وعند الانتقال من هذا المجال العلمي البحت إلى الميدان السياسي، تتضح النتيجة بجلاء: فإذا تحقّق ذلك، ستفقد الأسلحة النووية قيمتها بالكامل، لأنها ببساطة ستغدو بلا جدوى.
الجيل التالي من الردع
يقوم النظام العالمي الراهن على فرضيّةٍ جوهرية مؤدّاها أنّ القوى العظمى هي تلك التي تمتلك السلاح النووي. فالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، قد اكتسبت مكانتها المميّزة وحقّها في امتلاك سلطة النقض (الفيتو) استنادًا إلى امتلاكها الترسانة النووية، إلى جانب مجموعةٍ من العوامل الداعمة الأخرى، وهو ما منحها القدرة على التلويح باستخدام هذا السلاح في حال اندلاع أيّ مواجهةٍ كبرى.
 :
وقد أفضى هذا الواقع إلى نتيجتين رئيسيتين مترابطتين: أولاهما، أنّه على الرغم من تعدّد العوامل التي تُسهم في تحديد مكانة الدول — مثل القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والنفوذ السياسي — فإنّ امتلاك السلاح النووي يظلّ العامل الفاصل الذي يمنح الدولة صفة القوّة العظمى. وبمعنى آخر، فإنّ النظام الدولي الحديث قد بُني في جوهره حول مركزية القوى النووية التي أصبحت تمثّل نواة التراتبية العالمية وركيزة شرعيتها السياسية والعسكرية. أما النتيجة الثانية، فهي أنّ امتلاك هذه الأسلحة أفرز مبدأً عُرف لاحقًا باسم التدمير المتبادل المؤكّد (Mutually Assured Destruction)، وهو مبدأ يقوم على فكرةٍ بسيطةٍ في ظاهرها، لكنها تنطوي على منطقٍ مروّع: فالقوتان النوويتان لا تخوضان حربًا مباشرة ضد بعضهما، أو أنه حتى إذا اندلعت بينهما مواجهة، فلن تُستخدم فيها الأسلحة النووية، لأنّ النتيجة ستكون دمارًا شاملًا للطرفين معًا. ويشكّل الوضع القائم بين الهند وباكستان مثالًا حيًّا على هذا المبدأ، إذ يظلّ التوازن القائم بين الردع والخوف من الإبادة المتبادلة هو ما يمنع انزلاق البلدين إلى هاوية الصراع النووي.
نظريًا، يُفترض أن الأسلحة النووية — وعلى نحوٍ يحمل مفارقةً لافتة — تمثّل مصدرًا للاستقرار والسلام والأمن الدوليين، وأنها وسيلةٌ لردع الحروب بين القوى العظمى، أو ما يُعرف بـ”الحروب العالمية”. ورغم أنّ هذا الافتراض لا يخلو من وجاهةٍ من الناحية النظرية، فإنّ فكرة السلاح النووي في ذاتها تُعدّ أحد العوامل الجوهرية الكامنة وراء اندلاع النزاعات أو إطالة أمدها. فعلى سبيل المثال، يجسّد الخلاف المزمن بين إيران والدول الغربية هذا المنطق بوضوح، إذ يتمحور جوهر الأزمة حول مساعي طهران لامتلاك القدرات النووية، وما يثيره ذلك من مخاوف وجودية لدى الغرب. وفي عمق هذا التوتر، تكمن المخاوف الأمريكية المرتبطة بأمن إسرائيل في المنطقة، الأمر الذي يجعل الملف النووي الإيراني يتجاوز كونه قضيةً تقنية أو علمية ليغدو رهانًا استراتيجيًا يمسّ توازنات القوى الإقليمية والدولية على حدٍّ سواء.
علاوةً على ذلك، يمكن لفكرة امتلاك السلاح النووي ذاتها أن تتحوّل إلى ذريعةٍ لإشعال الحروب أو تبريرها، كما تجلّى في الحرب التي استمرّت اثني عشر يومًا بين إيران وإسرائيل، حين استخدمت الأخيرة القدرات النووية الإيرانية و”القنبلة النووية” كمبرّرٍ لشنّ غاراتٍ متكرّرة على طهران. وفي المقابل، يوظّف بعض قادة العالم مفهوم السلاح النووي بوصفه أداةً للتهديد السياسي دون اللجوء إلى استخدامه فعليًا. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سبيل المثال، لوّح أكثر من مرة بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في سياق الحرب الجارية ضد أوكرانيا. ورغم أنّ هذه التصريحات تُفهَم في الغالب كتهديدٍ موجهٍ إلى القوى الغربية التي قد تفكّر في مهاجمة موسكو، فإنّ مجرد امتلاك روسيا لترسانةٍ نوويةٍ ضخمة أتاح لبوتين هامشًا أوسع للمناورة والتصعيد داخل أوكرانيا، مستندًا إلى ضمانٍ ضمني بأنّ أية قوةٍ كبرى لن تُغامر بخوض مواجهةٍ مباشرة مع دولةٍ نووية.
وبناءً على ما تقدّم، فإنّ جميع ملامح الحرب ومعادلات الهيمنة السياسية التي فرضتها القوى النووية لعقودٍ طويلة ستتغيّر جذريًا إذا ما ظهرت تقنيةٌ قادرة على تحييد تأثير تلك الأسلحة وجعلها، تبعًا لذلك، بلا جدوى. فعند فقدان الأسلحة النووية قيمتها الاستراتيجية، ستتبدّل هرمية القوى العالمية على نحوٍ غير مسبوق؛ إذ قد تغدو قوى اليوم العظمى مجرّد قوى متوسطة الغد، والعكس صحيح. ومن ثمّ تطرح المرحلة المقبلة تساؤلاتٍ كبرى حول ملامح النظام الدولي الآتي: هل ستحتفظ روسيا بمكانتها بين القوى الكبرى إذا لم تعد ترسانتها النووية ذات فاعلية؟ وهل يمكن أن تؤدّي الاضطرابات الداخلية في فرنسا وعدم اليقين الاقتصادي إلى إخراجها من دائرة النفوذ التي طالما شغلتها ضمن مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية؟ بل هل سيبقى لتلك المجموعة وزنٌ يُذكر في عالمٍ انتفت فيه جدوى السلاح النووي؟ وهل سيظلّ مجلس الأمن الدولي على هيكله الحالي، أم أنّ العالم يقف على أعتاب تحوّلٍ شامل في بنية السلطة الدولية كما استقرّت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟
 
ورغم أن اختفاء الأسلحة النووية قد يبدو أمرًا باعثًا على الاطمئنان لأنه يزيل خطر اندلاع حربٍ نووية مدمّرة، فإنّ ذلك لا يُلغي احتمال نشوء جيلٍ جديدٍ من أسلحة الدمار الشامل. فكما أُشير سابقًا، فإنّ تقنيات تحرير الجينوم التي قد تُستخدم لتحييد آثار الإشعاع النووي يمكن، في حال إساءة توظيفها، أن تُسخَّر لإلحاق أضرارٍ جسيمة بفئاتٍ سكانيةٍ محددة، من خلال استهداف خصائصها الوراثية، بما يُفضي إلى عواقبَ قاتلة يصعب احتواؤها. وسواء تعلّق الأمر بتحرير الجينوم أو بأيٍّ من التقنيات الناشئة الأخرى، فإنّ تصوّر عالمٍ يخلو من الأسلحة الفتّاكة واسعة التدمير يظلّ أمرًا بعيد المنال؛ إذ ستظلّ احتمالية ابتكار أدواتٍ قادرةٍ على إنهاء الحروب في دقائق قائمةً ما دامت التكنولوجيا في تطوّرٍ متسارع. وهذا يعني أنّ التطورات العلمية الراهنة تُمهد الطريق لعصرٍ جديدٍ قد لا تحتلّ فيه الأسلحة النووية المكانة نفسها على خريطة القوة والسياسة الدولية كما كانت طوال العقود الماضية.
ورغم أن ذلك قد يعني أن هذه الأسلحة الفتّاكة لن تبقى بذات الخطورة التي كانت عليها في الماضي، وأن بعض القوى العالمية الراهنة قد تُستبدل بأخرى — أو يفقد بعضها مكانته الراسخة — فإن هذا لا يُفضي بالضرورة إلى مستقبلٍ أكثر سلمًا. فبمنظورٍ واقعي، تقوم السياسة الدولية في جوهرها على منطق الصراع والحروب؛ إذ إن وجود القوى العظمى التي يقوم عليها توازن النظام العالمي يقتضي بطبيعته امتلاك أدوات ردعٍ قاسية وفعّالة. وإذا ما اختفت الأسلحة النووية من معادلة القوة، فإنّ نوعًا جديدًا من السلاح سيظهر لا محالة لملء الفراغ؛ وإلا وجد العالم نفسه في حلقةٍ مفرغةٍ من الصراعات المتتالية، إلى أن تبرز قوةٌ مهيمنة جديدة تعيد تشكيل النظام الدولي وفق توازناتٍ مغايرة ومصالح جديدة.
References
Henderson, Hope. 2019. “From Battlefields to Cancer Wards: CRISPR to Combat Radiation Sickness.” June 27, 2019. Innovative Genomics Institute. https://innovativegenomics.org/news/crispr-to-combat-radiation/ Innovative Genomics Institute (IGI)
Tamaddondoust, R. N., et al. 2022. “Identification of Novel Regulators of Radiosensitivity Using …” PMC [article]. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9369104/ PMC
“Ionizing Radiation and Health Effects.” 2023. World Health Organization, July 27, 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ionizing-radiation-and-health-effects World Health Organization
“Fluorescent Paints Spot DNA Damage from Radiation, Gene Editing.” 2019. NASA Spinoff. Originally published in 2019. https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2019/hm_3.html NASA Spinoff




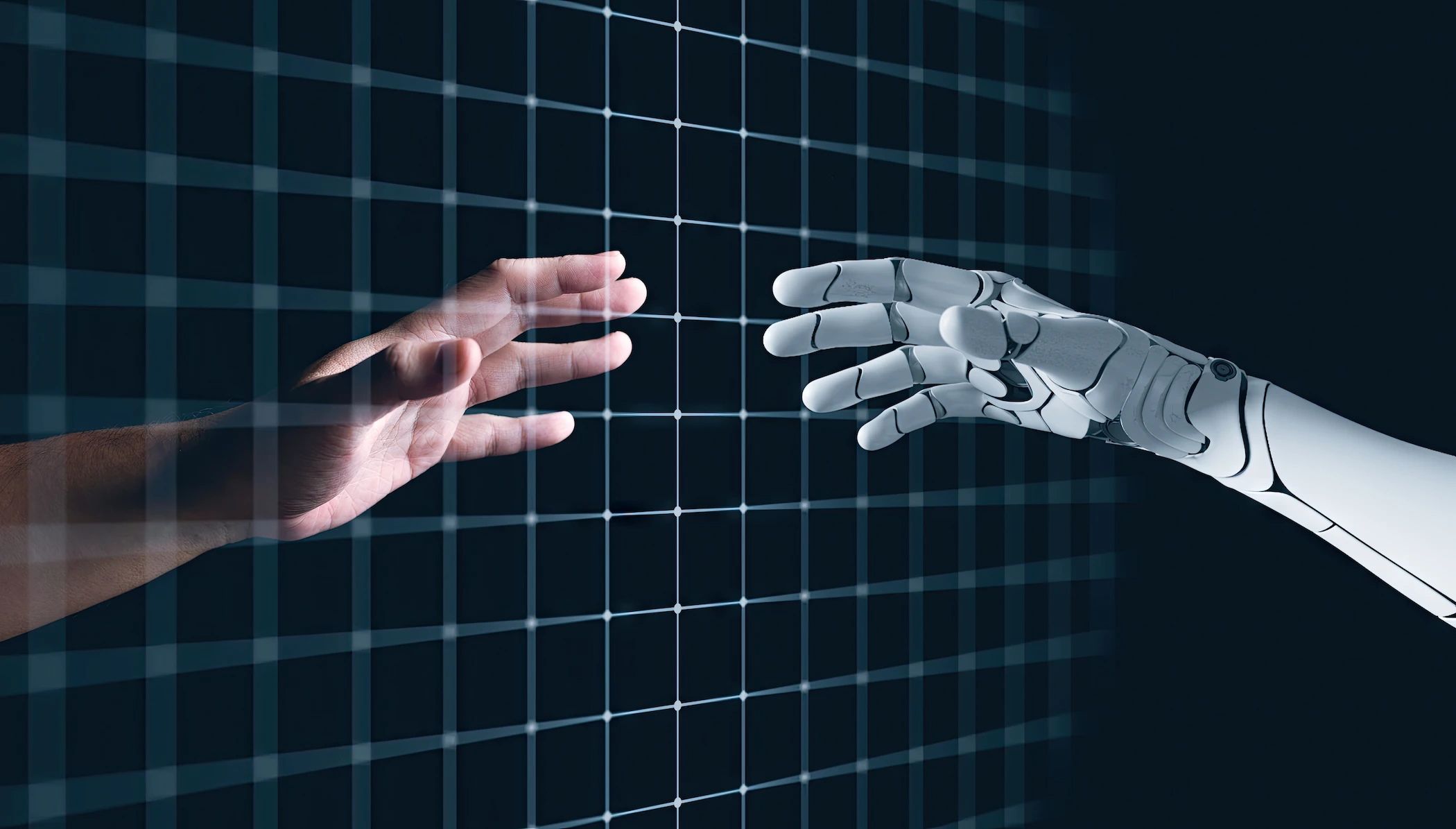



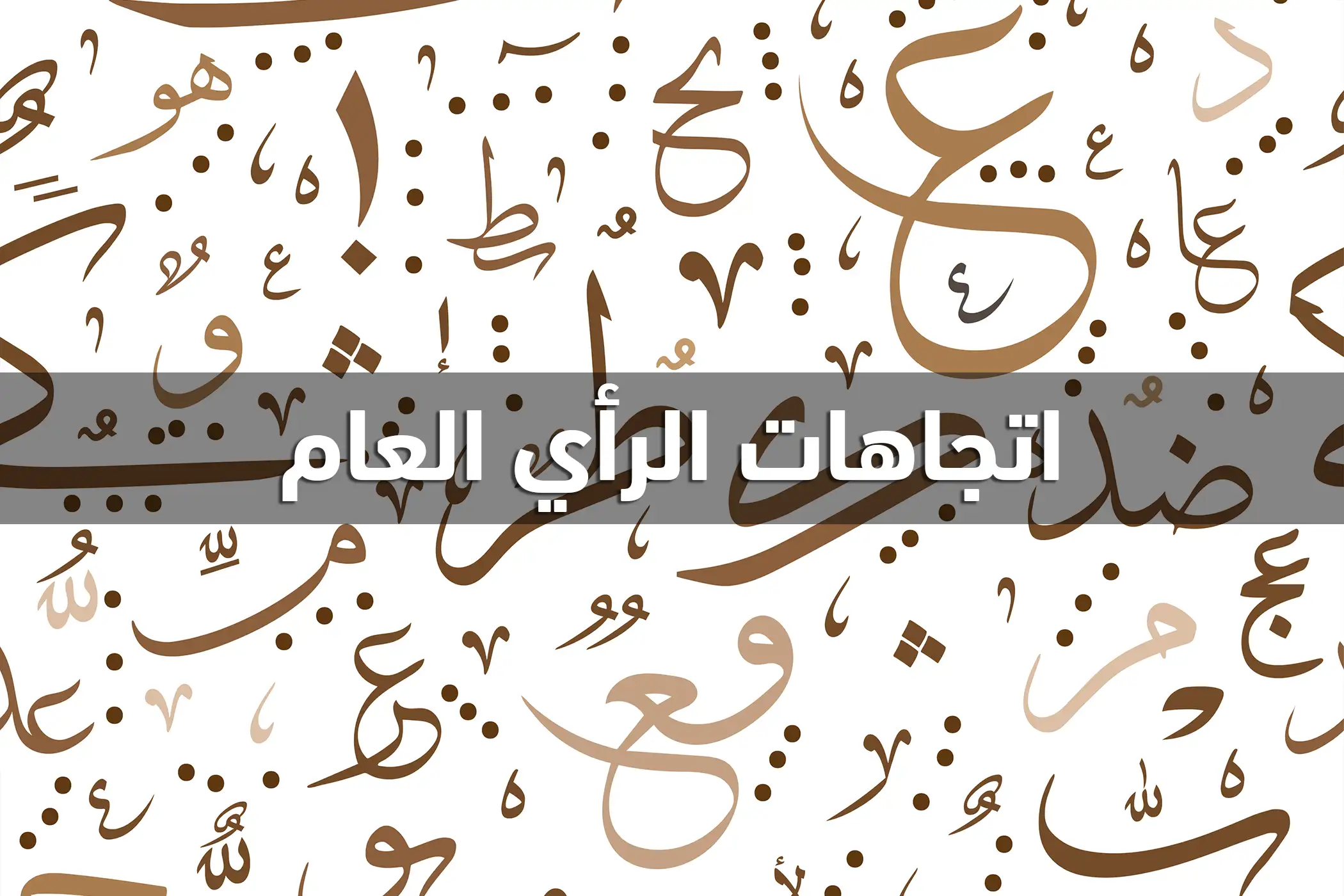




تعليقات